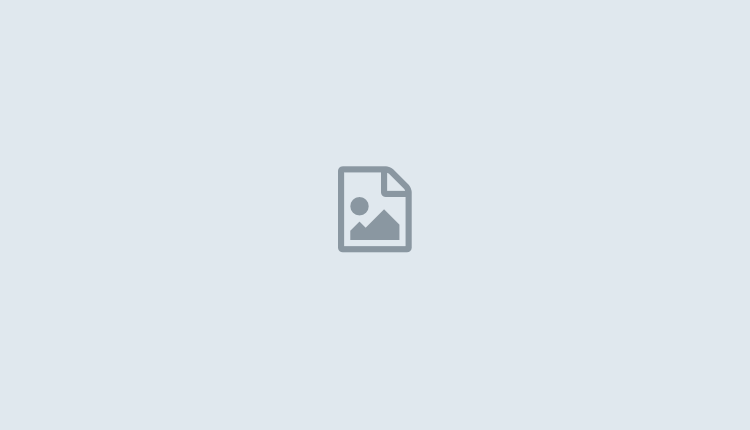عقيدة بن غوريون: الجثة لم تُدفَن بعد
محمد المقهور – وما يسطرون|
ماذا يفعل جيش حين يصاب في عقيدته القتالية، وهذه إصابة أخطر من رصاصة في القلب أو الرأس، لأن العقيدة القتالية لأي جيش أو تنظيم مسلح، تحتاج الاثنين معاً، فبدونهما لا وجود للروح القتالية.تحب الجيوش التسميات الكبيرة، الفخمة، لهذا نرى توصيفات ورموزاً تتراوح بين نسور وأسود وصواعق، شيء يوحي بالقوة والرهبة. بعض الجيوش، الغربية تحديداً، ارتبطت عقيدتها القتالية بأسماء بعض قادتها أو زعمائها، هنا يعنينا الجيش الإسرائيلي، وتسمية ارتبطت به على مدى عقود، هي: «عقيدة بن غوريون».
قيل الكثير عن هذه العقيدة القائمة على ثلاث نقاط: «الردع» و«الحسم» و«الإنذار المبكر»، وهي مفردات تماهى معها لزمنٍ قادة كيان الاحتلال وجيشه ومستوطنوه بعد كل حرب «كلاسيكية»، في مواجهة جيش آخر أو تنظيم مسلح، ولم تكن عمليات «الموساد» بعيدة عن هذا السياق. رافقت ذلك دعاية مدروسة أسهمت في خلق صورة للجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى نعته بـ«الجيش الذي لا يهزم»، صفة عُمِل عليها طويلاً، مثلما عُمِلَ على تسمية «جيش الدفاع الإسرائيلي»، ولكن ذلك زمن مضى.
قد تكون حرب تشرين الأول 1973 قد خدشت هذه العقيدة، ولكنّها لم تتعدَّ السطح، ظل التفوق العسكري الإسرائيلي قائماً، وتم التعويض عن هذه الحرب سريعاً عبر مزيد من الدعم الغربي عسكرياً وسياسياً، وخصوصاً الأميركي، في مسارٍ مفاده؛ ما نخسره في الميدان نضغط لنعوضه في محادثات وقف إطلاق النار ونربح أكثر على طاولات التفاوض. وهو ما حدث وصولاً إلى «معاهدات السلام». وتكفي الإشارة هنا إلى أن الفاصل الزمني بين حرب تشرين 1973 ومعاهدة كامب ديفيد هو ست سنوات فقط، سبقتها زيارة السادات إلى الكيان في العام 1977.
ما الذي حدث وتغيّر وأدّى إلى اهتزاز هذه العقيدة. التفوق تسليحاً وعتاداً وتكنولوجيا ما زال قائماً، بل ازداد لإبقاء ميزان القوة كاسراً لمصلحة الكيان. ما الذي تغيّر حتى تبدأ هذه العقيدة بالتحوّل من نقطة قوة إلى نقطة ضعف، وفي الإمكان القول إلى نقطة قاتلة. لقد صارت «عقيدة بن غوريون» عبئاً ثقيلاً على كاهل كيان الاحتلال وجيشه، منذ فقدت أهم اثنتين من ركائزها، «الردع» و«الحسم»، ولم يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، ولا جرّاء حرب كتلك التي تنشب بين الجيوش، ولكنها بدأت حين بدأ هذا الجيش يواجه فصائل مقاومة لا ترمي سلاحها، فصائل قد لا تحسم هي الأخرى، لكن مجرد صمودها أكثر من كافٍ. ولا أعني الفلسطينية فقط، ففي السياق، أسّست مدة احتلال جنوب لبنان، والتصاعد النوعي لعمليات المقاومة الإسلامية، لهذا النهج، بتؤدة وصبر كمن يحفر في الصخر، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، من دون اتفاق أو «معاهدة سلام».
كانت حرب تموز 2006 مفصلاً، وصار في الإمكان الرؤية أوضح؛ أي حرب يدخلها الجيش الإسرائيلي ولا يحسمها هي هزيمة. ما من إمكانية لنصف انتصار. عدم الحسم هزيمة، وفي حرب تموز لم يستطع أن يحسم. أمّا عن ركيزة الردع، فإنّ مجرد عملية أسر الجنديين ودخوله الحرب، دليل على سقوط هذه الركيزة. يبقى «الإنذار المبكر»، وهو مصطلح دائماً ما كان بمنزلة ذريعة لمعظم الحروب والجرائم الإسرائيلية، ومع ذلك، في تموز، كان لهذا المصطلح السقوط الأصعب، كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعرف نية حزب الله، تعرف أن قراراً اتُخِذَ لتنفيذ مثل هذه العملية ما إن تتوافر الظروف، ومع ذلك نفذ الحزب عملية الأسر، ودخل الحرب وانتصر فيها.
ليست مقارنة، ولكن بين عمليتي «طوفان الأقصى» وأسر الجنديين نقاط تشابه كثيرة. نعم، وما لا شك فيه، أن «طوفان الأقصى» أكبر، والحرب التي تلتها أطول، ولكن، طول هذه الحرب هو عبء آخر على جيش الاحتلال، ما دام أنه لم يستطع الحسم، ولن يحسم، كما لم يستطع الحسم في معارك «وحدة الساحات»، وقبلها «سيف القدس»، و«صيحة الفجر»، و«البنيان المرصوص»، بينما حرصت المقاومة على أن تكون آخر من يُطلِق قبل دخول إطلاق النار حيز التنفيذ. إنّ ما اعتُبِرَ إنجازاً في حرب تموز، حين رأى العالم تدمير دبابات «الميركافا» وحرقها بمن فيها، أصبح في «طوفان الأقصى» مشهداً عادياً. أهم نخب هذا الجيش، أُهينت في الالتحامات مع المقاومين، من غرفة لغرفة، وجهاً لوجه، عيناً بعين، وأحد لن يستطيع الإنكار أو التخفيف من هذه الهزيمة. وهنا، تجب العودة إلى أهم ما يميز المقاتل، ما يجب أن يمتلكه، وهو الروح القتالية، وقد أثبت رجال المقاومة الفلسطينية، أثبتت «القسام» و«سرايا القدس» ومن معهما، أنهم أصحاب الميدان، وأن لا مجال للمقارنة بين الروح القتالية التي يملكونها والمتأصلة فيهم، وبين أداء الجندي الإسرائيلي، ولا أقول روحه القتالية، لأنه صار جلياً أن أفراد هذا الجيش يتحوّلون إلى شخصيات أخرى خارج دباباتهم أو طائراتهم.
يدرك الإسرائيلي ومن يدعمه ذلك كله، يعرفون أن النتائج كارثية، وقد اعتاد الإسرائيلي بعد حروبه جني الثمار، والطرف الآخر يدخل في غيبوبة أو يسقط في «خيار السلام»، وفي الواقع هو استسلام، ويذهب إلى التطبيع سراً ثم علانية كما في السنوات الأخيرة، لتتحول أقوى مواقفه، وبـ«إجماع عربي»، إلى مبادرة فيها بعض النقاط المسماة شروطاً، شيء يشبه «العراضة» والمسرحية «الدونكيشوتية»، كما فعل السادات حين قرر زيارة الكنيست، «إنني مستعد أن أذهب إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم»، هكذا كان كلامه أمام مجلس الشعب المصري، الهزيمة بأبشع صورها، الكذب بأقبح صوره.
أعرف أنّ مقدار التفاؤل عالٍ في كل ما كُتِب، ولكنّني أجزم أنه تفاؤل عقلاني. مجرد ذكر ما يُسمى «الجبهة الداخلية» للكيان، هو باعث على الاطمئنان، هذه جبهة حرب حقيقية، ومريحٌ جداً الشبه بين الجندي والمستوطن الإسرائيليين، فالجيوش تشابه شعوبها، هكذا يجب أن يكون، أن يستمدا من بعضهما القوة والثبات، يمكن القول إنهما يتقاسمان الروح القتالية ذاتها للبلد والأرض، وهذا مفقود لدى الإسرائيلي. في المقابل، الفلسطيني الذي يرفض مغادرة قطاع غزة المدمر، هو مقاوم ظهراً لظهر مع المقاتل. أهالي الشهداء والجرحى الصامدون هم مقاتلون بكل ما للكلمة من معنى. هذا بعض من الفرق بين صاحب الأرض ومحتلها. التمسّك بالأرض عقيدة قتالية، تحريرها عقيدة قتالية، الثأر للشهداء وللجرحى وللأسرى عقيدة قتالية، والحق، أيضاً، وقبل كل شيء، عقيدةٌ قتالية. وما من شيءٍ يجدي جيشاً، يُجبَرُ عناصره على الخدمة، ويحملون الهزيمة وجثة عقيدتهم القتالية كما العتاد، لحماية مستوطنين يتفحّصون جوازات سفرهم الثانية كما يطمئنون على أولادهم، ولو ملأت رايات جيشِهِم صور النسور والأسود، وكل رسومات أبطال «مارفيل».