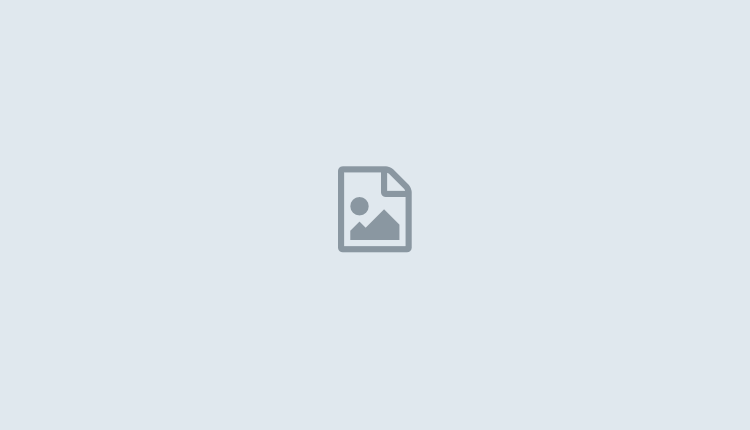أن تعيش تحت الاحتلال
جمال غصن – وما يسطرون|
من هم في سن الـ 24 وما دون من سكّان جنوب لبنان لم يختبروا يوماً واحداً من الاحتلال الإسرائيلي المباشر. حتى من هم في الثلاثين من عمرهم بالكاد يملكون ذكريات عن الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الماضية. هناك جيل ونيّف لم يعِش ما يعيشه منذ عام 1967 حتّى اليوم أهالي بلدة مجدل شمس الصامدة في الجولان المحتلّ. وهناك بين هؤلاء من يزايد على الأهالي الصامدين عن جهلٍ بمعنى التحرير، رغم العيش بترفه. في القرى الجنوبية المحتلة، الصمود كان مقاومة.
الحياة اليوميّة كانت تتطلّب التعامل مع واقع الاحتلال والقبول بما هو مفروض علناً وشتمه والعمل على إزالته سرّاً. لكنّ العلن والسرّ كانا أيضاً متداخلين، ففي كل بلدة، كان هناك (العملاء) الوسطاء الذين يتملّقون أهل البلدة الذين يبغضونهم لأنهم مدركون لتعاملهم مع العدو، لكنّ ضرورات الحياة والصمود كانت تتطلّب الصبر. فهؤلاء كانوا يتحكّمون بكلّ متطلّبات الحياة بالنسبة إلى الصابرين والمتشبّثين بأرضهم. مثلاً، لنفترض أنّ جدّي وجدّتي اللذين يقطنان قرية تحدّ فلسطين أرادا رؤية ابنتهما وحفيدهما البكر في الثمانينيات، كان عليهما طلب إذن من وسيط الاحتلال (العميل منير حدّاد في هذه الحالة الافتراضية)، إمّا لمغادرة الشريط الجنوبي المحتلّ لزيارتهما في البقاع الأوسط، أو لاستقبال الأمّ وطفلها الذي لم يبلغ العشر سنوات في القرية الحدودية. العميل منير حدّاد اغتاله مشغّلوه الإسرائيليون قبيل اندحار الاحتلال من الجنوب عام 2000 بالمناسبة.
فيلم «طيّارة من ورق» (2003)، للمخرجة الراحلة رندة الشهّال (وتمثيل زياد الرحباني وفلاڤيا بشارة وليليان نمري وجوليا قصّار)، يحاكي زواجاً عابراً لحواجز الاحتلال وحدود سايكس بيكو معاً. وأحياناً تظن أنّك تحتاج إلى التذكير اليومي بمن هما سايكس وبيكو، وكيف رسما حدودهما. تذكير سريع، أحدهما بريطاني والثاني فرنسي، وأرادا إبّان انتصارهما في الحرب العالميّة الأولى رسم حدود في منطقتنا لكيانات غير قابلة للعيش ليتمكّنا من الهيمنة عليها. نجحا في الشقّ الأول، لكن الولايات المتحدة استولت على الشقّ الثاني. بالعودة إلى الفيلم، الأهالي الصامدون يتحايلون على كل قيود الحدود والاحتلال لتنتصر قصة الحب. إنه فيلم سينمائي في النهاية. لكن في واقع الصمود والمقاومة، الحب عاملٌ أساسيٌّ.
التجذّر في الأرض حبٌّ حرم مشروع الاستعمار «الإسرائيلي» الانتصار بعد قرنٍ من بدايته. يتغزّل التراث اللبناني بمرقد العنزة، لكنّ مرقد العنزة تعبير مجازي اصطنعه من تغرّب وحنّ إلى ما فقده. وطبعاً التغرّب قد يكون بدون التزحزح من الأرض.
أهل مجدل شمس لم يتزحزحوا. قد يكون تغرّب قلّة منهم وتعامل مع العدوّ قلّة أخرى، ولكنّهم قلّة. هذا أمرٌ طبيعي في كل بلدة احتلّت، أو أيّ حيّ بيروتي نخبوي مثلاً، ظهر فيها من يَعِد أفراداً بالترقّي المجتمعي أو الطبقي، ويهرعون إلى العمالة له على حساب باقي مجتمعهم. ولكنهم يبقون قلّة، وقلّة مُحتَقَرة من محيطها. العميل الحقير هو نفسه إن كان محتلّاً أو يستدعي الاحتلال. لكن لا يمكن تقييم الذي يقبع تحت قيود الاحتلال مثل من له ترف التحرّك والتعبير. عدم التزحزح في الحالة الأولى انتصار، عدم التزحزح في الحالة الثانية تقاعُس.
الوسيط (العميل) المحلّي واقعٌ تحت الاحتلال، لكنه العميل اللطيف الذي يتملّق أهل البلدة. العملاء الآخرون الذين يضطرّ إلى أن يواجههم الأهالي الصامدون المقاومون القابعون تحت الاحتلال أسوأ بكثير. هناك عميل المعبر، في الحالة الافتراضية المذكورة سابقاً. لا يزال الطفل الزائر لجدّه وجدّته غاضباً لأنه كان عاجزاً عن الدفاع عن والدته يوم تنمّر عليها العميل «الجلبوط» على حاجز بيت ياحون.
وهناك من هم أسوأ من المذكورين، فهناك من يعذّب ويقتل بالنيابة عن المحتلّ. على كلّ، بوركت الأيادي التي ثأرت من العميل «الجلبوط» يوم أصبح التحرير متاحاً، فالتحرير أفضل ثأرٍ لمن عانى احتلالاً.
من يعيش تحت الاحتلال في الجولان أو الضفة أو أراضي الداخل يعاني منه وإن بدرجات مختلفة، لكنّهم كلّهم حتماً يأملون زواله. وزواله حتميّ بفضل من ذاق الاحتلال وتخلّص منه في جنوب لبنان، بطبيعة الحال، وفي غزّة الأحرار التي أطلقت معركة التحرّر النهائي.