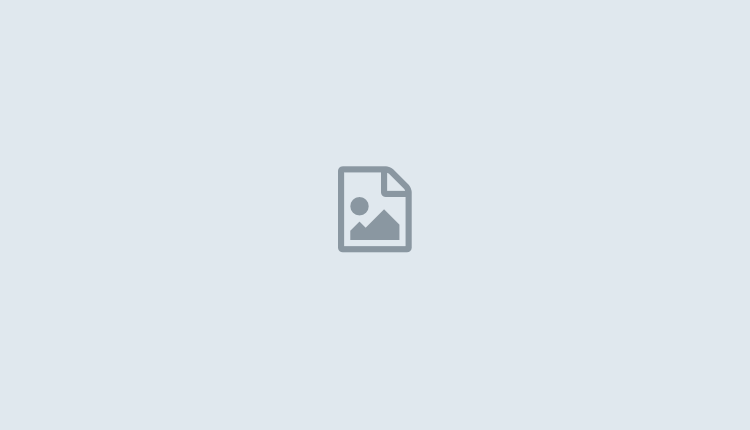التعدّدية القطبيّة وفخّ الدولتين
هشام صفي الدين – وما يسطرون|
«الحرب هي فعل عنفي يهدف إلى إجبار الخصم على تحقيق إرادتنا»كارل فون كلاوزفيتز
الحرب، على حدّ قول المنظّر العسكري البروسي كلاوزفيتز، هي استكمال للسياسة بوسائل أخرى. وسياسة الكيان الصهيوني، منذ نشأته، هي الحرب المستدامة. فهو كيانٌ استيطاني توسّعي يعتمد بقاؤه على إلغاء الآخر إلى حدّ الإبادة. لكنه عاجز اليوم، بالرغم من قوّته التدميرية الهائلة المدعومة أميركياً وبريطانياً، عن تحقيق نصرٍ عسكري في وجْه قوى المقاومة الباسلة على طول الجبهات المشتعلة من غزة إلى لبنان إلى اليمن إلى الضفة الغربية.
يعجز الاحتلال كذلك – حتى هذه اللحظة – عن أن يحقّق بالسياسة ما لم يحقّقه بالميدان كما فعل في حالات سابقة مثل كامب ديفيد بعد حرب ١٩٧٣ وأوسلو بعد الانتفاضة الأولى. لكن الجهود السياسية لتقويض منجزات الميدان لم ولن تتوقّف. تُبذل هذه الجهود على مستويين مترابطين: المستوى الأوّل يتعلّق بترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
الهدف هو عزل فصائل المقاومة الفلسطينية عن حكم أو إدارة القطاع واستبدالها بقوى أهلية أو بسلطة رام الله. تتصدّى «حماس» وسائر القوى الوطنية في القطاع وعموم أهل غزة لهذا المخطّط بنجاح، بالرغم من الضغوط الهائلة من الداني العربي والقاصي الغربي.
المستوى الثاني يتعلّق بمستقبل الصراع والتسوية السياسية للقضية الفلسطينية. تنشط الجهود في هذا المضمار على الصعيد الدولي حيث تأثير قوى المقاومة المباشِر محدود. آخر هذه المحاولات أتت في شهر أيار الماضي على شكل تصويت ١٤٣ دولة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمصلحة قرار يعترف بدولة فلسطينية، تلاه اعتراف رسمي من قبَل ثلاث دول أوروبية (النروج وإسبانيا وإيرلندا).
رحّب العديد من وسائل الإعلام والقوى السياسية بهذه القرارات. البعض اعتبرها من منجزات الضغط الشعبي في الغرب أو نتيجة التحوّل في مقاربة القضية الفلسطينية جرّاء عملية «طوفان الأقصى» وحرب الإبادة المستمرة. والبعض ربما تحمّس بدافع إغاظة العدوّ وكسب النقاط في الحرب النفسية. والبعض الآخر اعتبرها مكسباً ولو رمزياً في ظل موازين قوى جائرة. وقد ساعد موقف إسرائيل الرافض بعنف لتلك القرارات من اعتبارها لمصلحة الطرف الفلسطيني. وقد عبّر مندوب الاحتلال في نيويورك عن هذا الرفض من خلال تصوير عملية التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة تمزيق لميثاق الجمعية.
هذه المقاربات الإيجابية رغبويةٌ وغير موضوعية، وخاصّة أنّ الموقف الإسرائيلي المتعنّت يصوّر أيّ قرار سياسي لا يتطابق بحذافيره مع السياسة الإسرائيلية على أنه منحاز للمعسكر المعادي. إنّ تقييم هذه القرارات يجب أن يعتمد على مضمونها وينطلق من سؤال بسيط: هل تعكس ترجمة ولو جزئية للإنجاز الاستراتيجي الذي أحدثه زلزال «طوفان الأقصى»؟
الجواب هو بالنفي. العكس هو الصحيح. تسعى قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شكلها الحاضر إلى تقويض منجزات ما بعد ٧ تشرين العسكرية وإعادة عقارب الساعة الى الوراء. إنها أوسلو معجّل مكرّر. ينصّ قرار الجمعية العمومية للاعتراف بدولة فلسطين رقم ١٠/٢٣ على التأييد الثابت لـ«مرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ولمبادرة السلام العربية، وللحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام ١٩٦٧».
يثبّت قرار الجمعية العمومية الاعتراف بدولة فلسطين وفق حدود ٦٧ بدلاً من الحدود التي وضعها قرار التقسيم رقم ١٨١ عام ١٩٤٧ والتي على أساسه قامت دولة الكيان. ويلحظ القرار الأممي 12 قراراً سابقاً للجمعية العمومية ومجلس الأمن كمرجعية قانونية، لكنه لا يشير ولو مرة واحدة إلى القرار ١٩٤ الذي ينصّ على حقّ العودة. إنّ حقّ العودة – حتى في إطار «حلّ» الدولتين المزعوم – هو الضامن الوحيد، إلى جانب إلغاء القانون الإسرائيلي الذي يضمن «حق الهجرة» ليهود العالم إلى فلسطين، لمنع تأبيد وجود الكيان الصهيوني كدولة يهودية عنصرية.
تذهب قرارات النروج وإسبانيا وإيرلندا أبعد من القرار الأممي. فهي تشير علناً إلى أنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية هدفه محاربة «حماس» وتعويم سلطة رام الله وإعادة إحكام سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب. وقد أعرب عن ذلك وزير خارجية النروج باث عيد، الذي أعلن أنّ «الهدف هو تحقيق دولة فلسطينية من رحم السلطة الفلسطينية»، ومن أجل ذلك دعا إلى «تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى» والعمل «كي تدير السلطة الفلسطينية غزة بعد وقف إطلاق النار ومن أجل تشكيل حكومة فلسطينية واحدة». ولَم يَفت عيد ممارسة الوصاية الغربية المعهودة من خلال شمّاعة الإصلاح، فطالب الحكومة الفلسطينية بإقرار «إصلاحات ديموقراطية، وتمكين القضاء ومحاربة الفساد».
تسعى قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شكلها الحاضر إلى تقويض منجزات ما بعد ٧ تشرين العسكرية وإعادة عقارب الساعة الى الوراء. إنها أوسلو معجّل مكرّر
لم يحد موقف إسبانيا كثيراً عن موقف النروج. فقد صرّح رئيس الوزراء الإسباني بأن خطوة الاعتراف بفلسطين ليست موجّهة ضدّ إسرائيل، بل «تعكس رفضنا لحماس… التي ترفض حلّ الدولتين». وكأنّ إسرائيل تهرول نحو «حلّ» الدولتين. قد يتوهّم المرء أنّ موقف الحكومة الإيرلندية، نظراً إلى التعاطف الكبير لشعبها مع القضية الفلسطينية، أقلّ حدّة من موقف النروج وإسبانيا. لكنّ رئيس وزرائها صرّح كذلك بأنّ «الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو رسالة تفيد بوجود بديل ملموس لعدميّة حماس. ليس لدى حماس شيء لتعطيه غير الألم والعذاب للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء».
وفي خطاب الاعتراف بدولة فلسطين نفسه، وجّه الرئيس الإيرلندي نداءً إلى مجتمع الكيان: «إلى الشعب الإسرائيلي، أقول اليوم: إيرلندا صارمة ولن تساوم في الاعتراف بدولة إسرائيل وحق إسرائيل بالوجود [والعيش] بسلام وأمن إلى جيرانها. أقول بوضوح إن إيرلندا تدين المجزرة البربرية التي ارتكبتها حماس في ٧ تشرين… حماس ليست الشعب الفلسطيني».
وتسعى كل من النروج وإسبانيا إلى تفعيل فخّ الدولتين بالتنسيق الكامل مع السعودية وقطر. فقد أعلن عيد أن النروج «تتعاون بشكل وثيق مع السعودية من أجل أخذ خطوات فاعلة في سبيل تفعيل الدعم الأوروبي للرؤية العربية». وقامت إسبانيا وقطر بعقد ما سُمّي «الحوار الاستراتيجي الأول» في ٢١ حزيران، كرّر فيه وزير الخارجية الإسباني دعوته إلى إطلاق مبادرة سلام على شاكلة مؤتمر مدريد.
لا غرابة في الدعم الأوروبي والخليجي لمصالح إسرائيل. لكنّ المثير للقلق هو تصويت دول مِثل كوبا وفنزويلا وجنوب إفريقيا لمصلحة قرار الجمعية العمومية (وكذلك لبنان الرسمي الذي اعترف بموجب هذا القرار بإسرائيل دون اعتراض يُذكر). وإذا ما أضفنا تواطؤ النظامين المصري والأردني ومواقف تركيا والصين وروسيا وحتّى سوريا والجزائر المؤيّدة لطرح الدولتين، تبيّن مدى الإجماع الدولي على «حلّ» الدولتين من دون ضمانات واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتفاوض وعلى رأسها حقّ العودة.
بكلام آخر، قد تنعكس التعدّدية القطبية التي يكثر الحديث عنها على المستوى العسكري للصراع في ما يخصّ مصادر وحجم ونوعيّة التسليح المتاحة، وفي ما يخصّ تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى في منطقتنا وفي غياب الحسم العسكري بين الأطراف المتصارعة نتيجة تآكل الهيمنة العسكرية الأميركية. لكنّ التعددية القطبية تلك لَم تنعكس حتى اللحظة على المستوى السياسي.
قد يبدو القلق من التوافق السياسي الدولي حول فخّ الدولتين سابقاً لأوانه في ظل استمرار الحرب وقدرة المقاومة على فرض معادلاتها في التفاوض على اليوم التالي. لكنّ تاريخ الحروب يؤكّد أنّ المنتصر لَم ينتظر يوماً انتهاء الحرب لوضع تصوّر سياسي لما بعد انتهائها. والصهاينة سبّاقون في هذا المجال. وقد يبدو القلق في غير محلّه طالما أن الكيان نفسه يعارض إقامة دولة فلسطينية ويفرض سياسة أمر واقع، وخاصةً عبر تفعيل الاستيطان في الضفة، تجعل من تطبيق خيار الدولتين شبه مستحيل. لكن الرهان على حتمية موقف العدو مجازفة بالثوابت وتخلّ عن زمام المبادرة على الساحة الدولية.
إنّ الحفاظ على المكتسبات الاستراتيجية لـ«طوفان الأقصى» يتطلّب، في المدى البعيد، بناء توافق أو دعم دولي حول مشروع المقاومة المتعلّق بمستقبل فلسطين، أقلّه لدى القوى المناهضة للمشروع الأميركي، وإلّا فإنّ القدرة على استغلال التحوّل في ميزان القوى العالمية ستبقى محدودة. التقصير ليس في صياغة هذا المشروع السياسي، بل في دعمه من قِبل القوى غير المنخرطة في المعركة بشكل مباشر.
لقد عرضت «حماس» في نظامها الأساسي المعدّل عام ٢٠١٧ مشروعاً استقلالياً يتبنّى لغة التحرّر الوطني ويؤكّد على حقّ العودة ويطالب بالقدس (لا القدس الشرقية) كعاصمة لدولة ذات سيادة فلسطينية حقيقية. وتصريحات مسؤولي الحركة ما زالت تدفع بهذا الاتجاه. مع ذلك، يتمّ تشويه هذا الموقف أو نكرانه في الدوائر الإعلامية الغربية، بينما يسارع الإعلام العربي – بما فيه الممانع – إلى التصفيق لأية خطوة – وخاصّة إذا ما صدرت في الغرب – ظاهرها داعم لفلسطين حتّى لو كان باطنها يضرّ بالقضية.
إنّ تقويم حدود وطبيعة التضامن من دون زيادة أو نقصان، وتجذير المشروع التحرري الذي تنادي به قوى المقاومة وتفعيله بين الدوائر الإعلامية والبحثية والجماهيرية والديبلوماسية المتعاطفة مع فلسطين، يدعم الجبهة العسكرية عبر تحصين الساحة السياسية ضدّ أي محاولة للالتفاف على التضحيات الجسام للمقاومة وبيئتها الشعبية الحاضنة. فالصراع في نهاية المطاف هو صراع سياسي حول مستقبل فلسطين: إمّا تأبيد إسرائيل كدولة يهودية عنصرية، أو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.