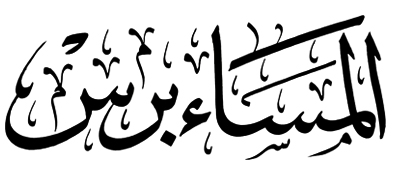أفُق الحرب التجارية: إعادة ضبط التدفّقات الرأسمالية لمصلحة واشنطن
ورد كاسوحة – وما يسطرون|
الغائب عن النقاش بشأن تبعات الرسوم الجمركية، التي فرضها دونالد ترامب، على الخصوم والحلفاء معاً، هو عودة التقلّبات الرأسمالية بشدّة، وبمعدّلات تفوق ما وصلت إليه، أثناء أزمتَي الإقفال الكبير عقب تفشّي فيروس «كورونا»، والفقاعة العقارية عام 2008. المسألة هنا ليست في الانهيارات التي شهدتها البورصات وأسواق الأسهم، قبل معاودة صعودها على إثر تعليق الرسوم المتبادَلة على 75 دولة، بقدر ما هي في السرعة التي سيحصل فيها الانتقال، بين التضخّم والركود، جرّاء «التخبُّط» الحاصل في فرض التعرفات وتعليقِها.
الخضوع للأولويات «الترامبية»
استبعاد النقاش النقدي حالياً، ليس مردّه التأخير في حصول التقلّبات، بل الهامشيّة التي تبدو عليها، في ظلّ طُغيان الأجندة الاقتصادية لفريق ترامب الاقتصادي، إذ ليس ثمّة أولوية، لدى الرئيس ومستشاريه، تفوق التسويق لمنافع فَرْض الرسوم، وما ستجلبه على الخزينة الأميركية من إيرادات، لتمويل التخفيضات الضريبية المُزمَعة وإيفاء الديون الأميركية. حتى الدول المتضرّرة من الرسوم والتي ارتاحت من تعليقها لاحقاً، تبدو بدورها أسيرة الأجندة التي فرَضَها الرجل، بموجب مفهومه عن التكافؤ، أو التبادلية، أو حتى التناظُر، في فرض الرسوم.
هذا في وقت، يشهد، ليس فقط تذبذبات متسارعة في البورصات وأسواق الأسهم وأسعار النفط، على ضوء التقييد الشديد الحاصل للتجارة الدولية، بل أيضاً، عودة سريعة للتقلّبات الرأسمالية، بعد نجاح البنوك المركزية في خفض وتيرتها لمدة، عقب اعتمادها سياسات التشديد الكمّي ورفع أسعار الفائدة. عدم ملاحظة ذلك كما يجب، تجعل الدول وحتى الشركات، محكومة بحلقة مُفرَغة، قوامُها؛ الردود على التعرفات الجمركية الأميركية برسوم مضادّة، وإن يكن نطاقُ تأثيرها أقلَّ بكثير، نظراً إلى صغر حجم اقتصاداتها ودورها في التجارة الدولية، قياساً بالاقتصاد الأميركي، الأكبر والأكثر امتلاكاً، حتى للقيود التجارية وأدوات عرقلة التبادلات، في حال اقتضت مصلحته ذلك.
وهذا يعني، لجهة استحالة تفادي المواجهة مع الولايات المتحدة، الدخول، ليس في حرب تجارية بالضرورة، بل في عالم تسوده أولويات تجارية، لا تعبّر عن الحاجة الفعلية إلى الأسواق، ولا سيّما بعد خروجها بصعوبة، من أزمة التضخّم الأخيرة. والحال أنّ آخر ما يحتاجه الاقتصاد العالمي حالياً، هو الاتجاه لإعادة هيكلة المبادلات التجارية، على نحو جذريّ، بحيث تغدو أكثر تناسُباً مع المسعى الترامبي، إلى التخفيف من العجز الحاصل، في الميزان التجاري للولايات المتحدة.
فلو كانت هذه العملية مختلفة، ولا تصبّ فقط في مصلحة الطرف المهيمن على الاقتصاد الدولي، أو لو كانت في أسوأ الأحوال، محصورة بدولة أو اثنتين كما كانت عليه الأمور، حين بدأ ترامب التفاوض مع كندا والمكسيك على إعادة جدولة الرسوم الجمركية المتبادَلة، لأمكن حصر الضرر أكثر، على اعتبار أنها «تصحيحات اقتصادية» لا تطاول أكثر من 5 أو 6% من الناتج الإجمالي العالمي. غير أنّ شمول الرسوم (قبل معاودة تعليقها بغرض التفاوض على تعرفات جديدة) لمعظم مبادلات الولايات المتحدة التجارية مع دول العالم، يضعها كإجراء اقتصادي، في مرتبة أعلى من مجرّد تصحيحات جزئية، أو حتى، إعادة إنتاج لهياكل التجارة الدولية، ليصل الأمر إلى حدّ المساس بماهيّة الأرباح الرأسمالية، لجهة بنيتها الخاصّة بتدفقات السلع والخدمات والرساميل والأفراد، على امتداد العالم.
الخلفية التاريخية للأزمة
في السنوات التي أعقبت صعود الصين كثاني قوّة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، تغيّرت بنية التدفّقات الرأسمالية، لتصبح متناسبة أكثر مع الانزياح الحاصل، ليس فقط في حركة الرساميل، بل أيضاً في انسياب السلع والخدمات واليد العاملة. التركُّز الذي حصل للصناعات الصاعدة، في أكثر القطاعات الرأسمالية ربحيّة، خارج الولايات المتحدة، ولا سيما في التكنولوجيا العالية والطاقة النظيفة، غيّرَ كثيراً في اتجاهات الثروة وآليات التراكم الرأسمالي، عبر العالم. فبدلاً من استمرار التركّز داخل الولايات المتحدة، حتى مع ديمومة تدفُّق الأرباح شمالاً باتجاهها، ذهبت الحصّة الأكبر إلى الاقتصادين الصيني والأوروبي، وهما، كما نعلم، الأكثر تنافسيةً مع الولايات المتحدة، والمستهدفان حالياً أكثر من سواهما، برسوم ترامب الجمركية.
تصاعُد حرب التعرفات الجمركية مع الصين، لتتجاوز معدّل الـ140%، ليس بهذا المعنى، مجرّد سياسة تفاوضية من جانب ترامب، بل هو بمنزلة محاولة لإخضاعها
لم يحصل ذلك بمحض المصادفة، بل في ضوء التطوّر الذي شهدته عملية التراكم الرأسمالي، والذي كان يقضي بنفاذ الرساميل ومعها اليد العاملة والخدمات والسلع، إلى أسواقٍ أكبرَ وأوسع وأقلَّ بيروقراطية وترهُّلاً، لتحدَّ من انخفاض معدّل الربحية المتزايد، الذي صار يميّز عمل الاقتصاد الأميركي، بفعل القيود المتزايدة التي وُضعَت على حركة رأس المال، هناك.
انفلاش سلاسل التوريد والتصنيع بهذه الطريقة، باتجاه دول مثل الصين والمكسيك وتايوان وفيتنام وحتى الهند، ساعَدَ على عولمة عملية الإنتاج، بحيث صار الطابع التجميعي هو الغالب على إنتاج السلع، ولم يعد ثمّة سلعة تُنتج في بلد واحد، كما كانت عليه الحال سابقاً. هذا جعَلَ الأرباح الرأسمالية، بخلاف مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين كان الصعود الرأسمالي للولايات المتحدة مصحوباً بتركُّزٍ شديد للثروة والإنتاج، داخلَها، تتوزّع على الاقتصادات التي توطّنت فيها الصناعات، ومعها سلاسل التوريد التي تؤمّن لها المواد الخام، والأسواق والعمالة.
صراع الحزبين حول وجهة الاقتصاد الرأسمالي
في المشهد السياسي الأميركي كان ثمّة انقسام حول عولمة التدفّقات الرأسمالية بهذه الطريقة، فالديمقراطيون كانوا دائماً إلى جانب هذا الشكل من التراكم، ولا سيّما في حقبتَي بيل كلينتون وباراك أوباما، اللتين شهدتا ذروة صعود دولة الرعاية الرأسمالية، مع ما رافقها من استقرار وتجذُّر لنموذج الإنفاق الكبير، على الصحّة والخدمات والبيئة والتعليم. بينما على المقلب الآخر، كان الجمهوريون على الدوام، من أنصار ما يسمّونه بـ «الحكومة المصغّرة» واعتماد سياسات التقشّف وضغط الإنفاق إلى الحدود القصوى، ولكن من دون التجرّؤ على المساس بهياكل دولة الرعاية، كما يفعل ترامب حالياً.
إذ لم تكن ثمّة مقوّماتٌ بعد، تجعل من الحمائية، وجهة قائمة بذاتها، أو حتى خياراً يمكن الدفاع عنه وتبنّيه جدّياً، في ضوء استمرار الاقتصاد الأميركي، في الحفاظ على معدّل ربحية، عال. لكن مع توالي الأزمات الاقتصادية، ودخول الاقتصادين الأميركي والعالمي بسببها، في نفق الركود والتضخّم، أصبحت الأصوات الداعية إلى الحمائية والانكفاء عن نموذج التصنيع على نطاق عالمي، مسموعة أكثر، لا سيّما مع بداية صعود «الترامبية» في نهاية ولاية باراك أوباما الثانية. هكذا، أخذَت نظرية الإنفاق الكبير، عبر تفضيل سياسات التيسير النقدي، بالتقوّض، لتحلّ محلّها، على مراحل، نظيرتها الخاصّة بالتقشّف والتشديد النقدي.
في هذا السياق تحديداً، أتَت التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرّها ترامب، والتي شكّلت محور سياسته الاقتصادية في الولاية الأولى، لتمثّل ذروة أولى في بناء هيكل السياسات الحمائية، قبل أن يجري تطويرها وتوسيعها لاحقاً، لتشمل حتى الإيرادات الآتية من الخارج. بمعنى، أن يصبح شرط خلق الوظائف وفرص العمل واستعادة الصناعات، ليس الضرائب المنخفضة على الأغنياء، بحدّ ذاتها، بل الرسوم الجمركية على الدول التي تحقّق فائضاً تجارياً، في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة.
خاتمة
على هذه الخلفية يمكن فهم استهداف الصين بالحرب التجارية أكثر من سواها، إلى حدّ استثنائها من معاودة تعليق الرسوم بغرض التفاوض، على شروط أفضل للولايات المتحدة. فمن منظور إدارة ترامب، تعدّ بكين، الدولة الأكثر استفادة من هجرة الصناعات الأميركية إلى الخارج عبر نموذج سلاسل التوريد والتصنيع، التي تبدو كدولة وكاقتصاد معولم كبير، حلقةً مركزية فيه. هذا إضافة إلى تحقيقها الفائض التجاري الأكبر مع الولايات المتحدة. وهي أمور لا يمكن لإدارة تحمل برنامجاً جذرياً، لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، بما يتناسب مع المصلحة الأميركية، تحمُّلها.
تصاعُد حرب التعرفات الجمركية مع الصين، لتتجاوز معدّل الـ140%، ليس بهذا المعنى، مجرّد سياسة تفاوضية من جانب ترامب، بل هو بمنزلة محاولة لإخضاعها، بعدما مُنيت المحاولة الأولى لفعل ذلك في الولاية السابقة للرجل، بفشل جزئي. لكن هذه المرّة، تبدو الأمور أكثر جدية، نظراً إلى فداحة العجز التجاري الأميركي معها، واستحواذها على جلّ المبادلات التجارية، مع الدول التي كانت تملك الولايات المتحدة فائضاً تجارياً معها، في ما مضى. ثمّة تصميم غير مسبوق هنا، على جعلها تتنازل عن الموقع الذي احتلّته في الصناعات التجميعية المعولمة، وصولاً حتى إلى تفكيك سلاسل التوريد والتصنيع التي أسهمت في توطينها وبنائها، جنباً إلى جنب مع خصوم الحمائية وأنصار العولمة الآخرين، سواء في الاتحاد الأوروبي، أو حتى داخل الولايات المتحدة نفسها.