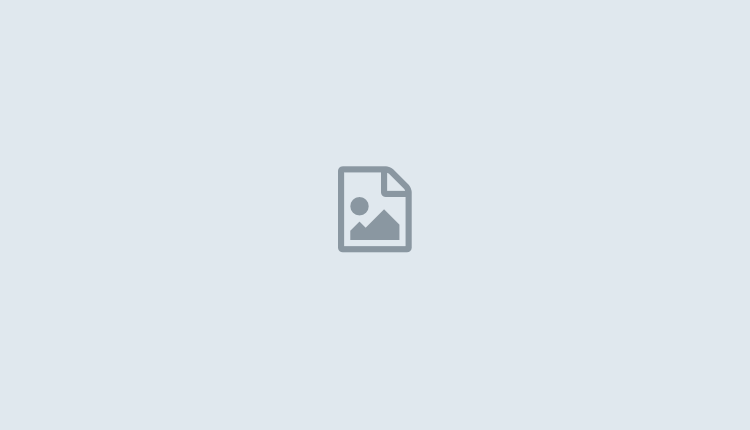حرب أمّة منتصرة
بشار اللقيس – وما يسطرون|
في نقده لضم الضفة الغربية إلى «إسرائيل»، حذّر يائير آسولين في صحيفة «هآرتس» قبل أيام من المزج الفاسد بين الدين والدولة، والذي جاء على حساب الروحانية اليهودية على الدوام. برأي آسولين، دفعت اليهودية ثمناً كبيراً من رصيدها الروحي من أجل قيام «إسرائيل» ولا تزال. خطورة هذه المسألة برأيه أنها جعلت الدين أداة من أجل الدولة، وتركت سؤال القيم والأخلاق والخيال السياسي فارغاً؛ من أنت؟ وما هي القيم التي تحملها؟ وما هدفك في الحياة؟ هذا بالتحديد ما لا تجيب «إسرائيل» عنه اليوم.
لسؤال آسولين تاريخ طويل في المشهد الثقافي في إسرائيل، مع مارتن بوبر وآحاد هعام (تيار الصهيونية الروحية والثقافية) ويهودا ليف ماغنيس (أول رئيس للجامعة العبرية في القدس). كل هؤلاء استشعروا خطراً من الدولة على اليهودية، وحذروا من طبيعة رد الفعل. صعود اليمين الإسرائيلي بالأساس كان رد فعل على التحدي الدولتي الذي فرضته ثقافة حزب العمل على اليهود. اليمين في إسرائيل «ضد دولتي» بطبيعته. بإمكاننا تشبيه اليمين بـ«الماتريوشكا» الروسية، تلك الدمية التي كلما فككتها وجدت نسخة مختلفة منها في داخلها. في اللب يقف حزب شاس، المناهض للدولة وللسياسة برمتها. تعلوه «العظمة اليهودية» بقيادة بن غفير، والصهيونية الدينية؛ التياران غير المعنيين بالدولة، ولا أسئلتها. فوقهما يأتي «الليكود». «الليكود» فضاء ممارسة الطقس اليميني العام. والطقس العام هذا، هو ليس غير الانتصار على الفلسطينيين الأصليين (العماليق بنظرهم) وفرض كامل السيادة على البلاد. وحده الطقس سيعمّد مكانة صهاينة «الليكودج في المشروع الصهيوني كـ«أسياد البلاد وأصحاب المكان». ومع ذلك، يظل طقس «الليكود» غير كاف لتعميد جمهوره إن لم يترافق انتصارهم على الأعداء بقتل «الأب الرمزي» (بالمعنى الفرويدي). قتل الأب وحده سيُمكّن الأبناء من وراثة الآباء المؤسسين. لذا، يخوض نتنياهو اليوم إسرائيل وفقاً لتصور أوديبي لذاته وللصراع. هو يريد قتل بن غوريون وميراث الأحوساليم (النخبة الأشكنازية الحاكمة)، وهو يريد إعادة تعريف الغربيين لأنفسهم في منطق «دولته»الجديد.
لم يرد البريطانيون أن يكون للشيعة صلة بفلسطين. لذا، رسموا الحدود مع الفرنسيين على أن يكون الخط «الثقافي» الفاصل بين شيعة جبل عامل وسنّة الجليل هو الخط الفاصل بين لبنان وفلسطين
تفيدنا أدبيات باروخ كيمرلينغ، مؤسس أدبيات الجيل الثالث من علماء الاجتماع في «إسرائيل»، في تشريح الواقع الإسرائيلي بعيداً من اليمين واليسار. في «إسرائيل» منظوران يتطلّع عبرهما الإسرائيلي إلى ذاته وإلى الآخرين. واحد مغرق بالخوف، وآخر مفرط في القوة. رابين بمنظور كيمرلينغ كان القوة بذاتها، لذا لم يتحرّج الرجل من أن يعد الفلسطينيين بدولة – ولو منزوعة السلاح. رابين لا يخاف أعداءه وهو على النقيض تماماً من بيغن. الأخير سارع إلى السلام لأنه كان يخشى الحروب الكبرى، ولم يدخل بيروت إلا بعد ضمانه حياد مصر. نتنياهو نفس الأمر، عنف الرجل مقرون بخوفه، وأكثر. إفراطه في العنف مقرون بخوفه المفرط. نحن هنا لا نحاول تغييب الواقع (دارج عند كثير من محللي المحور ذكر مثالب الإسرائيلي من قبيل «هو أيضاً يعاني»، وهذا النمط من الخطاب كارثي حقيقة) بقدر ما نحاول فهمه من زاوية أخرى. إن القتل الذي يمارسه اليمين الإسرائيلي في غزة ولبنان هو قتل طقوسي يتيح له إعادة تعريف ذاته تجاه الآخر الإسرائيلي. كما أن استراتيجية نتنياهو هي بالتمام والكمال الاستراتيجية الأوديبية المضادة لبن غوريون. خطيئة بن غوريون بالنسبة إلى نتنياهو في أنه كان غير حاسم. وقد تجلى إرجاء بن غوريون الحسم في مسألتين. الأولى: تهجير فلسطينيي الداخل (عرب الـ48)، والثانية: عدم السيطرة الكاملة على الضفة الغربية. وعليه، يخوض نتنياهو اليوم حرباً من أجل الحسم. حتى وإن بدا الحسم «بيروسياً».
يقترن اسم بيروس الأيبيري (جنرال إغريقي من العصر الهليني)، في الأدبيات التاريخية، بالانتصارات الباهظة الثمن. قاد بيروس عام 280 قبل الميلاد، الجيوش اليونانية من مستعمرات صقلية وجنوب شرق إيطاليا لمواجهة الدولة الرومانية. وبالرغم من انتصاره في معركة هيراكليا، إلا أن جيشه بدا منهكاً بعد الحرب وعاجزاً عن دخول روما. المعارك البيروسية كثيراً ما تكررت في التاريخ، في أواراير بين الأرمن والدولة الساسانية، في الحرب الأهلية الأميركية (في معركتي غيتيسبيرغ وشنسلورسفيل – battle of Gettysburg and Chanoellorsville)، في «الحرب الروسية – الأوكرانية» اليوم (تحاول الولايات المتحدة تحويل النصر الروسي – إذا ما تحقق – إلى نصر بيروسي)، في الحرب الإسرائيلية علينا (كما يتصور الإسرائيليون خواتيمها).
بيروسية وأكثر
تعدّ التقسيمات الإثنية/ الطائفية واحدة من الأسباب المباشرة والرئيسية لتشكيل الخرائط السياسية لمنطقتنا بالنحو الذي هي عليه. عام 1919، قدمت الحركة الصهيونية للخارجية البريطانية خرائط تدّعي حق اليهود بالأرض الممتدة من نهر الأولي (شمال صيدا) إلى منطقة العريش (في مصر). لم توافق الخارجية البريطانية ولا الفرنسية على الخرائط الصهيونية نتيجة أزمة المياه التي يمكن أن تتسبب بها «الخريطة المقترحة للكيان اليهودي» بين لندن وباريس. بعدها بسنوات، وتحديداً فترة الاتفاقيات البريطانية – الفرنسية (بين عامَي 1920 و1923) قسمت الدولتان المستعمرتان الحدود بينهما على أن للندن نهر الأردن وبحيرتي الحولة وطبريا، ولباريس نهري الأولي والليطاني. ومع ذلك، جاءت حدود عام 1943، ثم 1948، على أساس القسمة الطائفية بشكل رئيس. لم يرد البريطانيون أن يكون للشيعة صلة بفلسطين. لذا، رسموا الحدود مع الفرنسيين على أن يكون الخط «الثقافي» الفاصل بين شيعة جبل عامل وسنّة الجليل هو الخط الفاصل بين لبنان وفلسطين. كانت بريطانيا متخوفة من أن يثير احتلال جبل عامل (الشيعي) القلاقل في البصرة وعموم العراق. ومتخوفة من أن تؤثر سياستها في العراق في الوضع الأمني لجبل عامل. مسألة الحدود كانت على نحو من الحساسية والأهمية. فالحدود رُسمت من أجل إدامة النزاعات، ومن أجل إدامة شعوبنا في دوامة من الشلل المستدام. مخاوف بريطانيا وفرنسا لم تكن من تهريب السلاح فقط. في ثورة عام 1936، كان السلاح يُهرب من سهل حوران والغوطة إلى الجليل عبر بنت جبيل (أخبرتني جدتي أن شقيقها الأكبر استشهد أثناء تهريبه للسلاح إلى الثوار الفلسطينيين في الثلاثينيات). المخاوف الحقيقية كانت في أن ينخرط الجنوبيون الشيعة في القتال مع إخوتهم الفلسطينيين، مع ما يمكن أن يستدعي هذا القتال من انخراط لعناصر طائفية وإثنية أخرى في بلاد الشام تهدد بانفلات البلاد من ربقة السيطرة الاستعمارية.
الإشكالية التي تخوّفت منها لندن وباريس، آنذاك، هي نفسها ما انفجر سعيره بوجه الغرب وأميركا بعد «طوفان الأقصى». فأن ينخرط الشيعة والسنّة في قتال إسرائيل معاً، هو حتماً ما لا يرتضيه الغرب ولا يمكن للاستعمار الجديد تخيّله. المعركة صعبة، هذا صحيح، لكنها معركة صعبة لأمّة تطلب النصر وهذا ما ينبغي لنا فهمه. ولقد حسم «طوفان الأقصى» انتصارنا (أياً تكن نتيجة الحرب العسكرية) صبيحة 8 تشرين، يوم قرر ذاك الحسن الجنوبي الشهيد المضي في الحرب إلى آخرها. مرة جديدة، ليست المسألة مسألة عسكرية البتة. فلقد انتصرنا صبيحة السابع من تشرين، لا بفعل الإنجاز النوعي الذي حققته «القسام» فقط، بل بتحويل «القسام» المشهد العسكري إلى زحف شعبي لن يُمحى من ذاكرة شعوبنا ولا من تاريخها ووعيها. ولقد انتصرنا صبيحة 8 تشرين عندما أسقطت مقاومتنا الحدود المعرفية، والسياسية، والديموغرافية التي أسسها لها الغرب، منتصرة لغزة. فصارت «كل دروب الجنوب غزة» وهذا ما يخيف إسرائيل. و«كل أرض العراق يافا» وهذا ما يخيف إسرائيل. وصارت كل شعوبنا الملتحمة بلحمها ودمها، بصبرها وصدرها وعرائها، شهيدة، وهذا ما يخيف إسرائيل. لقد انتصر «طوفان الأقصى» فينا، لجذوة، كانت لازمة للنصر الذي نرتقبه. ولو تأجل هذا النصر بمعركة، ولو كان على بُعد جيل. وتذكروا، هزيمة إسرائيل لن تكون بنصر بيروسي، كما يتخيله اليسار في تل أبيب اليوم، بل بولادة أمّتنا نحن، وهذا ما لا يفقهه اليسار عندهم ولا اليمين.