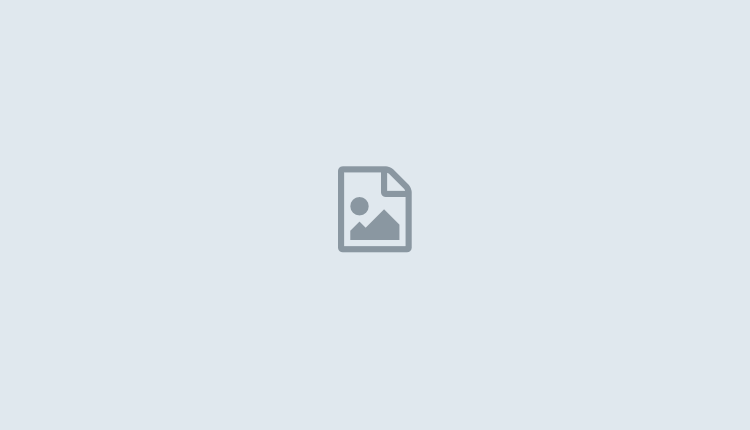بين الهزيمة والنصر.. حزب الله باقٍ
محمد الحسيني – وما يسطرون|
لطالما طوى الشوق الدائم إلى بلدتها صفحات أيامها بأمل اللقاء، ولطالما رفعت يديها عند آذان كل فجر هامسة بآيات العودة إلى بيتها العتيق في قرية “المسكن والمثوى”، ولطالما حملت في حقائبها أوراق من “عطرية” شباكها الأخضرتارة إلى بلاد الاغتراب وتارة أخرى إلى حي “النبعة” في شرق مدينة بيروت، حيث أصابتها هناك مصيبة في الأرزاق والأملاك نتيجة للحرب العبثية (العام 1976)، فهُجّرت قصراً وعادت طوعاً إلى المكان الأقرب إلى قلبها، والأحب إلى أبنائها التسعة، إلى قريتها العاملية من ناحية النبطية، هناك أطعمتهم من خبزها وزيتونها الجنوبي على وقع الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، وهناك تلقت نبأ مقتل زوجها وشريك حياتها قنصاً خلال طلبه للرزق في منطقة البربير غرب مدينة بيروت وذلك في أوائل ثمانينات القرن الماضي…
إنها الحاجة “أم ناصر” التي نشأت وترعرعت منذ طفولتها على يوميات العدوان الصهيوني المتكرر ضد الجنوب اللبناني، فحرصت على نقل مشهدية الظلم هذه لأبنائها، وفي وجدانها “واقعة كربلاء”، شأنها في ذلك شأن مثيلاتها من الأمهات الجنوبيات ممن ربيّن أولادهن على أنّ أحرف الشرف والكرامة تُكتب برصاص المقاومة. وحين أدرك أبناؤها كغيرهم من الشبان اجتياح العام 1982 للبنان، انخرطوا في صفوف المقاومة لدّحر الاحتلال وتحرير الأرض …لكن لليل سواده الذي يأبى أن يفارق لباس “أم ناصر”، ومع ابتسامة الأم الصابرة التي تُغطي آلامها عند “فراق الأحبة” تلقت الخبر تلو الخبر والفجيعة تلو الفجيعة بارتقاء أبنائها الثلاثة شهداء في عمليات متنوعة ضد مواقع الاحتلال الاسرائيلي، أولهم في محيط موقع “برعشيت” العام 1987 وثانيهم في محيط موقع “بئر كلاب” العام 1994 وثالثهم على محور “النبطية” العام 1995.
لكن أنّى لحكاية المقاومة و”إم ناصر” أن تنتهي، إذ ارتقى لها في يوم واحد خلال الأسبوع المنصرم شهيدين شقيقين، هما حفيديّها أحمد وعبدالله دفاعاً عن أرض الجنوب وعن لبنان في معركة “أولي البأس”… ولم تنته حكاية “إم ناصر” عند هذا الحد، فهي ما زالت ترابط في بيتها العاملي ترفض مغادرته على الرغم من الدمار الذي أصاب محيطه، جالسة على عتبة الدار متكئة على عصاها الخشبية التي طالما رافقت وحدتها، تنتظر مع كثير من الأمهات خبر من هنا أو هناك عن أبنائهن ولسان حالهن يقول: “أوَ تسلم المقاومة؟…إذاً خُذّ حتى ترضى”…
وإن كانت حكاية المقاومة هي ذاتها في كل زمان ومكان، تبدأ بممارسة شتى أنواع الظلم والإضطهاد والاستعباد ضد شعب حر أو ضد مجتمع ما، وإن كانت لا تُختصر بحزب أو حركة أو تيار أو حتى طائفة ما. فإنه تبقى لحكايتها مع شيعة لبنان روايتها “السرمدية”، فهي نهج حياة فرضته حيثيات وجودهم في هذه الأرض منذ مئات السنين، فضلاً عن الامتداد العقائدي المتجذر في نفوسهم، وما زادهم صلابة التاريخ الطويل من الإضطهاد السياسي الذي لحق بهم، فضلاً عن محاولات التغيير الديموغرافي الذي أصابهم عبر العصور، وذلك تبعاً لكل من حاول بسط نفوذه على بلاد الشام، حيث ثبت شيعة لبنان في أرضهم، وصمدوا في جبال لبنان متمسكين بمقاومتهم إلى أن اندحرت كل الاحتلالات والحملات التي حاولت إلغاءهم… وحين جاء الكيان الصهيوني وانضوا الشباب الجنوبي تحت لواء التنظيمات الفلسطينية والأحزاب الوطنية والقومية واليسارية في بداية خمسينيات القرن الماضي بغية مقاومة الاحتلال، بقوا في أرضهم واستمرت مقاومتهم وحافظوا على سلاحهم، في الوقت الذي تراجعت فيه جميع هذه الأحزاب والتنظيمات بعدما اندثرت عقائدها وألقت سلاحها ..
واليوم في الوقت الذي تستمر فيه الاعتداءات الوحشية للعدو ضد المدنيين والعسكريين، عدا عن ارتفاع وتيرة التدمير العشوائي للمدن والقرى اللبنانية، يخرج البعض ليُجاهر بفخرعن انتهاء دور حزب الله وهزيمته، تارة عبر استغلال التحديات الداخلية التي يواجهها حزب الله في ظل تزايد الإرهاق بين اللبنانيين، وتارة أخرى بالتصويب على أنه المسبب في نزوح آلاف العائلات من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية والبقاع بعد فقدان منازلهم، والأخطر من ذلك ما تُعلن عنه فئة من “الجامعيين” لازالت تعيش في وهم “الميثولوجية التناخية” بما تحويه من آيات القتل والتدمير، في محاولة لإسقاطها على قوات الاحتلال وكأنها “جيش الرب” الذي يُطبق “عدالة السماء” ضد شريحة كبيرة من اللبنانيين، ما يؤكد أن هذه الحرب ليست ضد فصيل مسلح ومقاوم فقط، إنما أرادوها “حرباً توراتية” لا تبقي ولا تذر على غرار مجزرة أريحا في “سفريشوع”.
ومن بعد هذا الكم الهائل من التصريحات الداخلية غير المطمئنة، هل تُسلم المقاومة سلاحها؟ ومن بعد نوايا العدو بالإبقاء على لبنان “منطقة عمليات ناشطة له”، هل يتخلى حزب الله عن دوره المقاوم؟ وبغض النظر عن السردية التاريخية للاعتداءات الصهيونية على لبنان التي تجعل من الجنوبيين قبل حزب الله لا يتخلون عن دورهم المقاوم، فإنه مازال بيد حزب الله العديد من عناصر القوة تجعل من الاستحالة في مكان أو زمان انتزاع سلاحه عنوة مهما اشتدّ عليه الخناق، لأسباب عدة أبرزها:
-
القدرة السريعة لدى المقاومين على التعافي واستعادة زمام المبادرة في الميدان، بعد أن فشل العدو في كسر إرادتهم بسبب فقدانهم لمعظم قاداتهم وللكثير من وسائل القيادة والسيطرة لديهم، حيث أظهروا بأساً وثباتاً قل نظيرهما عند القرى الحدودية الجنوبية.
-
مازال المقاومون على الجبهات الجنوبية يتصدون لجيش الاحتلال، باعتمادهم أسلوب القتال ضمن مجموعات صغيرة إذ استطاعوا خلال شهرين ويزيد من عرقلة تقدمه واستنزافه، وتكبيده الخسائر المرتفعة عند كل تقدّم، حيث بلغت منذ بدء عدوانه البري أكثر من 1200 ضابط وجندي بين قتيل وجريح فضلاً عن عشرات الدبابات.
-
قلق العدو من استراتيجية المقاومة في الاستعداد لحرب عصابات طويلة الأمد ضد قواتهم في الجنوب، فلغاية الآن لم تنشر المقاومة بعد أو تستنزف كل مقاتليها البالغ عددهم حوالي 40 ألف مقاوم، فضلاً عن اعتراف العدو بنجاح محدود في تقليص قدرة المقاومة على تنفيذ هجمات بصواريخ بعيدة المدى ذات رؤوس متفجرة كبيرة، وفشلهم حتى الآن في القضاء على الصواريخ القصيرة المدى التي تستهدف مستوطنات الجليل.
-
مبدأ التفاوض تحت النار الذي يُصر عليه العدو، حطمته المقاومة حين دكت صواريخها عاصمة الكيان المحتل “تل أبيب”، وذلك عشية وصول “آموس هوكشتاين” إلى بيروت في رسالة مباشرة لمن يعنيهم الأمر بأن الكيان يفاوض أيضاً تحت النار.
-
إصرار العدو على السماح له بإبقاء لبنان “منطقة عمليات ناشطة لقواته”، يعود لإدراكه التام بالخسارة الاستراتيجية التي بدأت مؤشراتها تظهر، حيث ما زال يقف عاجزاً عن تحقيق أهدافه التي أعلن عنها، أهمها عجزه عن تحقيق نصر حاسم ضد المقاومة، فضلاً عن اتساع دائرة التهجير القسري داخل الكيان منذ بداية العدوان بدل أن تضيق، بعد أن شملت صواريخ ومسيرات المقاومة مدينة حيفا، مما أفشل هدفه الرئيسي من عملياته البرية التي أطلقها تحت عنوان “العودة الآمنة لمستوطني الجليل”، وذلك على الرغم من محاولاته إظهار بعض النجاح في التقدم داخل بعض القرى الحدودية عبر وسائل تواصله الإجتماعي.