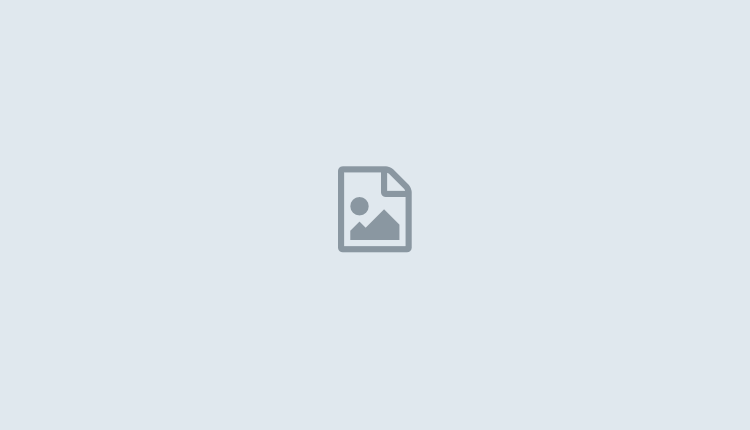لا شمس تشرق من الغرب… ولن تضيء الليل نجمة سداسيّة
عبدالحليم فضل الله – وما يسطرون|
عام 1985 غادر العدو السياسة اللبنانية من دون رجعة، مكتفياً بشريط من الأراضي بزعم حماية حدوده. قبل ذلك بثلاثة أعوام بلغ ذروة تغلغله السياسي في لبنان بمحاولته استغلال الاجتياح للعبث بنظام الحكم. طُرد العدو من العمق اللبناني بالمقاومة وطرد معها من السياسة الداخليّة. وهذا ليس تفصيلاً، فالأطماع السياسيّة في لبنان كانت لعقود عدة هي الغالبة على أذهان قادة الحركة الصهيونية وفي ما بعد لدى حكومات الكيان. وغذّت الليونة الرسميّة اللبنانية منذ خمسينيات القرن الماضي هذه الأطماع وجعلتها واقعيّة بنظره، وزادت منها الأيادي الممتدة إلى العدو طلباً للدعم المادي أو المساندة، من سياسيين وانتهازيين ما أكثرهم. اطمأن العدو إلى «حسن الجوار» فازدهرت الحدود اللبنانية الفلسطينيّة وتضاعف عدد السكان والمستوطنات وتجرّأ العدو بعد تردّد سابق على إقامة أول مدينة حدوديّة هي كريات شمونة.
في زمن المقاومة عاد لبنان ليكون هاجساً أمنيّاً وعسكريّاً لـ»إسرائيل» بلا أوهام سياسيّة. ومضى زمن طويل لم نسمع فيه تعليقاً واحداً من قادة العدو على حدث لبناني داخلي، وسرى هذا اليأس على المراهنين عليه في الداخل، الذين بدّلوا وجهاتهم وغالباً ما وضعوا أوراقهم بيد الأميركيين أو جعلوا ولاءهم للدول العربيّة الأقرب إلى واشنطن. ولم تجدِ نفعاً آراء هؤلاء، التي ألقيت في الكواليس على أسماع الأميركيين أو قيلت علناً في وسائل الإعلام أثناء حرب تموز، في تبديل نظرة العدو إلى منزلقات السياسة اللبنانيّة.
ما زال العدو وسيبقى يراهن على القوّة، القوّة العارية، في مقاربة الوضع اللبناني، وسيبقى ينظر إلينا من زاوية أمنية وعسكريّة. لكن لماذا لا يتقدّم خطوة إلى الأمام فيغذّي ترهات المراهنين على تغيير آت من الخارج؟ قد يكون كلام بنيامين نتنياهو في بداية هذه الحرب عن تغيير أوضاع لبنان أول همس صهيوني يطرق الآذان بشأن قضايانا الداخليّة منذ عقود، وكذلك كلامه اللاحق عن تحرير لبنان من قبضة حزب الله وإيران. لا نحمّل الأمور أكثر مما تحتمل، فهذه طريقة نتنياهو في المراوغة والتضليل وبناء الحجج وركوب الموجات. لكن ذلك يظهر بداية وعي في طرف العدو بأنّ الحرب استكمال للسياسة بمعناها الواسع، وأن القتال وحده لا ينجز المهمّة.
الخطاب الداخلي المعادي للمقاومة قد يغري العدو بالتوغل أكثر في دهاليزنا السياسية، فما لا تنجزه الحرب من الخارج تستكمله النزاعات من الداخل، وكما لدى العدو جبهته الداخلية الهشّة واستقطاب حاد مفتوح على انقسامات عميقة، فلدى لبنان خاصرته الرخوة المحكومة إلى توترات مزمنة تستدعي الأطماع الخارجيّة. تغذّي التصريحات والأقوال التي تتردّد على ألسنة خصوم المقاومة، مبرّرات حروب الإبادة ومسوّغات القتل نفسها: الدروع البشريّة، احتماء المقاومين بالسكان، نزع سلاح المليشيات… هم لا يعون الفارق بين خصومتهم مع حزب الله وحجم التهديد الذي يمثّله الاستنهاض الصهيوني الجديد. لا يعرفون أنّ المقاومين في الجنوب وأبطاله واستشهادييه إذ يحرسون حدود الوطن فإنما يدافعون عن المجال الذي يتيح لهم مقعداً في مسرح السياسة. تغيير لبنان هو خطوة محسوبة في رسم الخارطة الجديدة للمنطقة وجزء من إستراتيجية إقليميّة شاملة يُراد فرضها على الجميع، هذا يفتح صندوق المفاجآت ويحرّك عواصف لا تستثني أحداً.
أيّها المراهنون، لا زرع ينبت فوق الرماد.
للمطبّعين الجدد:هذا ليس مركبكم
عام 2006 أضافت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة كونداليزا رايس إلى جعبة سرديّات الحرب، استيلاد شرق أوسط جديد. لم ينطوِ ذلك على مبالغة خطابيّة بل عبّر عن إستراتيجيّة أميركيّة جدّية مهّد لها المحافظون الجدد في نصهم (بيانهم) الشهير»فتح نظيف». كانت آلة الاستكبار تتقدّم بقوّة وتحطّم في طريقها أمماً ودولاً وأنظمة. أسهمت حرب تموز في إعطاب هذه الآلة ووجّهت تحذيراً جادّاً بصعوبة تحقيق الأهداف وكلفتها الباهظة. قبل ذلك فكّر جورج بوش الابن بضرب إيران لكنه تهيّب التورط فيها بعد نتائج تلك الحرب.
غادرت أوهام الشرق الأوسط الجديد العقل الأميركي لتحطّ في الخيال الإسرائيلي. يريد نتنياهو استيلاد شرق أوسط جديد يعبّر عن طموحاته الثلاثة: التطبيع الشامل، وتصفية القضيّة الفلسطينيّة، وأن يكون المركز السياسي والاقتصادي للمنطقة على حساب الآخرين لا بالتكامل معهم كما يُدّعى. يغذّي الاستعلاء والإحساس بالتفوق أوهام العدو الخطيرة، وسيكون ضحية أوهامه، التي يغذيها تواطؤ المتواطئين، وهرولة من يريد جعلها حقائق. ما يفوت هؤلاء أن حكومة العدو تسعى من خلال الحرب إلى صوغ دور «إسرائيل الجديد» الذي سينمو على حساب الآخرين كلّهم، أعداء وأصدقاء، فلا حاجة إلى الشراكة والتعاون بمعناهما القديم بعد الانتصار المطلق. والنصر المطلق هو الأفق الجديد لشرق أوسط إسرائيلي أكثر منه أميركيّاً، وسيحظى إذا أفلح العدو بضوء أخضر من واشنطن، التي تريد ادخار طاقتها للمنافسات العالميّة الكبرى. فما يضيرها أن ينوب أحد عنها في ضرب المعادين وقمع المخالفين واستدعاء المتردّدين وتثبيت أقدام المطبّعين، وبأقل ثمن.
إنّ بناء شرق أوسط جديد بمنطق «إسرائيل» يحتاج إلى نيران مشتعلة في كلّ جغرافيا المقاومة التي هي مشروع إستراتيجي متكامل لا تبعيّة فيه. إيران التي تعي أنّها الهدف النهائي، تنوي زيادة ميزانيتها العسكرية ثلاثة أضعاف لتضاهي مثيلتها الإسرائيليّة، وبذلك تكشف عن إستراتيجيتها الفعليّة التي هي الدفاع من العمق (أي بالاعتماد على قدراتها)، وليس كما يقال الدفاع في العمق (بالاعتماد على حلفائها). وحشيّة العدو ونجاح الجانب الإرهابي في حروبه يحييان زمن المغامرات. هناك في الغرب من يعيد إلى التداول وظيفة عفا عليه الزمن للاحتلال، بالقول: ألا ترون كم «إسرائيل» هذه مفيدة وفعّالة لنا، وكم نحن بحاجة إلى من يمارس ألعابنا القذرة ويصرف فائض القوّة خارج أي معيار قانوني وأخلاقي ولا يرى نفسه مضطرّاً أن يحسب حساباً للقانون الدولي أو الانضمام إلى معاهدة دوليّة تقيّد بطشه.
أيها المطبعون، أين مقعدكم في هذا المركب؟
للواهمين الجدد: ليست حربكم
لم تكن المنطقة في تاريخها القريب موحّدة المصالح كما هي اليوم، لكنها ليست موحّدة الأهداف بالقدر نفسه بوجود من يعتقد أنّ الزمن السياسي للفتنة لم ينته بعد. لقد اجتازت المنطقة عشريّة الحرب والنار، وترى نفسها محكومة للتقارب إذا أحسنت قراءة مصالحها، ولاحظت بالخصوص ضخامة التفويض الأميركي المعطى لـ»إٍسرائيل» باستعمال القوّة. صحيح أنّ العنف موجّه نحو قوى المقاومة لكنه يطال الجميع، بل يهدّد أعضاء النادي الإبراهيمي بأن يكون تطبيعها مع إسرائيل جديدة، إسرائيل «البعث الصهيوني» لا القوّة الناعمة، ويهدّد دول التسوية بشرق أوسط جديد تُنسج قماشته من خيوط أوطانها (الأردن) أو على حساب دورها ومواردها (مصر).
لقد انجلت الحقائق على وقع شلال الدم في غزّة ولبنان، لكن الحروب الاستكبارية في المنطقة تنبش أوهاماً وترّهات طواها النسيان. يفترض الواهمون أنّ في وسعهم الحصول على مكاسب وغنائم لا يد لهم في تحقيقها، كما لو أنّ حربي غزة ولبنان تستكملان حروب الربيع العربي وما قبله. يغفل الواهمون أنّنا في زمن سياسي جديد، المنطقة فيه قطعة في لعبة عالميّة أكبر، وأنّ أميركا تبحث عمن يحقّق لها مصالحها ويخفّف الأعباء عنها. فشل بعض دول الخليج في أداء المهمّة ووجدوا أنفسهم ضحيّة مقاربة خطأ قوامها شراء الحماية من واشنطن. لم تعترف أميركا البتّة بالمصالح القوميّة والأمنيّة لحلفائها (عدا «إسرائيل» بالطبع)، وتجاهلت هواجسهم وتصرفت على أنّها تبيع ولا تشتري، بل تأخذ دون مقابل، كما فعل وسيفعل دونالد ترامب بلا حرج وعلى رؤوس الأشهاد.
يغفل الواهمون أنّنا في زمن سياسي جديد، المنطقة فيه قطعة في لعبة عالميّة أكبر، وأنّ أميركا تبحث عمن يحقّق لها مصالحها ويخفّف الأعباء عنها
لقد وافقت الدول العربية الدائرة في الفلك الأميركي على الانضمام إلى شبكة الدفاع الجوي الإقليمي والإنذار المبكر التي جُرّبت أول مرّة في حماية الكيان من المسيّرات والصواريخ الإيرانية والعراقيّة واليمنيّة، وتناسوا أن الهجمات ضدهم جرى تجاهلها مرّة تلو أخرى. فعل ذلك ترامب غداة حصوله على مئات المليارات من الصناديق السياديّة العربيّة، ولم يمهل الموقعين على اتفاقات التطبيع الإبراهيمي (يا لمفارقة التسمية) حتى يبتلع الرأي العام تنازلاتهم المخزية، فعاجَلهم بنقل السفارة الأميركية في الكيان إلى القدس وتأكيد الاعتراف بها عاصمة لـ»إسرائيل». وحين شخّص بعض حلفاء أميركا من العرب مصلحتهم في طيّ صفحة الخلاف مع سوريا قُطع عليهم الطريق لإبقاء نار الأزمة عنوة تحت الرماد. ومع ذلك لم تتورع الإدارة الأميركيّة (بايدن وترامب معاً) عن فتح خطوط الترغيب والترهيب مع دمشق. وأسهم الأميركيّون في إذكاء نار الخلافات بين حلفائهم العرب أنفسهم، ونقلوا التنافس في ما بينهم إلى مرحلة متقدّمة من الصراع، كما في قضية حصار قطر والتنافس الإماراتي السعودي الملتهب خفية على الدور والوظيفة، والذي نرى ظلاله في حروب اليمن والسودان وليبيا. وتُرك الحبل لنتنياهو على غاربه في حربه على غزّة وأضيء له طريق الترانسفير، دون تقدير لعواقب ذلك وانعكاسه على دولتين حليفتين هما الأردن ومصر.
تنتظركم إسرائيل أخرى لا تجد مبرراً لمعاملة أحد بنعومة زائدة، وتتلقى دعماً أميركيّاً مفتوحاً بمعزل عمن يمسك بمقاليد السلطة في البيت الأبيض ومن لديه الغالبية في الكنيست. ولا يغيّر من هذه الحقيقة انكشاف حدود قوّة العدو من دون دعم أميركيّ. لا أفق للحروب الإسرائيليّة بنظر تل أبيب ولا تساهل في دعمها بنظر واشنطن، والاحتلال هو العقدة الجامعة لهوية كيان لا يجمعه شيء آخر سوى الغلبة. ولا بأس من التكرار، إسرائيل الجديدة لن تحتاج، إن تغلّبت، إلى تسويات مع أحد، ولن تسدّد فواتير مقابل ما ستناله من تطبيع واتفاقيات «سلام». من يفترض أنّه يمكن مقاسمة العدو، ولو دون مناصرة، مكاسب حروبه الإباديّة واقع في وهم خالص. لن يكون لأيّ كان نصيب في النتائج، وبالكاد سيسمح للراغبين بتنظيف المسرح ودفع كلفة الحطام.
أيها الواهمون، هي ليست حربكم فلا توقظوا البراكين الخامدة.
للغرب: عالم سيولد
لم يستند القانون الدولي في يوم ما إلى المبادئ السامية كالعدالة والإنصاف والحقوق بل كان نتيجة صراعات وحروب. مع ذلك، فإنّ المساومات التي قام بها مهمّشو العالم ومستضعفوه بعد الاستقلال وفي خضم توازنات الحرب الباردة أضفت مسحة منصفة على القانون الدولي، كتكريس حقّ الشعوب في المقاومة وتقرير المصير. أراد الأميركيون التحوّل إلى نظام قائم على القواعد، التي تعبّر عن مصالحهم وتتبدّل بتبدّلها، لكنهم مع دونالد ترامب قد يذهبون بعيداً في العمل على نظام دولي من دون قواعد أصلاً. يراوغ ما يُسمّى الغرب الواسع قدر الشراكة، ويصعب عليه تقبّل وجود عالم أقرب إلى اللاقطبيّة. يفضّل الغرب عالماً أحاديّاً يدور في فلكه، أمّا إذا عجز عن ذلك، فلا مانع من هيكليّة عالميّة متعددّة المراكز يقف هو على رأسها. في وسعه أن يتدبّر أمره مع قوى كبيرة أو كبرى أكثر مما يمكنه فعل ذلك مع قوى أصغر إقليمية أو أقل من إقليمية، تابعة أو غير تابعة لدولة.
وتواجه النظرة الأميركيّة الغربيّة للعالم ثلاثة تحولات لا تتماشى مع نظرته للأمور. التعاون بين دول الشرق والجنوب في إطار منظّمات مرنة عابرة ومتعددة الأهداف («بريكس» الموسّعة، «شنغهاي»…) تضمّ دولاً لديها أجندات مختلفة لكنّها قادرة على إبعاد قضايا الخلاف من مجرى المصالح المشتركة (الصين والهند). هذا يتعارض مع الترسيمة الغربية للعالم: محاصرة الدول والأقطاب الصاعدة من خلال توسيع الهوّة مع جيرانها ونشر التوتر في محيطها، وإذكاء التناقضات لحبس فائض القوّة الذي قد يهدّد الغرب في عقر الدار. لم يصلح ذلك في مواجهة الصين وروسيا وحتى في وجه إيران ما اضطر الأساطيل الأميركيّة وحلف الأطلسي إلى التواجد مباشرة في بحر الصين وإلى دعم أوكرانيا و»إسرائيل». لم تنجح القوّة الخشنة للنظام القديم في حبس المنافسين على النظام الدولي (دول التوازن) داخل الجدران، لا في أوكرانيا حيث ينقلب المشهد تدريجيّاً لمصلحة روسيا، ولا في الصين حيث لم تنجح خطة دفع الصين إلى ما وراء خط الجزر. ولن تفلح «إسرائيل» بحروبها الإباديّة في كسر دائرة التغيير التي تمثّل باقي العالم وتكافح في تقرير مصيره، وتضمّ دولاً وروافع إقليميّة ذات قرار مستقل ومقاومين من أجل التحرير والحرّية وحركات اجتماعيّة مناهضة للهيمنة.
للمقاومين
تقفون على حدود فاصلة بين عالم قديم لا يريد أن يموت وآخر يُراد له بقوة الظلم الغاشمة ألا يولد. أنتم طلائع الزمن الجديد وشركاؤه وقدرنا الذي لا مردّ له. لم تشعلوا نيران هذه الحرب كما يحبّ خصومكم أن يرشقوكم به، بل كانت امتداداً لرغبة حمقاء ودمويّة لإبقاء ستار الظلام مسدلاً على شعوب الأرض. أنتم طليعة من يحطّمون الجدار. لم يعد هذا حلماً وطموحاً، من صمد في غزة تحت نيران الإبادة والقتل دون تنازل، ومن قاتل في لبنان بشرف وحسٍّ إنساني وقّاد، يستحق أن يكون ركناً من أركان عالمنا الجديد. تقاتلون في حرب تصل في زمنها وشدّتها أضعافاً مضاعفة لجميع الحروب العربيّة الإسرائيلية؛ 400 يوم من القتال حتى الآن، أي أكثر بمرتين من أيام القتال في جميع الحروب النظاميّة بين العرب و»إسرائيل». نمجّد في تلك الحروب تضحيات كل فدائي وجندي فيها، لكن أحابيل السياسة حيناً وضعف الإرادة السياسيّة حيناً آخر حالت بينهم وبين الأهداف التي بذلوا دماءهم من أجلها.
نثق بكم وأنتم تدفعون ثمن السيادة الحقيقي، وتعيدون الحياة إلى منطق الأمن القومي العربي، وتضعون اللبنة الأولى في استقرار مستدام، وبناء سياسي يعبّر عن آمال شعوب المنطقة وتطلّعاتها، وعقد إقليمي مرض للجميع، وتوازنٍ مع المنافسين والخصوم والأعداء وحضورٍ قويٍّ إلى جانب الأصدقاء.
نثق بكم إذ تعيدون المياه إلى مجاريها الصحيحة، بنهجكم الذي لم يتبدّل. لم تنزلوا عن التلّ عام 1985 عندما قيل لا ضير في قليل من الاحتلال، ولم تصغوا عام 1990 لهمس من رأى التحرير تفصيلاً هامشياً في ميثاق السلام الداخلي. ومنذ البداية أدركتم عقم مسار مدريد ثم أوسلو وحرصتم طوال الوقت وكلّ الحرص على السلم الداخلي، وصرفتم أسماعكم عن وصف تضحياتكم بدورة العنف حيناً ومساواتكم بالعدو طوراً آخر حتى قبل تحرير عام 2000، وجعلتم ظهركم محميّاً سياسيّاً واجتماعيّاً وميثاقيّاً. لقد بنيتم عالماً معاكساً للذي يريدونه، التعددية مقابل العصبيّة، والوحدة في مقابل التجزئة، والاعتماد على الذات في مقابل الرهان على الآخر، والإيمان مقابل عبثية خرقاء، والحريّة في وجه العبوديّة.
أيها المراهنون غادروا الأوهام فلن تشرق شمسٌ من الغرب ولن تضيء نجمة سداسيّة ليلكم الطويل.