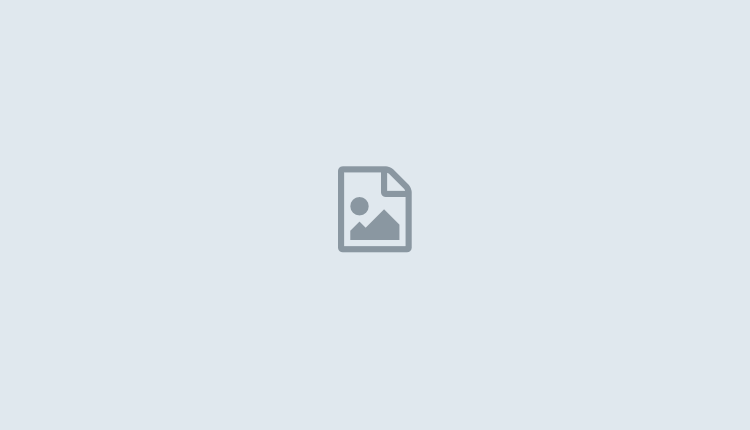كيف مثّل «الطوفان» أزمة لـ«المفكِّر العربي»؟
موسى السادة – وما يسطرون|
حاول علي شريعتي التمييز بين مصطلحي المفكّر والمثقّف، ولكننا في ظرفنا الحالي سنتجاوز هذا التمييز، بالتركيز على تعريف شريعتي بأن من ينطبق عليه مصطلح (المفكِّر/المثقّف/الأكاديمي)، هو الشخص المنشغل بالعمل العقلي والفكري. وأن دوره ومساهمته في المجتمع – من الناحية النظرية – هما عملية إنتاج الفكر، أي إنهما جزء من عملية الإنتاج في أي بنية اقتصادية-سياسية لأي مجتمع. وعليه، ولكي نحلّل «المفكِّر العربي» علينا الانطلاق من موقعه في النظام الاقتصادي-السياسي العربي وبل العالمي، أي «عضويته» بتعبير أنطونيو غرامشي.
ولذلك، تبدأ عملية فهم «المفكِّر العربي» من تتبّع موقعه هذا، والتي ستصلنا في الأخير إلى الريع الخليجي. لكن هذا التتبّع ليس سوى منطلق للاشتباك مع طرح المفكِّر، لا أن تتحوّل مسألة تكرار كشف العلاقة العضوية بالريع إلى نوع من المناكفة الاعتباطية والفوضوية، أقرب للحفظ منها إلى الفهم، عاكسة ضعفاً في المنطق لا قوة، حيث تلعب دور رجل قشّ للتغطية على كسل فكري، أو التهرّب من مسؤوليتنا في التأكيد لجمهورنا ولغيرنا، أننا في جبهتنا لدينا الأسس الفكرية والنظرية الثورية القادرة على الاشتباك وإثبات ذاتها بالمنطق والحجة في كل الحقول المعرفية.
من هنا، وبما هو أعمق من أسطوانة العلاقة بالريع الخليجي والقواعد الأميركية، لنتتبّع ما أحدثه «طوفان الأقصى» من أزمة لـ«المفكِّر العربي»، وبالشكل الذي ضرب عمق البناء الأيديلوجي لمؤسساته البحثية والفكرية ومواقعه الإلكترونية والإعلامية.
مكَّنت القوّة المالية «المفكِّر العربي» من إنتاج بنية فكرية من الأعلى، كوّن عبرها شبكة من الأكاديميين والمثقّفين يعملون على إعادة إنتاج أطروحات فكرية، وإغراق المكتبات والمواقع الإلكترونية بها. ولأنها من الأعلى (ولا جدال على كونها من الأعلى سوى إن استيقظنا في عالم تكون فيه ثروات الأمير تقع في أسفل السلّم الطبقي العربي) وقبل أن يصرحوا بذلك، فنحن نعلم أنها بنية قائمة على الليبرالية، فالليبرالية بتكوينها كأيديولوجيا تصاغ وينتمى لها من الأعلى ضمن نادٍ نخبوي مغلق. وأيضاً، ولأنها من هذا السياق الطبقي، فلها رمزية اجتماعية وفوقية، حيث يكون «المفكِّر العربي» محتكراً للأكاديميا ورونقها ومصطلحاتها، إلى درجة الولع الذاتي بها، تمكّنه من لعب دور الوصاية والوعظ الفكريين، تقوده إلى أن يظنّ أنه «سيفكّر» ثم سيجري التاريخ والحدث كما فكّر له، ثم ستواكبه وتلتحق من خلفه «الشعوب».
من هذه الخلفية عمل «المفكِّر العربي» بآلة جبارة على إعادة تقديم مقاربة القضية الفلسطينية، أو كما يسميها مسقطاً أل التعريف «قضية فلسطين»، حتى لا تختلط مع «القضايا» العربية الأخرى؛ فالسوريون والعراقيون واليمنيون «منشغلون بقضاياهم» وفقاً له. قدّم «المفكِّر العربي»، عبر كتابين، طرحاً بأسلوب أكاديمي فيه الكثير من صخب المصطلحات والمفاهيم، واصطناع متعمّد لتعقيد المشهد الحالي والتاريخي لفلسطين، بشكل يحيل إلى أنّ الوضع في فلسطين استثنائي، لا يمكننا فيه تبنّي نموذج الاستعمار الاستيطاني أو حتى نموذج الفصل العنصري، بل منزلة بين منزلتين لها خصوصية تستدعي تبنّي «منظور جديد». ما يقوم به «المفكِّر العربي» هنا، هو العمل على نزع متعمّد لفلسطين عن سياقها المتّصل بتجارب النضال ضدّ الاستعمار والإمبريالية، وما تؤول له هذه السوابق من دروس وإستراتيجيات. وهدفه هنا ادّعاء الخصوصية، وهي في المناسبة محاولة موسعة لذات «الخصوصية لعرب الداخل» التي يتبنّاها. بطبيعة الحال، نعم، فلسطين ظرف تاريخي له خصوصيته ضمن المشاريع الغربية الاستعمارية، ككل تجربة سبقتها بظروفها الخاصة، ولكن هذا الظرف حتماً لا ينزعها من كونها نموذج تحرّر من الاستعمار الاستيطاني. إلا أن خلاصة ما يهدف له «المفكِّر العربي» ويحاول تمريره عبر عجن للمصطلحات والمفاهيم هو أن «قضية فلسطين» تمثّل في نهاية المطاف صراعاً حول المواطنة لا حول ملكية الأرض.
يعود سبب هذا التعريف إلى حاجة «المفكِّر العربي» إلى إلحاق فلسطين، رغم خصوصيتها الاستعمارية التي تؤهّلها لنطلق عليها تسمية قضيتنا المركزية كعرب، إلى سلّة «القضايا العربية» والتي هي بدورها صراعات حول المواطنة وحقوقها ضد الاستبداد. وبالتالي، يقود هذا التشخيص إلى أن المسألة في فلسطين تتطلّب نضالاً ديموقراطياً للوصول للمواطنة المتساوية بين المستعمِر والمستعمَر. وهذه ليست أوّل مرّة تقدّم فيها المواطنة كحلّ لقضية استعمارية، فقد عمل المستلبون للخطاب الليبرالي والديموقراطي الفرنسي في الجزائر على المساواة في المواطنة في العلاقة بين فرنسا «وجميع أبنائها» منذ العشرينيات.
يقول «المفكِّر العربي» إن من مصلحة الفلسطينيين طرح برنامج ديموقراطي يعمل على أساس دولة ثنائية القومية يوفّر بديلاً عقلانياً للإسرائيليين اليهود. وضمن هذا المسار الطويل الأمد فعلى الفلسطينيين الدمقرطة بشكل يشمل بناء المؤسسات التي تضم القوى الديموقراطية داخل المنطقة وخارجها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤَلّف الذي يشرح فيه «المفكِّر العربي» هذا «المنظور الجديد» صدر باللغة الإنكليزية، فيما يعكس مخاطبة النادي المغلق من الناشطين الليبراليين عرباً وغربيين لا كبرنامج عمل شعبي لفلسطين ومخيماتها. والمفارقة أن ترجمة الكتاب للعربية صدرت بعد «الطوفان»، ما استدعى «المفكِّر العربي» إلى إصدار مؤلَّف ملحق حمل عنوان «الطوفان» لمحاولة مواجهة الأزمة التي بدأت مع السابع من أكتوبر، وهذا ما يوصلنا إلى أزمة «المفكِّر العربي» و«الطوفان».
إنّ منطلق الأزمة التي سبّبها «الطوفان» أن مجموعات من المقاومين العرب، وبدمائهم وسلاحهم، أحدثوا انقلاباً عبر ممارسة مباشرة للنظرية الثورية في الميدان، بشكل وجد فيه «المفكِّر العربي» نفسه فجأة في مؤخرة الحدث، وأن على العملية التنظيرية من برج مؤسساته الفكرية مواكبة الحدث التاريخي الذي صنعه إسلاميون من أبناء المخيمات من الخلف. شكّل انقلاب المكانة هذا صلب أزمة «المفكِّر العربي»، وفيما يعطف عليه، مآلات «الطوفان»، من وحدة جبهات المقاومة العربية، إلى اكتساح فلسطين للرأي العام العربي والعالمي. ولذلك، ولمواجهة الأزمة، لم يتمسّك بالمنظور الديموقراطي ذاته فقط بل عمل في عجلة من أمره على طرح تقييم ختامي لـ«الطوفان»، يفضي إلى أنه بُني «على حسابات خطأ».
إنّ إحدى ركائز منظور «المفكِّر العربي» هو أنّ المقاومة المسلّحة ليست إستراتيجية تحرير لفلسطين، ولا يستطرد «المفكِّر» كثيراً في شرح لماذا؟ بل ينطلق من التسليم بالحسم بذلك، لأنها لم تنجز «تحريراً» وبأنها أصبحت «حالة دفاعية رادعة» أياً كان معنى ذلك. وأنّ المقاومة العربية في فلسطين ولبنان لم تشكّل حركة تحرّر، لغياب الشرط الديموقراطي كي تكون كذلك، مشيراً إلى تناقض الإسلاميين مع قيم المواطنة والعلمانية. ينطلق تقييم «المفكِّر» للكفاح المسلّح من طرحه الأولي الهادف إلى نزع فلسطين عن سياق تجارب الكفاح المسلّح ضد الاستعمار السابقة، إذ إنها لا تصب في مصلحة «المنظور الجديد»، رغم أن مرافعته القائمة على اختلال موازين القوة لمصلحة «إسرائيل» هي ذاتها مرافعة كل من وقفوا ضدّ حركات التحرّر ضد الاحتلال في التاريخ.
في الأخير، تتلخّص أهداف «المفكِّر العربي» في مسألتين، وفي كلتيهما يعمل على تزييف متعمد للحقائق وليس مجرد خطأ في قراءة المشهد، إذ يدّعي أن لـ«الطوفان» منجزين لم يكونا أصلاً من مخططات المقاومة وحركة «حماس». وهما إنهاء تهميش القضية عربياً والتضامن العالمي بسبب الفظائع الإسرائيلية -لا العمل المسلّح الذي كان أثره عكسياً على الرأي العام العالمي وفقاً له. يزيّف «المفكِّر العربي» وهو يعلم حقيقة أن الكفاح المسلّح أثبت المقدرة على إنتاج حاضنة شعبية متضامنة في العالم دون الحاجة إلى المفردات الليبرالية ومشروعه في الترويج لفلسطين عبر «القيم الديموقراطية». وأن أوسع تضامن شعبي منذ النكبة يرفع فيه المثلّث الأحمر ويتضامن معك عشرات الألوف في شوارع «أعرق» عواصم أعرق الديموقراطيات الغربية متحدّين قمعها، وبمزيج من احترام القوة والبطولة في المقاومة والمظلومية في التضحيات.
الجانب الآخر المهم لفهم سيكولوجية «المفكِّر العربي»، هو الموقف من حركات المقاومة العربية في لبنان واليمن والتحامها بالطوفان، فهذا الموقف لا ينطلق فقط من كونها تندرج ضمن إستراتيجية الكفاح المسلّح. بل لأنها حركات سياسية اجتماعية فاعلة، فنحن نتحدث عن حقيقة موضوعية عن كون حزب الله أكبر حزب وحركة اجتماعية وسياسية ممأسسة في تاريخ بلاد الشام الحديث، وعن «أنصار الله» أكبر حركة اجتماعية وسياسية في تاريخ الجزيرة العربية الحديث. وهنا ينطلق موقف «المفكِّر العربي» من مزيجٍ بين الحقد الأيديولوجي والطبقي، فهو يعلم أن الليبرالية لا تؤسس حركات اجتماعية جذرية، ولكنها تؤسس شبكة مصالح وانتفاع من الناشطين حول العالم يمكنه أن يكون على رأس هرمها.
إنّ ما يجب التصدّي له من قبلنا، هو أنّ «المفكِّر العربي» يعمل عبر مؤلّفاته وبما بعد «الطوفان» من مواقف واستنفار للناشطين من ليبراليي «الربيع العربي»، على النيل ممّا يسميه «تأثير كتائب القسّام في قيادة حماس»، وإستراتيجيتها للتحرير وحساباتها لـ«الطوفان»، ورهانها الناجح العابر للحدود على باقي حركات المقاومة العربية. ظاناً بفوقيّة أكاديمية ونخبوية على الحركات الإسلامية ومقاوميها، أن ليس للمقاومة وللشهيد السنوار من أقلام وعقول قادرة وبشكل علمي ومعرفي وتاريخي -أي بأدوات المفكِّر نفسها- قبل أن يكون انتماءً أيديولوجياً تقديم طرح رصين لـ«الطوفان» والكفاح المسلح كإستراتيجية وحيدة للتحرير. أما المنطلق الآخر، فأنّ «المنظور الجديد» لـ«المفكِّر العربي» من الخطورة الجمّة، أنه ليس سوى تمكين وتواطؤ مباشر مع مشروع مجانين الصهيونية في إتمام آخر مراحل إبادتها للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة والذي يريد «المفكِّر» مواجهته بالدمقرطة. ففي حين يكتب المفكِّر «وسوف تظل إسرائيل خائفة من احتمال صعود خيار الديموقراطية في العالم العربي؛ فهي لا تستسيغ اللايقين الإستراتيجي الدوري المتمثّل في انتظار نتائج الانتخابات في دولة عربية»، فنحن لن نتخلّى عمّا أحدثه «الطوفان» من خوفها الإستراتيجي أنّ من أي بقاع العرب والمسلمين اليوم سيستهدفها صاروخ أو طائرة مسيّرة.