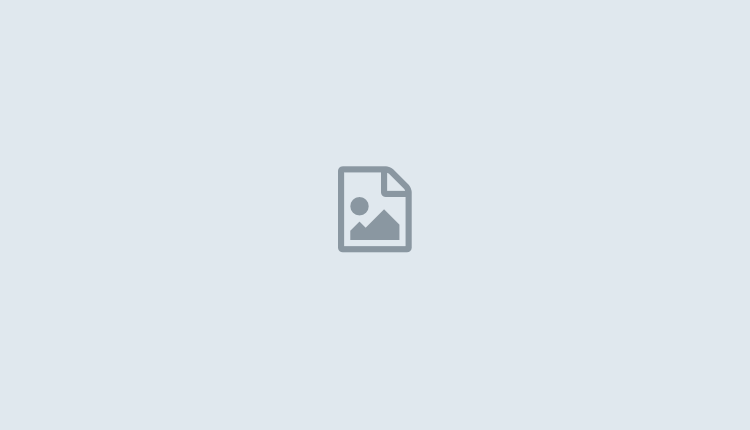وراء العدو في أمستردام؟
احمد ضياء دردير – وما يسطرون|
أمام هذه الأحداث الجسام، أستأذن القرّاء في محاولة للتفكير معهم جهراً وأن يعذروني إن كانت بعض الأفكار التي سأطرحها غير ناضجة أو مهلهلة أو حتى متناقضة.
منذ بداية الحرب على غزة، أو ربما من قبل ذلك، أستدعي أيام «وراء العدو في كل مكان» وأقول إن هذا الشكل من العمل الفدائي ربما كان ليردع الغرب الذي يشكل مع العدو الصهيوني جبهة إمبريالية واحدة؛ لم يكن ليكسر في يوم وليلة الرابطة الإمبريالية (سنون من العمليات المجيدة لم تنجح في ذلك) ولكن ربما ردع شيئاً من غلواء الغرب أو ألزمه نوعاً من الحياد السطحي.
لديّ فكرة أخرى غير مكتملة (وإن كان عليها شواهد في المصادر التاريخية)، وهي أن أحد الأسباب التي نقلت الجمهور الفرنسي من التطرف في التمسك بالجزائر إلى الحياد في المسألة الجزائرية هو ما فاض من الصدامات بين الجزائريين من جهة والمستوطنين والسلطات الفرنسية من جهة أخرى ووصل البعض منه إلى فرنسا وأماكن أخرى من أوروبا. لم تنه هذه الصدامات عنصرية الفرنسيين ولا استعمارية فرنسا ولكن وكأنّ الفرنسيين قالوا وإن من باب العنصرية: دعوا هؤلاء الهمج، الجزائريين والمستوطنين الذين أصابتهم همجية الأرض التي استوطنوا فيها، يتصارعون مع بعضهم بعيداً عنا.
لا يعني هذا الاستهانة بالرأي العام ودوره، ولو عدنا إلى مثال الجزائر فجبهة التحرير كسبت الرأي العام العالمي حتى وهي تخسر «معركة الجزائر» ميدانياً، ما عجّل بانسحاب الفرنسيين. ولكن ماذا لو كان العالم فعلاً لا يفهم إلا لغة العنف؟ لا أتحدث هنا فقط عن مسألة الرد على العنف بالعنف، ولكن كيف أن العمل العنيف يصنع أبطاله الذين يمكن للجمهور العالمي الذي ربّته هوليوود على ثقافة العنف والعدوان أن يستمع إليهم ويفهمهم: فلننظر إلى علاقة الإعلام العالمي الملتبسة بكارلوس أو، بدرجة أقل، بليلى خالد أو حتى بياسر عرفات (هل كانت هذه العلاقة ممكنة قبل عمليات أيلول الأسود؟ السؤال هنا حقيقي أكثر مما هو بلاغي) أو بالفتى المغربي الذي تتناقل صفحات التواصل الاجتماعي صورته، بعضها تمجيدٌ وبعضها بصفته مطلوباً للعدالة؛ العنف هنا يصوغ لغة لها رموزها ووجوهها وجمالياتها، تفرض على العالم الاستماع وتيقظ ضميره وإن نحا إلى التشويه والإدانة.
لا أستطيع ولا أجرؤ من موقعي أن أجادل أي أساليب النضال أنجح أو أشرف أو أجمل؛ ولكن لأعرض فكرة أخرى غير مكتملة:حرب التحرير الشعبية بالطريقة التي تخوضها حماس وحزب الله تعني الالتحام التام بالحاضنة الشعبية، وهذا كما تعلمنا تجربة الصين وتعاليم ماو تسي تونغ من مصادر القوة. ولكن هذا يعني أيضاً أن إسرائيل تعرف أين ترد وكيف تؤلم هذه الحاضنة. أما في وجه النوع الآخر فماذا تفعل؟ هل ستقصف أمستردام؟ هل ستفرض الحصار على الأحياء العربية في المدن الأوروبية؟
طبعاً هذا كلام نظري، وربما يكون قاصراً: البنية الإمبريالية قادرة على الملاحقة والاعتقال وأن تجعل حياة الناس جحيماً، وعلى تنظيم العنف خارج إطار القانون (ويبقى في وجه ذلك قرار الناس أن يواجهوا بالرغم من المخاطر) بل ويمكن الرد عليه من واقع التجربة العملية، فعندما استهدفـ»نا» الرياضيين في ميونيخ رد طيران العدو باستهداف مخيمات اللاجئين، وعندما خطفـ»نا» الطائرة إلى مقديشو قتلوا أصدقاءنا في السجون الألمانية (ثم قالوا إنهم انتحروا)، وهكذا.
تبقى هذه الفكرة سؤالاً، إذاً: في وجه عدو يتبع سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية، هل الوسيلة الأنجع هي حرب التحرير الشعبية أم «وراء العدو في كل مكان»؟ ويبقى هذا السؤال نظرياً (وضرباً من التذاكي والعبث، ربما) ما لم تلتقطه جهة فاعلة ويصبح سؤالاً مشروعاً إذا كانت جماهير المتضامنين مع المقاومة قد بدأت بالفعل في التقاطه بشكل ربما يكون عفوياً.
فكرة أخرى: كان القرنان التاسع عشر والعشرون (حتى قرب نهايته) قرنَي التنظيمات السياسية. حتى الثورة الفرنسية التي نتخيلها زحفاً عفوياً للجماهير كانت في جانب كبير منها عملاً تنظيمياً للنوادي السياسية والأجنحة التقدمية في البلاط والجيش ثم أصبحت التنظيمات السياسية سمة سائدة في أوروبا وتحت ظل الدولة العثمانية وفي عالمنا العربي. نعم كانت هذه فترة دخول الجماهير إلى المعترك العام ولكنه كان كذلك عصر التنظيمات الشعبية والشعبوية المرتبطة بحركة الجماهير (ولهذا كان من الطبيعي أن ينتظم العمل الفدائي في شكل تنظيمات شبه حزبية). أما الآن فنحن في «عصر الجماهير الغفيرة» (أستعير المصطلح من كتاب لجلال أمين) بمعزل عن التنظيم.
لم تختف التنظيمات، بطبيعة الحال (ولن تختفي وإن تغيرت أشكالها)، ولكنها لم تعد السمة السائدة في عالم تتحرك فيه الجماهير السائلة ويعاد تشكيل توجهاتها في كل لحظة إعلامياً. أو ربما نكون في لحظة تغيير جديدة أو كنا بحاجة إلى تغيير نظرتنا إلى الجموع من بعد ثورات 2011 (كنت عن نفسي ميالاً إلى الجماهير على حساب التنظيم حتى قيام هذه الثورات، ثم من بعد هزائم الثورة المصرية وانحرافات الثورة السورية أصبحت أؤمن بدور التنظيم، وإن لم يكن حزباً بالمعنى الرسمي أو المتعارف عليه، في ضبط حركة الجماهير).
بينما في العقد الثالث من القرن العشرين يصبح تركيز المقاومة في تنظيمات بعينها حاضراً فقط في قلب المعركة بينما حولها لا يوجد سوى جماهير سائلة قد تتظاهر دعماً (فيُزجّ بها في السجن أو تحاصر على سلم نقابة الصحافيين كما يحدث في مصر) أو تنتفض وتمارس أشكالاً من العنف الثوري العفوي كما حدث في أمستردام أو ما حدث في مدن أخرى استهدفت فيها الجموع الغاضبة أهدافاً للعدو. ولا نزال نبحث عن التنظيم السياسي والشعبي الذي يستطيع أن يكون داعماً حقيقياً للمقاومة فلا نجده.
أو ربما أطرح السؤالين أعلاه كما يطرحهما أدعياء الفكر المنعزلون عن الواقع، كأننا نجلس أمام قائمة اختيارات ونختار. المسألة ببساطة أن ظروف الاحتلال تفرض المقاومة، والشعب يختار من ضمن الممكن ويطوّره ويتخطاه؛ وأن عنف الاحتلال يولد عنفاً مضاداً، وما الطوفان القائم سوى رد الفعل الطبيعي والمنطقي.
يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى تجارب حرب التحرير في القرن الماضي؛ وإلى فرانز فانون ونيلسون مانديلا، مع الفارق بينهما. يقول الأول في كتاباته والثاني في مرافعته (بأشكال مختلفة) إن عنف الاحتلال يولد عنفاً شعبياً مضاداً، وواجب الثورة هو تنظيم هذا العنف في شكل يدحر الاستعمار: وبينما قال الأول ذلك من باب تمجيد العنف الثوري المقاوم، والثاني من باب الاعتذار عنه، فكلاهما بدأ لا بأخلاقية هذا العنف ولكن بحتميته (فليتعلم ليبراليونا ومستغربونا من مانديلا: هذا العنف واقع حتماً مهما صرخوا أو أدانوا، والعبرة في تنظيمه في شكل يقلّل الخسائر لا في التباكي كما لو كان ممكناً منعه). استعارة الطوفان هنا مفيدة ليس فقط لأن الطوفان حادث طبيعي لا يمكن منعه، ولكن لأن الماء بالذات، وهذا يعلمه جيداً المهندسون الذين يعملون في المعمار أو مع الماء، لا سبيل لمنع تدفقه؛ ولكن توجد سبل كثيرة لتنظيمه في خزانات وجداول وأقنية وفي تنظيمه في مولدات للطاقة أو خراطيم مياه تدك سواتر العدو الترابية.
السؤال إذًا ليس «هل» وإنما «كيف»: هذه الطاقة الهادرة حتمية وبينما إدانتها هي نوع من السخف فإن تمجيدها والتصفيق لها (وإن كان ذلك ضرورياً) لا يكفيان.
وفي النهاية، وإذا كان واجبنا أن نُنظِّر للمقاومة لا عليها، وإن كان ما حدث في هولندا وما حدث ويحدث في سائر أنحاء العالم امتداداً لطوفان المقاومة، فإن لنا أن نقرأ الأحداث ونتعلم. في وجه المخاطر الأمنية، وفي وجه تصاعد العنصرية الأوروبية وتضاؤل الحريات في الغرب، اختارت ثلة من الشباب العربي في أمستردام المواجهة، ربما لأنها تعلم أن القبضة الأمنية مهما فعلت بها فلن تكون شيئاً فيما يفعله جيش العدو في فلسطين ولبنان. ما حدث يشي بأشكال خلاقة من التنظيم: تتحدث وسائل التواصل الاجتماعي عن براعة هؤلاء في إخفاء وجوههم بينما يتحدث الصهاينة عن تنادي هؤلاء الشباب على بعضهم من خلال مجموعات على تطبيقات الاتصال، وقيل عن طريق مجموعات للسائقين. كل هذا، صدقاً كان أو كذباً أو مبالغة، يمكن أن يصبح درساً في التنظيم والفعل، وقد نستطيع أن نبلور من خلاله يوماً رؤية للدعم المستمر لجبهات المقاومة.
* الأخبار اللبنانية.