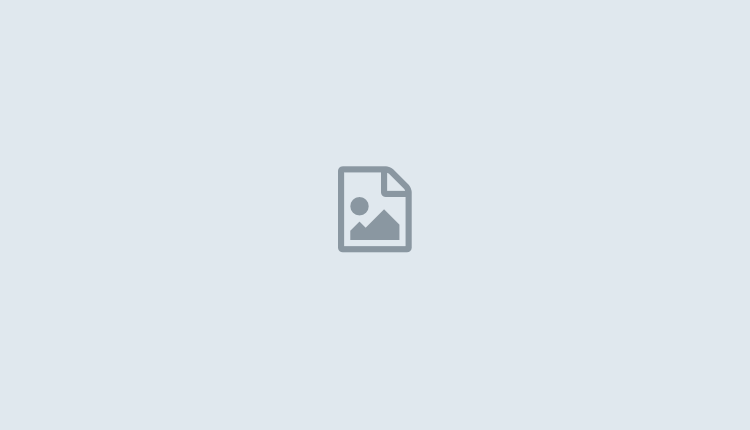«ولا تَحْسَبَنّ»… عن الموت والأفكار
عوني بلال – وما يسطرون|
«وبالجملة، فالموت طريق نجاة يركبها المؤمنون، لَقوا فيه ما لقوا وسُقوا منه ما سُقوا، كل ذلك يهون لمَا يُفضِي بهم إليه» ــــ عبدالحق الإشبيلي.
كل حضارات الدنيا لها صندوق طوارئ في أزمنة الحرب. صندوق تحفظ فيه أدباً وحكمة وكلاماً جليلاً لساعات الحاجة وأيام الكرب. وعندما تعصف الريح بأغلى ما يملكه المرء، بإيمانه ووعيه، يجد نفسه -على غير موعد- واقفاً هناك، أمام صندوق الإرث العالي، يفكّ مغاليقه ليبحث عن شيء يسنده ساعةَ الشدة. إرثنا ليس عادياً، ولا أعلم إن تجمَّعَ لأمّة في صندوقها ما تجمّع عندنا. ليس هذا غروراً حضارياً. بل ربما هو عكس الغرور تماماً لأنه يشهد لأمّة بينها وبين الكرب قرابةٌ وأخوّة ولها باع في النكبات، ولذلك فهي تحتاج ذخيرة لوعيها ووجدانها بقدر ما تحتاج ذخيرة للقتال. الأكيد الذي لا يحتاج برهاناً أنه ما من كتلة سياسية في التاريخ تعرّضت لبرنامج اغتيال منهجي وشامل كتلك الكتلة التي تواجه إسرائيل اليوم. صحيح أن هذا كان نهج إسرائيل دوماً، لكن التمكين التقني سمح لهذه النزعة في ضرب الرؤوس وإبادة الرموز أن تبلغ مداها الأقصى. ليس القصد هنا تصويراً ملحمياً للمقاومة (فملحميّتها لا تحتاج بياناً)، بل وصف مباشر لفلسفة إسرائيل في حربها على أعدائها: الإفناء الجسدي الشامل.
كثيراً ما نردّد بأن الأفكار لا تموت. نقولها رغم أن أكثرنا يعلم في قرارة نفسه أن البقاء لله، وأن الفكرة التي يفنى أنصارها تغيب في ظاهرها معهم. القناعات والقيم كيانات سديمية تَحيا في صدور البشر. الإنسان شرطُها الوجودي. وإن لم يكن شرطَها فهو بالحدّ الأدنى برهانُها والرئة التي تتنفس وجودَها عبره. والاعتراف واجبٌ في ساعة كهذه؛ أننا نخشى على «فكرتنا» وسط شلال دم يسيل من قيادات المقاومة ورموزها في كل الساحات. وهذا تحديداً ما يحمل المرء، عن وعي أو من دون وعي، صوب صندوق تراثنا الأوّل؛ تراثنا الذي يحكي كثيراً عن موت البشر بوصفه جسراً لعبور المبدأ، وعن فناء الأجساد بوصفه جلاءً للمعنى وشرطاً لبقاءٍ أسمى.
لمن يرون في الموت تحرّراً من حمولة الأبدان وتحوّلاً إلى حيّزٍ وجودي أعلى، فالشهادة تمثّل شكلاً أقصى للحياة. الموت حينها ليس إلا استخلاصاً للفكرة التي تسكن الإنسان وتحريراً لها من قيدٍ مادّي كان يعطّلها. هناك رسالة قصيرة كتبها مسكويه بالقرن الرابع الهجري ولها عنوان مهيب: «في الخوف من الموت». وعلى قصرها الشديد، فهي تحفة وجدانية، ولو قرأها الراطنون اليوم بأسطوانة «ثقافة الحياة بوجه ثقافة الموت» لفقدوا صوابهم ولم يُبقوا شتيمة بحق مسكويه إلا وصاحوا بها. كيف لا وهو الذي يكتب قائلاً: «وذلك أن هذا الموت هو تمام حدّ الإنسان.. فالموت تمامُه وكمالُه، وبه يصير إلى أفقه الأعلى. فمن أجهلُ ممن يخاف تمامَ ذاته، ومن أسوأ حالاً ممن يظن أن فناءَه ونقصانَه بتمامه؟».
مَن يطيل الوقوف أمام أدبيات كهذه -وما أكثرها في تاريخنا- يدرك شيئاً يستحق الانتباه: أن هناك معنى مضمراً عجيباً في أدبيات الموت عندنا. ليس معنى مقصوداً في غالب الأحيان، لكنه آتٍ من السحر الكامن في الكلام العالي؛ الكلام الذي يبدو خلّاقاً للمعنى الجديد حتى وهو متمترس في حضن اللفظ القديم، الساكنُ في صوته ونصّه لكنه جامحٌ في الدلالة والإشارة. تقرأ لحبّان بن الأسود: «الموت جسرٌ يوصل الحبيب إلى الحبيب». فتدرك القصد الظاهر، لكنك -في حضرة كل هؤلاء الشهداء الذين حولنا اليوم- تبصر أيضاً مقصداً متجدداً، يعتمل في الكلام ويغلي بداخله. فجأة، يتسع المعنى الذي يخص وصال المخلوق بالخالق ليشمل شيئاً أكبر، والجسرُ الذي دشّنه شهداؤنا لا يعود جسر وصال صوفيّ فقط، بل شيئاً يشد الباقين على الراحلين، ويجعل من الفقد لحظة «جسرية» وبوابة عبور.
كل قديمِنا في أيام كهذه يبدو فائضاً بأكثر مما فيه… أو أننا احتجنا إلى كل هذا الذي حدث حتى ندرك حقاً ذاك الذي فيه.
أيُّ انتباهة فكرية كبرى أثارها رحيل ثلّة من خيرة ناسنا وأئمة مقاومتنا، وأي تحفّز وتوتّر جهادي قدحه هذا الموت الممتدّ
وبعيداً من موروثنا الجليل، هناك في التاريخ الأحدث ما يقرأه المرء أيضاً في مسألة المقاومة وفعل الاغتيال. واحدةٌ من وجوه هذه المسألة تجدها في مفارقة وضيعة حصلت بتاريخ تصفية القيادات والفاعلِين الثوريين، وهي أن الولايات المتحدة أدارت إحدى أكبر الحملات المنظمة لإبادة رموز جبهة التحرير الوطني الفيتنامية وكوادرها تحت اسم «برنامج الفينيق». ماذا عسى المرء أن يقول: الرمز الأهم للانبعاث بعد الموت (الفينيق) كان عنواناً مخابراتياً لقتل قادة الثوار والمنخرطين في العمل التحرّري. برنامج إجرامي محض، متوَّجٌ بتسمية أسطورية مقدّسة. هل من شيء أكثرَ أميركيةً من هذا؟ دارت هذه الحملة بين عامَي 1967 و1972، وقُتل فيها أكثر من 25 ألف إنسان، وقد عدّها الفيتناميون أنفسهم واحدة من أخطر مفاصل الحرب. لا نعود إلى المثال الفيتنامي لأن له «نهايةً سعيدة» نتكئ عليها ونمنّي أنفسنا بمثلها (انكسار العدوان وفشل أهدافه)، بل لأن شيئاً في جوهر التجربة والمواجهة -رغم آلاف الاختلافات التي يمكن سردها- هو ذاته.
وكما في المثال الفيتنامي، فكل هذا الذي يحدث أمامنا اليوم، في أساسه، هو حربٌ على فكرة. كل ما يشنه مغول النجمة المسدسة ضد الوجود المحسوس لأهلنا وشعبنا وقادتنا، كل ما يصبّه هؤلاء من أدوات إبادة حسية لا غاية له بالنهاية -ولا محرّك له بالبداية- إلا تحطيم فكرة تلبث في أذهان الناس. لم تنشأ حركات المقاومة في وجه إسرائيل رغم الاغتيالات. هي نشأت لحد كبير «ببركة» الاغتيال؛ بوطأته وضغطه وفي بوتقة ناره. تقاسيم هذه الحركات ارتسمت بعصف أعمال التصفية المستمرة، وقائمة القادة الشهداء صارت كبيرة للحد الذي يبدو فيه ابتذالاً أن يبدأ المرء حتى بسردها. لكن هناك ما يجدر أن يُسجّل على هامش قائمة كهذه: إنّ حركة مثل حركة حماس، التي تُرمَى بالأصولية والتحجّر والانغلاق، هي لربما أكثر حركة تداولاً للسلطة وتعاقباً في القيادات عرفها العالم العربي في تاريخه المعاصر. هذه الاغتيالات حَكَمت بتجديد إجباري للدم طوال الوقت. وبينما يلوك البعض أدبيّات التحوّل الديموقراطي ليل نهار، فإنّ حركات المقاومة الإسلامية، في لبنان وفلسطين، تشقّ طريقها وسط دمها وتعيش تجدّداً قاسياً لا ينتهي. ماذا تُسمَّى هذه الحركية القيادية والتجدّد الذي لا يتوقّف تحت ضغط التصفية البدنية والاغتيال الدائم؟ الواقع أنه ما من تسمية. وهذا أمرٌ لافت. مراكز بحث وتحليل وأكاديميات عربية على مدّ البصر، ولا تكاد تجد أحداً يلتفت إلى ظاهرة سياسية كبرى كهذه (هي الأهم على الإطلاق في سياقنا العربي). لا أحد يقف أمامها ليستلّ منها المفهوم الأصيل الذي يعتمل فيها ويمنحه ولو اسماً يُعرَف به. الكل مشغول بالترجمة عن الغربيين ومنحبسٌ في معجمهم ومأسورٌ بخيالهم. وحتى اليوم لا تجد مقاومتُنا -مِن خارجها- مَن يواكب ريادتها العسكرية بريادة لائقة في عالم الفكرة والمفهوم.
في قولته الشهيرة، يقول الإمام عليّ: «الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا». ومرة أخرى، فأيُّ معنى هاجعٍ تكتشفه في جملة كهذه بلحظة كهذه. أيُّ انتباهة فكرية كبرى أثارها رحيل ثلّة من خيرة ناسنا وأئمة مقاومتنا، وأي تحفّز وتوتّر جهادي قدحه هذا الموت الممتدّ. ليس من ضمانةٍ لنجاة فكرتنا. هذا صحيح. لكن هناك ما هو أسمى من الضمانات: الإيمان الآتي من قداسة الشهداء الذين بلغوا «تمامَ حدّ الإنسان، وبلغوا أفقه الأعلى». الإيمان بأن الفكرة، بقدسية الدم وسرّ الشهيد، باقيةٌ في قلوبنا لا تزول، وجاثمة على صدورهم حتى يزولوا.