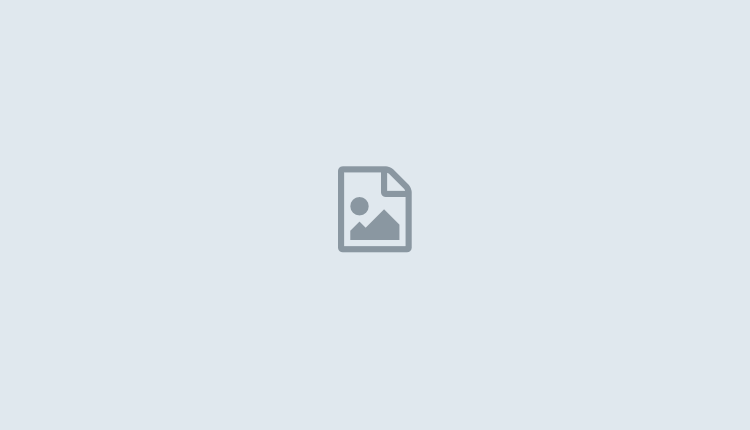حرب الإرادات: عن الإيمان الذي لا يملكه أحد
موسى السادة – وما يسطرون|
جلّ الوجود الاستعماري قائم على فكرة واحدة: أنه في إمكانه كسر إيمان وتمسّك أصحاب الأرض بأرضهم، ودفاعهم عنها، ومقاومة غزاتها. بل إن المستعمرين الصهاينة أسبغوا على هذه النظرية الاستعمارية مصطلحاً وهو «الجدار الحديدي». بعد السابع من أكتوبر المجيد، حاول العدو ممارسة هذه النظرية بأقصى درجاتها، إلا أنه وفي الأخير، لم ينجح في كسر إيمان الفلسطينيين لا في شمال غزة ولا جنوبها ولا المخيمات على امتداد فلسطين، ولا في كسر إرادة المقاومة العربية في إسنادها للمقاومة الفلسطينية. انعكست هذه الصدمة في تصريحات لهم وللأميركيين على وجه الخصوص، أنه وكيف لهذا الكم الهائل من العنف والإجرام أن يفشل في دفع هؤلاء الناس للاستسلام، لا بل لا زالوا يصيحون بالتكبير والوقوف خلف المقاومة.هذا الصمود الأسطوري، بذاته، له وقعه على المستشرقين الصهاينة والغربيين العارفين للثقافة العربية بنوع من الولع، وتراهم يردّدون ويحلّلون الكائن المستعمَر الغريب الذي يقول لهم أنتم تحبّون الحياة كما نحن نحبّ الموت.
ولأنّ وجود الاستعمار قائم بالضرورة على تصوّر وافتراض قابلية كسرنا وكسر روح المقاومة فينا، فإنّ كل سياسة وإستراتيجية صهيونية تقوم عبر التسليم بأنّ الكسر ممكن. وعليه، فإنّ المسألة بالنسبة إليهم هي عبر ماهية الوسيلة، وتاريخياً ابتدعت الأيديولوجيا الاستعمارية نظريات عدة ووسائل متنوعة لضبطنا وقمعنا، إلا أن المشترك التاريخي بين كل التجارب الاستعمارية أنها ومهما ظنّت أنها بلغت من التطوّر في علوم الأنثروبولوجيا الاستعمارية أو المعرفة التكنولوجية، فبمجرد مواجهة أزمة يكون جوابها حول سؤال الوسيلة هو العنف، وبالنسبة إليهم إن فشلوا فيه، فهو لأنهم لم يمارسوه كفاية.
تعددت القراءات التاريخية للمشروع الاستعماري الغربي منذ مئات السنين، سواء أبنظرته إلينا أم بنظرتنا إليه، من الصدام الثقافي والحضاري والديني إلى التحليل المادي ضمن البنية التاريخية لنمط الإنتاج الرأسمالي. ولكن، ولأننا نعايش حرباً مباشرة ضروساً مع درّة المشاريع الاستعمارية الغربية «إسرائيل»، فإنّ ما نعيشه ونمارسه مختلف عن التحليل النظري.
الأكيد هو أن الظرف المادي القاهر للمستعمِر (أي: الغرب)، في رجحان كفة القوة المالية والعسكرية والتكنولوجية، يؤسس إلى انتمائنا، نحن وهم، إلى نطاقين مختلفين، حيز مختلف لنمو الفكر والأيديولوجيا والإيمان. فقصورنا المادي اللازم ضد العدو يجعلنا ننشئ بنية ثقافية وأيديولوجية وروحية تعمل كوسيلة تعويض للهوة في فرق القوة العسكرية مع العدو. اختلاف هذين الحيّزين يلزمنا فهم أن مسألة انتصارنا على العدو لا تكون عبر منافسته في حيزه، أي أن نكون أكاديميين أكثر منه، أو نستخدم أدوات التحليل الحديثة أفضل منه، ونلعب في ميدان نظرية اللعبة والعقل السياسي للصراعات بين قوى دولية أقرب للمتناظرة. وذلك لأن نطاق ممارستنا منطلق من محصلة معرفية للتجارب التاريخية مختلفة عنه، وكأننا ننتمي إلى تاريخين مختلفين، فالممارسة السياسية المنبثقة للخط التاريخي التحرري لا تلتقي مع السياق التاريخي للاستعمار ولا في أي نقطة.
وعى العقلُ الاستعماري هذه المسألة، فأمسى استخدام القوة لديه يحاول بشكل ممنهج ضرب الوعي الإدراكي والمعنوي للمجتمع المقاوم، أي إنه يعلم أنه يقاتل الأضعف منه مادياً وعليه استهداف مركز قوتنا في قدرتنا الهائلة على الصمود، المبنية على إيمان ومحصلة تاريخية وحضارية وثقافية حول مفهوم الصمود هذا. أطلق العدو على هذه العملية الممنهجة عقيدة الصدمة، أي الممارسة العنيفة الهادفة إلى تكسير البنية الإيمانية للمجتمع المقاوم. ونحن اليوم وبعد الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشرس المركب على لبنان في أقصى مراحل هذا الصدمة، إلى درجة وصول العدو لسكرة بما يراه منجزاً يكاد يضعه في الحالة النفسية ذاتها بعد السابع من أكتوبر، وإن كانت تلك ذهاباً للعقل بجنون الانتقام، فهذه ذهاب له بجنون العظمة.
المسألة هنا أن الحرب كمفهوم تحوّل صراعنا المفاهيمي النظري مع الاستعمار إلى ممارسة تطبيقية، وهذه الممارسة قائمة على صادم بين إرادتين، بين حيزين مختلفين لكل منهما شكله، وإرادة في استنفار أدواته، الترسانة والقبة والذكاء الاصطناعي، والتضحية والإيمان والصمود والمقاومة. يخبرنا التاريخ هنا قاعدة، إن المنتصر ليس القادر على إيذاء الطرف الآخر أكثر، بل إن المنتصر من يطور آلية صموده وأدواته أكثر. من هنا نعلم أن استمرار إرادة صمودنا سبيلنا للنصر على هذا العدو.
ولكن، الأمر أكثر، ولعله البعد الذي يجعلنا نرتبط ارتباطاً يقينياً بالنصر، وهو أننا سوف نصمد أكثر ليس فقط لأننا نملك إيماناً أصلب أمام الصدمات، فللعدو إيمانه أيضاً ضمن سياقه الاستعماري، بل لأن منظومتنا قائمة على نطاق معرفي لم ولن تصله الأكاديميا الغربية. وهو نطاق علينا العمل على بناء منهجي له كعلم اجتماعي تحرري، وهو أننا نطلق مفاهيم، كالشهادة والفدائية والتضحية والثأر، هي بذاتها مفاهيم تعتاش على تكثيف العدو استخدامه لأدواته، أي إنه يصنع لنا الشهادة وهو الذي يحضّنا على التضحية والفداء والثأر، أي إنها حلقة مستمرة حتى انكسار أدواته هو. من هنا عندما نتكلّم ونقول إننا لا نُهزم، فهذا بالتأكيد يندرج بعدٌ منه في آلية شحذ هممنا، وهي مهمة، ولكنها أيضاً منطلقة من فهمنا الموضوعي أننا إن ما تمسّكنا بفكرة أننا لن نهزم، فإنّنا لن نهزم حقاً.
يحاول المرء البعد عن النرجسيات القومية والدينية، بأننا شعب ذو خصوصية مطلقة عن باقي شعوب الأرض، لكننا، ولأسباب موضوعية، نلعب اليوم ذلك الدور.
فنحن من دون شك نواجه أقوى قوى الأرض مجتمعة، بمعنى معاصر وأيضاً بمعناه التاريخي. ولأننا نحمل من دون شك أصل كل المفاهيم الروحية وشواهدها بحجم التضحية والفداء والصلابة، «إيماناً لا يملكه أحد على وجه الكرة الأرضية»، انتصرنا قبلاً وسننتصر اليوم، وسنكسر إرادة العدو الغربي من واشنطن إلى تل أبيب إلى عواصم ذيول الغزاة بترفهم وترفيههم ورقصاتهم، وسينكسر جبروت كل ذلك الحلف أمام صمودنا. ولكن، وفي المقام الأول، لأننا نمتلك (فعل مضارع) أبرز شخصية معاصرة علّمتنا كل ما تقدّم من سرد وكلام؛ كثيرة هي مميزات السيد الشهيد نصرالله، ولكن لو حاولنا عبثاً اختصارها، هو أنه الشخصية البشرية التي جسّدت لنا المحصلة التاريخية للتحرّر كما لم يقم به أي إنسان.
أوّل من قال للعرب وللفلسطينيين وللعالم «لا بأس ما بكم وهن»، في أوج العصر الأميركي. وإن كل ما كُتب أعلاه هو مجرّد محاولة قاصرة لتحليل وفهم ما علّمنا إياه وهو يقول: «إن أقصى ما يملكه عدونا أن يقتلنا، وإن أقصى ما نتطلع إليه أن نُقتل في سبيل الله. المعادلة الإيمانية تُحوّل نقطة قوة العدو القصوى إلى نقطة قوتنا القصوى؛ وبالتالي نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نُستشـهد ننتصر».