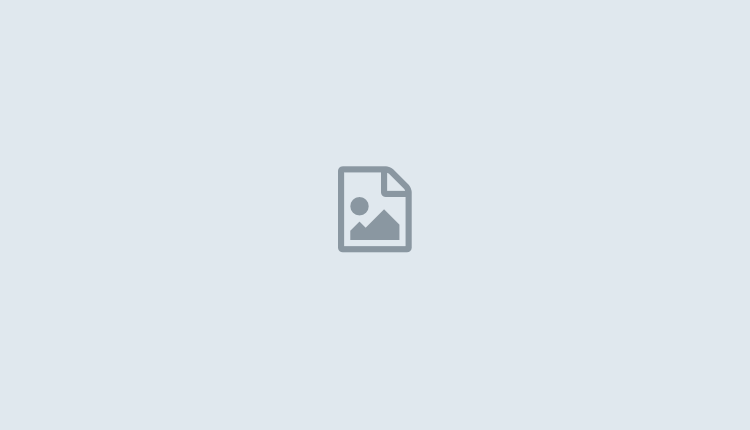الحرب من منظور نسبي: محدودية القدرة الصهيونية على الاستفراد بالجبهات
ورد كاسوحة – وما يسطرون|
المنحى الذي اتخذته الحرب، مع لجوء إسرائيل إلى «الخيار الصفري» على الجبهة الشمالية، لن يقود بالضرورة إلى جبايتها ثمناً مرتفعاً من خصومها في المقاومات المختلفة. فهذه السردية التي يجري تقديمها، في معرض توصيف الانتقال الحاصل للثقل العسكري، من الجنوب إلى الشمال، تتجاهل، ليس فقط التسلسل القتالي المنهجي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بل أيضاً البنية المعقّدة للجبهات، والتي تجعل أيَّ تراجُعٍ ظاهري في أحدها لمصلحة إسرائيل، مدخلاً لتخفيف الضغط عن نظيراتها. وهو ما يُترجَم عسكرياً بإعادة تنظيم الصفوف لجهة الفاعلية القتالية تمهيداً لجولة جديدة من الردع. وهذا على أيّ حال، هو جوهر فلسفة الإسناد التي يقوم عليها هذا النوع من القتال، في مواجهة قوّة عسكرية مدجّجة بالتكنولوجيا القتالية العالية والدعم الغربي غير المحدود، مضافاً إليهما القدرة المستجدّة على مصادرة سلاسل التوريد والعبث بها، حتى تصبح في مواجهة خصومها، وليس العكس.
أفضلية عدم التناظُر وتوسيع هامش المناورة
في مواجهة كهذه، تبدأ الفاعلية العسكرية من إدراك، ليس فقط الطابَع غير المتناظِر للحرب، بل كذلك آليات قتال كلّ جبهة على حدة. ففي غزّة، حيث المواجهة المركزية، تكون المناورات بغرض الحفاظ على البنية العسكرية التي تسمح باستمرار المواجهة هي الأكبر، قياساً بنظيراتها في جنوب لبنان واليمن. لا يعود ذلك فقط لمجابَهتها الثقل المركزي لآلة الحرب الصهيونية، بل أيضاً لأنّ نمط القتال في المواجهة المباشرة هناك يتطلّب، بحكم الافتقاد إلى عامل الجغرافيا الأفقية البعيدة، أن تكون وسائل الحماية والتحوُّط عمودية. أي اتخاذ الأنفاق درعاً للمقاتلين، وحتى للآليات الخفيفة، حتى يحصل قدْرٌ من التناظر مع الجندي الصهيوني المحتمي داخل دروع مدجّجة بالتكنولوجيا الفائقة، سواء في البر أو في الجوّ.
هذا لا يجعل القدرة على الوصول إلى المقاتلين من «كتائب القسّام» وسواها أقلَّ فقط، بل يوسِّع الهامش القتالي أمامهم، بحيث يصبح ممكناً بعد حصول التناظُر الجزئي مع القوّات الصهيونية المهاجمة، تركيز القوّة النارية في مواجهتها أكثر، حتى مع انعدام التناسب أيضاً بين القوّتين الناريتين المتجابهتين.
هذه الاستراتيجية لا تغيِّر المنظور القتالي للمواجهة في غزّة فقط، بل تضع كذلك أيّ تراجع تكتيكي أو حتى خسارة، في الأرض أو في القدرات البشرية للمقاومة، مع زيادة وتيرة التصعيد الإسرائيلية في إطار تعزيز القدرة على المناورة. خسارة الأرض أو الكوادر القتاليّة، بهذا المعنى، تصبح مؤقّتة، لأنّ القدرة على التحرّك، من الأنفاق وإليها، تضمَن للكوادر التي لم تتعرّض للنيران الإسرائيلية، بالمقدار نفسه، العودة لاحقاً حين يغيّر الصهاينة إستراتيجيتهم، تحت وطأة المراوحة المستمرّة في المكان، وانعدام القدرة على «جباية ثمن» الحرب، بعد أحَدَ عشَرَ شهراً على اندلاعها.
في مواجهة كهذه، تبدأ الفاعلية العسكرية من إدراك، ليس فقط الطابَع غير المتناظِر للحرب، بل كذلك آليات قتال كلّ جبهة على حدة
النسبية في احتساب الإنجازات والخسائر
هذا يغيّر، بدوره، وبوصفه قياساً نسبياً للخسائر، منظورَنا إلى مجمل عمليات القتال على الجبهات. فالاختلاف بين الجبهة المركزية في قطاع غزّة ونظيراتها في جنوب لبنان واليمن، وحتى العراق، لا ينفي التقاطعات بينها، وصولاً حتى إلى تكوين نَسَق للقتال، يمكن اعتباره ناظماً لهذا الترابُط، بحسب أولويّات كلّ جبهة على حدة. أهمّ أشكال هذا النسق، أو لِنقُل النمط في القتال، هو اعتماد استراتيجية للأهداف، مفارِقة من حيث البنية لشكل الحرب بين الجيوش النظامية. بمعنى أن يُصار إلى «تصغير حجم الهدف» حتى لو كان كبيراً، وعدم اعتباره حين يَسقط إنجازاً كاملاً، إلا حين تكتمل صيغة الترابط مع ما يعادِله من أهداف مُنجَزة على الجبهات الأخرى.
حين يحدث ذلك على نطاقٍ واسع، يصبح الترابط في قياس الإنجازات هو المحدِّد لكلّ ما يحصل في المعركة المتعدّدة الجبهات مع إسرائيل، بما في ذلك «الانتكاسات» والتراجعات الجزئية، على ضوء تغيير الصهاينة إستراتيجيتهم، أو انتقالهم من مرحلة إلى أخرى في الحرب.
هذا مهمّ، ليس فقط لتفادي انعدام التناسب الظاهري، مع الآلة العسكرية الصهيونية المدجّجة بالتكنولوجيا العالية والدعم الغربي، بل أيضاً لأنّ قدرة الصهاينة على الوصول بسهولة إلى سلاسل التوريد العالمية، كما أظهرتها تفاصيل مجزرة البيجر، تهدّد بتعطيل كثير من الآليات اللوجستية المرتبطة بالقتال التقليدي، لجهة العلاقة مع الدول والشركات، وصولاً إلى القدرة على تأمين انتقال آمن وسلس للشحنات المرتبطة بالعمل القتالي.
المنظور النسبي هنا يجعل حتى العمل اللوجستي مرتبطاً بهذا التسلسل العامّ لأشكال القتال، على اعتبار أنّ النجاح في جبهة، حتى لوجستياً، ليس بالضرورة أن يعادِله نجاحٌ مماثل على الجبهة النظيرة، بل يمكن لتراجُعٍ هنا أن يكون سبباً لإسناد متقدّم من الجبهة الأخرى التي تقدّمت لوجستياً مقارنةً بنظيراتها. فالخلل الذي قاد إلى حدوث مجزرة البيجر أتى مسبوقاً بقدرة الجبهة اليمنية التي تقودها «أنصار الله» على معاودة استهداف العمق الصهيوني بالصواريخ الباليستية، بعدما اعتُقد على نطاقٍ واسع أنّ الهجمات الجويّة الإسرائيلية على ميناء الحديدة، في تموز الفائت، قد حيّدت هذه القدرة تماماً، وأخرجتها من سياق الصراع.
الربط بين الأمرين، حتى من دون وجود مسبّب فعلي، يجعل من الخلل الخاصّ بانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكيّة أمراً يحدُث ببساطة في هذا النوع من الحروب مع الجيوش النظاميّة على النَسَق الغربي، نظراً إلى الأسبقية المعقودة للصهاينة على الوصول إلى سلاسل التوريد واختراقِها. وهذا نقاش آخر له صلة بالاقتصاد السياسي أكثر منه بالحرب نفسها.
على أنّ ما يسبِق حدثاً كهذا أو يعقبه أهمّ، لأنّ الضرر أصاب جبهةً واحدة، لا كلّ الجبهات. وحتى هذه الإصابة، مع كلّ ما يستتبعها من لجوء الصهاينة إلى الحرب الجوية الشاملة، ستتحوّل لاحقاً إلى أثَر جزئي، أو عارض من أعراض هذا النمط في القتال. يحصل ذلك بشكل أساسي حين يعود الترابُط البنيوي بين الجبهات لقيادة الصراع، باعتباره المحدّد الرئيسي للفاعلية والقدرة على المجابَهة، أكثَرَ منه قدرة جبهة لوحدها، مهما كانت فاعلة ومركزيّة، على تثبيت توازن الردع مع الصهاينة، إسناداً لغزّة ولفصائلها المقاتلة.