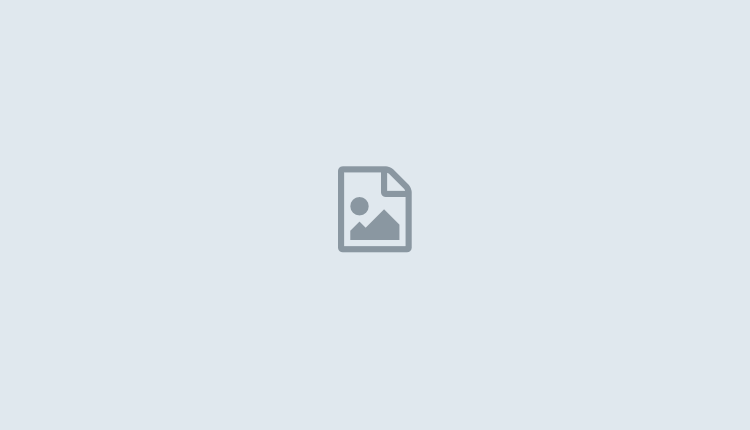طاعون الليثيوم: عن التسميم التقني لإسرائيل
عوني بلال – وما يسطرون|
عام 1999، اجتاحت الساحة الإلكترونية العالمية حالة من الفوضى دُعيت حينها «طاعون المكثفات». شركات كبرى بوزن «أبل» و«آي بي إم» وقَعت فريسة الطاعون ودفعت أثماناً فادحة. يكفي أن يعرف المرء أن شركة الحاسبات الشهيرة «ديل»، أنفقت قرابة نصف مليار دولار لاستدعاء منتجاتها التي ضربتها الجائحة التقنية. وخلاصة الواقعة أن شركات تايوانية (نعم، تايوانية مرة أخرى) أنتجت ملايين المكثفات بعيب كيميائي قاتل يحوّلها بعد فترة من الاستخدام إلى مفرقعات صغيرة. لم يكن الانفجار مسألة حتمية.
بعض المكثفات تضخّمت وبدت وكأنّ ورماً أصابها، وبعضها تشقّق، وبعضها الآخر انبجس أعلاه ورمى بحشوته السائلة وكأنه بركان مقزّم. وفي جميع هذه الأحوال، كان المكثف يَخرج عن الخدمة معطّلاً ما اتصل به أو اعتمد عليه. حاسبات، شاشات، كاميرات، خوادم رقمية وجمهرة هائلة من الآلات نالها الأذى. لم يكن الأمر مقصوداً. ما حصل وقتها أن الشركات الصانعة سرقت الوصفة الكيميائية للسائل الكهرَليّ اللازم لهذه المكثفات من شركة يابانية منافسة. لكنَّ خطأً حصل خلال السطو ولم يستكمل السارقون نقل كامل المكوّنات اللازمة.
وبهذا المعنى فمنشأ الخلل كان إهمالاً لصوصياً عابراً، لكن ثمنه دوّى بأركان العالم وكلّف كثيراً.عندما انطلقت حملة إسرائيل على أجهزة الاتصالات في لبنان وحصلت المجزرة تذكّرت هذه الواقعة القديمة، ليس بسبب التشابهات وحسب، وإنما بسبب التباينات أيضاً. عملياً، طوّعت إسرائيل فكرة طاعون المكثفات وأعادت إنتاجها على نحوٍ مؤتمت ومضبوط. هذه الأتمتة الدقيقة هي ما سمح بتحويل النتيجة من فوضىً عارمة إلى مجزرة دموية. ومن أوجهٍ عديدة جداً، يحق لنا أن ندعو ما جرى تسميماً تقنياً (لعلها من ترميزات التاريخ أن ينتسب مجرمو اليوم إلى سُلالة ترتبط في وعينا بأول محاولة للتسميم في الإسلام، وضد نبي الدعوة نفسه).
بالتوازي مع ما جرى، تستحق فوضى الإعلام التي واكبت الحدث قدراً من الانتباه، فمشاهدة أكبر الفضائيات العربية منخرطة في الحبك الفوري لأساطير فيزيائية وخرافات سيبرانية تعجز عنها العفاريت كانت أمراً مشيناً. هذه القنوات ذاتها التي تثقب آذاننا كل يوم تحذيراً من «الأخبار الزائفة» وتترزّق بعقد الدورات والمؤتمرات المخصصة للموضوع. أحدهم خرج على واحدة من هذه الشاشات ليحدّثنا عن بثٍّ رهيب لموجة راديوية عملاقة حملت من الطاقة ما كفى لتفجير الأجهزة. وأزعم أن أغلب العارفين بأسس الاتصالات وفيزياء البث الراديوي رجّحوا باكراً أن الأمر تفخيخ مسبق وأن أفلام الخيال العلمي الذي انخرط إعلامنا الرديء في سبك فصوله كان كلاماً فارغاً (ومؤذياً إلى حد كبير).
أترقّب، كغيري، ما سيكشفه قابل الأيام عن تقنيات التفخيخ المستخدمة؛ إلى أي حدّ اعتمد الأمر على متفجّر مستقل، أو على الليثيوم الذي في البطارية، أو على تضافرٍ موزون بينهما. كلامٌ كثير طُرح في هذا المضمار، ومن المعيب أن يرمي المرء تكهنات جديدة وسط كل هذا الزحام لكنّي أجد شيئاً واحداً جديراً بالإضافة هنا: أن غياب انفجارات عَرَضية منذ استيراد هذه الأجهزة يستحق انتباهاً خاصاً. غياب كهذا أمر لافت بالنظر إلى كثرة الأجهزة المعنية (نتحدث عن آلاف). هذه الآلاف تعرّض بعضها -حتماً- لحرارات مرتفعة أو ارتجاجات أو حتى حوادث سحق وحرق أو سوء استخدام عام خلال أشهر من التشغيل. وإذا كان من شيء يمكن قراءته هنا فهو أن عملية كهذه قامت على إعداد هندسي طويل، ليس بالنظر إلى نجاح التفجير، وإنما بالنظر إلى العكس تماماً: لعدم حصول انفجار واحد غير مقصود قبل ساعة الصفر. أن تُنتج مفخّخة كهذه، موزّعة على آلاف الأجهزة، كل منها يعيش ظرفاً مختلفاً، وتكون مطمئناً أن أياً منها لن ينفجر عَرَضاً ويفضحَ المؤامرة هو الشاهد الأكبر لحجم ما استُثمر في عملية كهذه، تصميماً وتطويراً.
ما جرى ليس قفزةً كمية في وتيرة معركة؛ هذه قد تكون انعطافة بفكرة الحروب وفلسفة الجريمة. وينبغي أن يتجاوز المرء توصيف «الإرهاب» حتى يدرك بحق معنى الحدث
ورغم كل ذلك، فالمبالغات التي واكبت هذه العملية تبقى مزعجة لأنها تزيح قوة إسرائيل من جوانبها التنظيمية واللوجستية إلى جانب علمي وهندسي. يحتاج المرء إلى الحذر قبل أن تنجلي حقيقة ما جرى، لكن -وقياساً على شواهد سابقة كثيرة- فالنجاح اللوجستي هو العنصر الأهم. هذه سمة حاضرة في إسرائيل منذ زمن طويل جداً. عام 1968، تمكّن الإسرائيليون من وضع أيديهم على 200 طن من الكعكة الصفراء لتسريع مشروعهم النووي في ديمونا. العملية -التي عُرفت لاحقاً بعملية الرصاص- اعتمدت على تأسيس شركة وهمية في ليبيريا اقتنى «الموساد» من خلالها ناقلة بحرية (سُمّيت شيرزبرغ-أ).
ثم استُخدِمت شركة ألمانية «صديقة» متخصصة في البتروكيماويات كي تشتري الأطنان المئتين بحوالي 4 ملايين دولار من شركة بلجيكية. بعد ذلك، تمّ الاحتيال لتوقيع عقد مع شركة إيطالية ثالثة متخصصة في الطلاء بهدف معلن هو «معالجة المواد المشعّة». ورَكّب الموساد طاقماً جديداً للناقلة البحرية بجوازات سفر مزوّرة. ثم مضى بالعملية لحين إتمام شراء المواد المطلوبة من المزوّد البلجيكي وتعبئتها في براميل كُتب عليه تمويهاً: «رصاص». حُمّلت الشحنة بعد ذلك على الناقلة وبدأ نقلها -ظاهرياً- صوب الشواطئ الإيطالية، قبل أن تنتهي البراميل جميعاً في إسرائيل وتختفي الشحنة من السجلّات الرسمية.
نتحدّث دوماً عن الصفة العنكبوتية لإسرائيل في إشارة إلى الهشاشة الكامنة فيها. لكن من الواجب الإقرار أن هناك أخطبوطاً خلف العنكبوت، وأن أذرعه ممتدّة حول العالم، ونافذة في أبعد أركانه. وربما أن ما ردّده علينا خطيب الجمعة في صبانا عن سيطرة «هؤلاء» على العالم لم يكن مبالغة بالكامل. هذا التنبه للجانب اللوجستي ضروري حتى لا يأخذ الافتتان التقني حجماً مفرطاً ويتحول إلى شلل في المواجهة. المُركبة الكبرى فيما جرى هي للنصّاب الخبير وليس للعالِم الفذّ.
مهما يكن فأهمية التفكير في ما جرى لا تحتاج إلى تأكيد. ما جرى ليس قفزةً كمية في وتيرة معركة؛ هذه قد تكون انعطافة بفكرة الحروب وفلسفة الجريمة. وينبغي أن يتجاوز المرء توصيف «الإرهاب» حتى يدرك بحق معنى الحدث. لعلها من مفارقات التاريخ أن من يقدّمون أنفسهم ضحايا أفران الغاز يجترحون اليوم أهم بدعة أداتية في مضمار الإبادة. وكل ما في الأداة الجديدة «يليق» بالمرحلة: أشباه موصلات، أدوات اتصال، إلكترونيات، تفعيل لاسلكي، وتلاعب بسلاسل إنتاج. إذا كان النازيون أنتجوا أداة إبادة غازية، فالصهاينة قدّموا اليوم نموذجاً راديوياً معاصراً.
على كلٍّ، ومما صار معلوماً، فأجهزة الاتصال الأقدم لم يبلغها هذا التسميم، فيما كانت الأجهزة الأحدث جسرَ العملية وبوابتها الأساسية. جزئية كهذه تؤكد شيئاً طالما قيل في صِلَتنا بالتقنية: عن وجوب اختلاف علاقتنا بها قياساً على علاقة سوانا بها. «التخلّف التقني» ليس سيئاً بالضرورة. بل أكثر من ذلك: التخلّف التقني بذاته -وأحياناً- هو الضرورة. هناك معركة مفتوحة بين الإنسان والآلة تتعلّق بمن يملك الآخر حقاً، ومَن يسيطر على من. هذا ليس تفلسفاً في الموضوع ولا محاولة لتعميقه ولا تعقيده. هذا واقع رأينا ثمنه الدموي على الأرض وبين الأشلاء.
الأشياء الأبسط والأعتق والأقل تركيباً تسمح لك بامتلاكها أكثر من سواها؛ أن تمتلكها معرفياً وأداتياً وأن تحيط بها أنت لا أن تحيط هي بك. وكما يتحدّثون عن ضرورة التأنّي في مسار التطوير السياسي والاقتصادي وتجنّب القفزات العنيفة التي تهدّد المجتمع، يحتاج الأمر إلى تأنٍّ مضاعف في الجانب التقني. ربما يبدو الكلام مزعجاً بالنظر إلى سياق الموضوع: نحن نتحدّث عن أجهزة إخطار نصّية بسيطة، بل عن الأجهزة الأبسط إطلاقاً في ميدان الاتصال اللاسلكي. لكن هذا تحديداً ما يؤكد الأمر. تطويرات بسيطة في نسخة أحدث فتحت الشقّ التقني اللازم لإسرائيل حتى تنفذ منه دون انتباهٍ من أحد. أعلم أن رائحة التعالم والتنظير والحكمة الاسترجاعية تفوح دوماً من أحاديث كهذه، لكنَّ أفكاراً من هذا النوع مطروحة منذ زمن، وما جرى يزيد وجاهتها.
بقي سؤال أخير حول الأثر الذي ستُحدثه عملية كهذه في الوعي الأمني للمقاومة. أغلب الناس يتأهبون بعد أحداث كهذه لتفكر في الجهاز المسموم التالي وكيف يمكن استباق الأمر ومنع وقوعه. أجهزة تلفاز مفخّخة؟ ساعات رقمية؟ كاميرات مراقبة؟ أجهزة طبية؟ هذا هو الامتداد الخطي لمن يفكر في عملية إسرائيل. لكن الأهم في ما جرى هو الانعطافة التقنية بذاتها، وليس وِجهة الانعطاف. إن التيقظ الدائم للانعطافات هو تحدٍّ علمي وهندسي قبل أن يكون تحدياً أمنياً؛ أن تملك في كوادرك من يجلس طيلة الليل والنهار، مستحضراً شخصية العدو في نفسه، مهووساً ومهجوساً بالأمر، وباحثاً عن حيلة مدهشة لضرب المقاومة. حيلة من خارج كل خط سابق، وبانعطافة لا تخطر في بال أحد كي يستبق حصولها ويمنعها. ولا شك عندي أن ما جرى سيدفع المقاومة في هذا السبيل بأكثر مما دفعها كل تاريخ الصراع من قبل. رحم الله الشهداء.