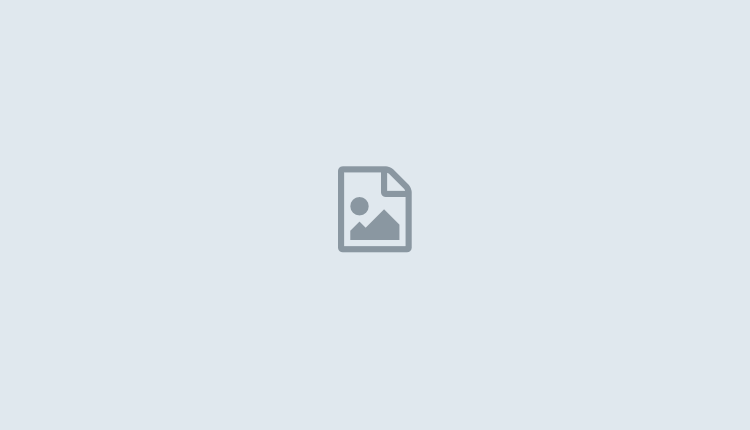عاطفتنا السياسية ضد «إسرائيل»
موسى السادة – وما يسطرون|
إن ما نخوضه منذ بدء «الطوفان» هو حرب دائمة ومستمرة، ولعله من الخطأ الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب. صحيح أنه إن طالت أم قصرت فإن مآل الجبهة العسكرية والقتالية أن تقف، لكن ليس للجبهات الأخرى السياسية والإعلامية والثقافية التوقف. وكل ذلك ليس فقط لأن «الطوفان» يؤسس لنقلة نوعية للصراع إلى مستوى آخر، أو أن جبهة العدو الغربي والطغم الحاكمة العربية هي بدورها لن تتوقف، بل ستضاعف الجهد والمال لتعيد مشروعها الذي باغته «الطوفان» في إعادة رسم «الشرق الأوسط»، وبحس انتقامي وتوحش أكبر، بل إن من عليه الحرص على استمرارية هذا الحرب هو نحن، وليس لحسابات العقلانية والربح والخسارة، بل لأنه يتملّكنا شعور بالغضب والرغبة في الثأر والانتقام من العدو أولاً ومن طغم الحكم العربية ثانياً.فكما تنبّهنا صديقة أن غياب المشاعر وتبلّدها والتعامل مع الصراع بنوع من الميكانيكية والحسابات، والنفور من إحساس الرغبة بالثأر والانتقام، من منطلق أنها مشاعر لاعقلانية وفيها نوع الهمجية والقبلية النقيضة للتحضر والحداثة، كل ذلك هو أمر لا يعكس تطوراً صحيحاً في طبيعة صراعنا ضد العدو، بل على العكس إنما يدل على أن المستعمر قد اخترق لاوعيك وفرض عليك التخلي عن إنسانيتك وتلبّس ذهنية المستعمِر.
ففي إحدى أهم زواياه، قتالنا ضد الاستعمار هو قتال للحفاظ على هذه المشاعر الإنسانية، أي الحفاظ على كوننا بشراً. بل لعل الأهم أن مشاعر العربي والجنوبي الغاضب هذه، يدأب الاستشراق على تصويرها على أنها انعكاس للهمجية المنبوذة، وهو لم يقم بذلك إلا لعلمه أن تمسكنا بهذه الأحاسيس هو وسيلة وشرط وأصل في قتاله.
وهذا ما تخبرنا به أكثر بيئاتنا ثوريةً وتضحية في غزة وفلسطين، حيث، وبشكل لا مثيل له، الهجوم على الموت لأجل إيمان بقضية وحق، بالجملة، العوائل بأكملها زرافات ووحداناً، في نموذج من الإقبال على التضحية من المباح الحسم أنه لم يحدث في التاريخ بهذا الشكل قط. وفي هذا النموذج ومن باكورته، وأقلّ من بعد حرب «العصف المأكول»، خبرت المقاومة فعالية حس الانتقام، وبأن فتك العدو بالناس لم ينتج الصدمة الردعية التي أرادتها «إسرائيل» بل فتحت الباب لإقبال المنتسبين إلى المقاومة والتجنيد، وهذا ما أشار إليه أبو عبيدة بشكل مباشر في تموز الماضي: «نار الانتقام التي أشعلها الاحتلال بجرائمه وساديته كافية لحرقه وتدمير كل مخططاته، وستنشئ جيلاً فولاذياً معبّأ بإرادة المقاومة والقتال والتصدي للاحتلال».
إن هذا الحس الثأري الانتقامي الغاضب كان ولا يزال العمود الفقري لكل أدبياتنا الجهادية من آيات القتال والحرب في القرآن الحكيم إلى أناشيد المقاومة، لأنها أدبيات الثورة، تشحذ الهمم وتشد العصب، وأحد مصاديق أننا حركة تحرر تعمل على تغيير الواقع التاريخي.
المسألة هنا في التأكيد والعودة على أهمية العاطفة على ذاتنا الثورية، وأن لا نقع في فخ أسطورة الحداثة الغربية الاستعمارية بأنهم هم الطرف ذو الحسابات العقلانية والتي لا تشوبها عاطفة، وأن ذهنية الدولة والمؤسسات الديمقراطية تعمل على غربلة خطيئة تملّك الإنسان للعاطفة، عبر الأكاديميا والمؤسسات البحثية. بل بالعكس، فالإنسان المستعمِر، والصهيوني تحديداً، هو أكثر المسعورين عاطفياً وأضعفهم في مساوئ سيطرتهم على القرار وتغييب الحكمة، بل إننا شهدنا نقاش ذهنية المستعمِر الغربي مع بعضه أمامنا على الشاشات، في تحذير الأميركيين للصهاينة من مغبة تكرار خطأ الحس الانتقامي بعد غزوة منهاتن في 11 أيلول، وهو تحذير لم ولن يكون له مستجيب لدى العدو الصهيوني بعد السابع من أكتوبر المجيد. وإن من المهم التذكير هنا، أن كل التجارب الناجحة ضد الاستعمار الاستيطاني كانت عبر شن المقاومات لعمليات تفقأ فقاعة عقلانية وتحضّر المستعمر وتؤدي به إلى الجنون ومنها إلى التهلكة. أي إن إحدى ركائز هزيمة الاستعمار هي استنفاره عاطفياً عبر كسر غروره وجبروته بالعمل العسكري المقاوم.
الأخطر، أن نسمح لهذا الاستفزاز أن يدفعنا للتخبط والرعونة المؤسفة في تصويب الاتهامات بشكل عشوائي بين بعضنا، ونتخلى عن نظريتنا الثورية في وحدة الأمة
وهنا يأتي الأهم في جبهتنا، وهو في فهم إدارة هذه المشاعر والعواطف، وفي المبدأ إن معركة لا تكره فيها عدوك بما فيه الكفاية هي معركة لن تنتصر فيها، وإن وجدت نفسك تستفز وتكره نظيرك العربي الخصم والمتواطئ أكثر من أن يثار دمك بمجرد أن ترى ذلك المستوطن تطأ قدمه أرض فلسطين، فأنت تخوض، ولو عاطفياً، صراعاً آخر ليس ضد الصهاينة. فكراهية الصهاينة فوق كل كره هي أصل في الصراع. وإن ما يجب علينا الوصول إليه من ناحية المقاربة العاطفية لصراعنا ضد الصهيونية هو أن يحتار كل فرد منا في الإجابة على السؤال التالي: هل يا ترى أنا أحب فلسطين أكثر من كرهي للصهاينة، أم أن كرهي للصهاينة أكثر من حبي لفلسطين؟ وليس غير الحيرة في الإجابة على هذه المعضلة هو الصواب، وهو التموضع العاطفي السليم.
اليوم ووسط حرب إبادة، واستنفار عواطفنا وتقلبها، فمن السهل تدهورها لتكون رهينة الاستفزاز من شبكة واسعة ومتنوعة من ذيول الأميركيين، الذين أدخلتهم فلسطين وعودة الصراع في الوطن العربي إلى أصله ضد كيان العدو الإسرائيلي في أزمة وجودية، هم فيها من الإفلاس إلى حدّ أن الاستفزاز هو سلاحهم الوحيد، من المنتسبين إلى شبكات ريع الدولة الوطنية العربية وهويتها المأزومة في الخليج والأردن ومصر مع تعملق مقاتلي أمّتنا على امتداد الجغرافيا، إلى عصابات التمويل للمنظمات غير الحكومية، وصولاً إلى رواسب مشاريع الانقسام الأهلي والطائفي للأمة.
الخطير أن نسمح بأن يكون لسلاح الاستفزاز هذا فاعلية، خاصة مباشرة عبر ردة الفعل على أكبر جبهة تتخذ من أساليب المراهقين كسلاح سياسي، ونستدرج إلى ملعبهم وأدواتهم وخطابهم، ونحن الجبهة ذات المشروع السياسي الحقيقي والأسلحة الثقافية والأخلاقية والعسكرية والتي تعرف عدوها الصهيوني والاستعماري وتقدّم الشهداء والتضحيات الكبرى.
والأخطر، أن نسمح لهذا الاستفزاز أن يدفعنا للتخبط والرعونة المؤسفة في تصويب الاتهامات بشكل عشوائي بين بعضنا، ونتخلى عن نظريتنا الثورية في وحدة الأمة، ونبذ الحدود، وسبيل الكفاح المسلح، ومعرفة العدو والصديق والحليف، ومصداقيتنا الإعلامية. لنقع ضحية تشكيل منظورنا السياسي بشكل مائع وبما يتطلبه الاستفزاز والاستفزاز المقابل، ونحوّل منهجيتنا وتحليلها السياسي إلى خطاب خاوٍ بلا معنى، ومجرّد تهم عشوائية، وهنا تحديداً نساهم في جبهة الإمبراطورية الأميركية في دفع أنفسنا لإفلاس ذاتي في المنطق والخطاب والفكرة.
ولذلك، علّ أهم ما يجب أن نتمسك فيه اليوم، هو عاطفتنا السياسية ضد الصهاينة والأميركيين، خصوصاً ونحن اليوم في حرب مباشرة معهم كنا ننتظرها ونعدّ لها لعقود، وأن نحوّل كل الغضب والثأر والانتقام نحوهم، نحو ذلك الرجل الأبيض المترف الجبان الذي غزا ويغزو بلداننا منذ أكثر من مئة عام، واستباح أرضها وسماءها وفتك فينا بكل أنواع القتل، كلها وجميعها، حتى صارت مسألة القصاص العادل منه استحالة فيزيائية، فلن تكون كل الرؤوس سواء ولا الزمان سيكفي ولا المكان سيعود، ولا غليل سيشفى. ولكن، ولأننا نكرهه بما فيه الكفاية، لن ينجح في تشتيتنا عن قتله هو، فالزمن الذي ينجح فيه الاستعمار في إرسال ذيوله من بني جنسنا ويرانا في أمنه وأمانه ونحن نأكل لحم بعضنا قد ولّى، وأن التخلي عن مبادئنا الثورية وركائز نظريتنا التحررية هو مستحيل، بل إن الزمان زمان التمسك بها أكثر من أي وقت مضى، وأن لا هدف أو غاية اليوم سوى سفك دم المستعمرين وطردهم عن أرضنا.