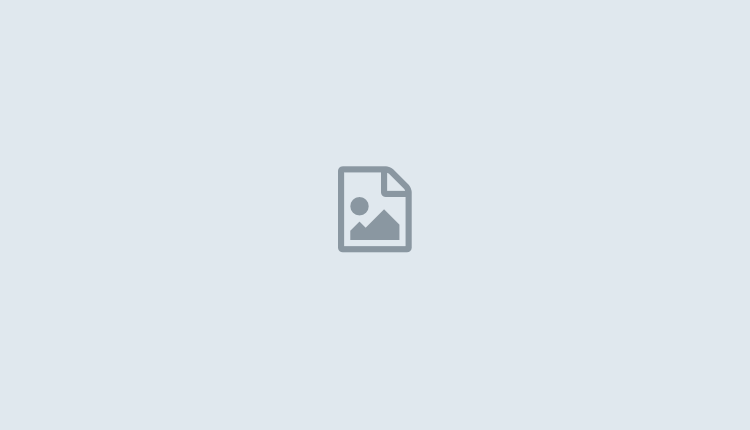المسألة اليهودية والمشروع الإمبريالي الغربي
مازن النجار – وما يسطرون|
من قضايا الشأن الصهيوني الملتبسة التي نالت قسطاً من النقاش في فضاء الفكر العربي المعاصر هي طبيعة العلاقة بين الغرب -وخاصة الولايات المتحدة- وبين الكيان الصهيوني ومشروعه الاستيطاني: هل هي علاقة عضوية أم علاقة وظيفية غير عضوية؟ ورأى المفكر العربي الراحل، عبد الوهاب المسيري، أنها علاقة وظيفية، وأن الكيان الصهيوني ليس إلا «دولة وظيفية»: قاعدة عسكرية وحاملة طائرات غربية. ويترتب على ذلك إمكانية تفكيك الكيان الصهيوني وتصفية مشروعه الاستيطاني وترسانته النووية وإزالة الأوضاع الجيوسياسية المرافقة لقيامه. ولا زال الناشطون ينشرون عبر «يوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي أفكاره ومقولاته حول الصهيونية ومآلات مشروعها الاستيطاني وضرورة رفع كلفة استمرار الكيان على حلفائه لإرغامهم على التخلي عنه.
الجماعات الوظيفية
ويؤكد هذا تاريخياً أن دور الجماعات اليهودية في الغرب دور وظيفي: بقّال في بولندا، مُرابٍ في هولندا وإنكلترا، صراف وسمسار في بلاد أخرى، مرتزقة في جيوش إمبراطوريات المشرق القديم كما تظهر نصوص صلوات دينية يهودية بالآرامية تعود إلى مرتزقة يهود بجزيرة فِيَلة المصرية. ويعزز ذلك نموذج «الجماعات الوظيفية» في علم الاجتماع الذي يفسر سلوك جماعات بشرية تنحصر قيمتها في «وظائف» أو مهن، مثل الغجر وفِرق «الترفيه» و«البغاء» («الحبشيات» منذ عصر الرومان بحسب ويل ديورانت في «قصة الحضارة»).
وتختلف الجماعات الوظيفية باختلاف قيم المجتمع وتقاليده ومرجعيته. وكان المسيري يرفض تفسير الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل بالسيطرة اليهودية على سياسة أميركا واقتصادها. ويعدّد قطاعات مهمّة في الاقتصاد الأميركي، لا ثِقل لليهود فيها، كصناعة الحديد والصلب والنفط والكيماويات والهندسة والمصارف الكبرى والزراعة، ويُبرز اقتصار نفوذهم تقليدياً على تجارة التجزئة والصرافة والسمسرة والبورصة والترفيه والخدمات. تلك كانت مهن مخصّصة ليهود أوروبا منذ القرون الوسطى.
لكن الجيل الأوّل من المهاجرين اليهود لأميركا مثلاً كانوا عمّال مناجم، وغدا أبناؤهم محامين وأكاديميين، وأحفادهم مُديري أعمال ورؤساء شركات وسماسرة بورصة وإنتاج سينمائي، وهكذا.
علاقة اليهود بالغرب محكومة بمثلّث محدّدات دينية وحضارية وتاريخية وجيوسياسية: المسألة اليهودية؛ المشروع الإمبريالي الغربي؛ تنظيم الاجتماع الغربي. فعلى مدى قرون عدة، لم تستوعب أو تتقبّل الحضارة الغربية الوجود اليهودي بمجتمعاتها، وشهدت أوروبا موجات شيطنة واضطهاد وترحيل جماعي وتمييز ديني وإثني، حتى بعد ظهور الليبرالية وتجلياتها ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، وتم اختصار كل ذلك في «المسألة اليهودية». وجاء الإصلاح الديموقراطي وتشريع الحقوق المدنية والمواطنة في الغرب كضرورة لتنظيم المجتمعات الأوروبية وتجنيدها في خدمة وتمدّد المشروع الإمبريالي وزيادة موارده البشرية، فكان لا مناص من تفكيك نظام الإقطاع لعقمه وعدم جدواه إمبريالياً. وهذا بدوره فاقم المسألة اليهودية!
أبرز «طوفان الأقصى» مركزية الكيان الصهيوني في منظومة الاستيطاني الدولي
الإمبريالية والترانسفير
فمن ناحية، لم يعد مُبرَراً استمرار نبذ اليهود والتمييز ضدهم مع تمتعهم بالمواطنة الكاملة؛ ومن ناحية أخرى، وباستثناء الإقراض بالفائدة، لا نفع لهم في المشروع الإمبريالي كباقي شرائح المجتمع التي مرّت بعمليات «الترانسفير» أو التحويل والترحيل الملازمة له، وبموجبها جرى:
– شحن المساجين والمشاغبين إلى المستعمرات وراء البحار وتحويلهم إلى مستوطنين.
– تحويل أقنان الأرض إلى بحارة في الأساطيل وجنود في جيوش الاستعمار وموظفين بإدارة المستعمرات.
– اختطاف عشرات الملايين من الأفارقة واستعبادهم بمناجم الفحم ومزارع القطن وقصب السكر بجزر الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة.
– شحن عشرات الملايين من الهند وإندونيسيا إلى مستعمرات جنوب أفريقيا والكاريبي والإنديز وتسخيرهم في الزراعة والمناجم.
– تسخير الناجين من الإبادة بأميركا الجنوبية في مناجم الفضة التي أفنت معظمهم.
ورغم فتور ممالك أوروبا وجماعاتها اليهودية تجاه الحركة الصهيونية وعجزها عن إقناعهم بمشروع «دولة اليهود»، لاح المشروع الصهيوني فرصة سانحة تبنتها بريطانيا لـ«تحويله» إلى حاجز استيطاني أوروبي يفصل مصر عن «آسيا العربية»، ويمنع أي مشروع وحدة كمشروع محمد علي بعد أن قررت بريطانيا في عام 1840، بلسان وزير خارجيتها لورد هنري بالمرستون (1784-1865)، أن سيناء هي الحد الفاصل لنفوذ محمد علي.
لا عودة عن الحل الإمبريالي
إذاً، تتّسم العلاقة بين الغرب الاستعماري والكيان الصهيوني بالطابع الوظيفي، كما بدأتها الإمبريالية البريطانية أولاً، وورثتها الإمبريالية الأميركية لاحقاً بعد قيام الكيان الصهيوني، وبعد حرب حزيران 1967 بخاصة.
كان الأولى أن تكون علاقة الغرب عضوية بالكيان الاستيطاني الأوروبي (المسيحي) بجنوب أفريقيا ونظامه العنصري المعلن رسمياً قبل قيام الكيان الصهيوني. لكن الغرب اضطر إلى تفكيكه، بفعل موجة عالمية من المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، لتمكين الغالبية بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي من تقرير المصير، وفقاً لمبدأ يلخّص نظام الأبرتهايد وأزمته وعنصريته وطريقة تفكيكه، من دون إقصاء أحد: «شخص واحد.. صوت واحد».
نجح الغرب في تأمين المستوطنين البيض وتحصين أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والمدنية، وهذا سرّ ثنائه على الزعيم نيلسون مانديلا الذي أظهر تسامحاً وكرماً بالغاً إزاء التشكيل الاستيطاني، وأكّد مسالمته وحقوقه تحت حكم الغالبية الأفريقية.
أبرز «طوفان الأقصى» مركزية الكيان الصهيوني في منظومة الاستيطاني الدولي، بينما لا يبدي الغرب أدنى قبول بوقف استيطان الأراضي المحتلة عام 1967 أو حق تقرير المصير لشعبها، ناهيك بإنهاء الاحتلال وتفكيك النظام العنصري الصهيوني كما وقع بجنوب أفريقيا.
يتواصل إذاً مسار توظيف المسألة اليهودية بالغرب، لتغذي عمليات «الترانسفير» الغربي ومشروعها الاستيطاني الصهيوني باليهود وسلاح الغرب وأمواله، وتكرّسه حلّاً استعمارياً لـ«المسألة الشرقية» ضمن المشروع الإمبريالي الغربي. ولا عودة لدى الغرب عن إخضاع المشرق واحتلاله واستيطانه وتفتيته. وهذا هو حل «المسألة اليهودية» النهائي بالمنظور الغربي! فهل هناك من يتذكّر الحلّ النازي؟!