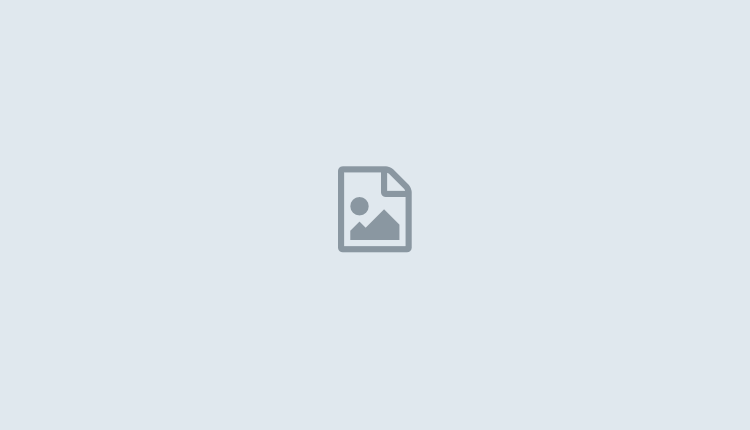في فهم الخطر الصهيونيّ على لبنان والمنطقة: أبعد من الحدود
عبدالحليم فضل الله – وما يسطرون|
يستند الخطاب المناوئ للمقاومة في لبنان وخارجه إلى ثلاث فرضيات: أن لا أطماع للعدو خارج فلسطين، وأنّ التسوية السياسيّة للقضية الفلسطينيّة ممكنة في إطار حلّ الدولتين أو غيره، وأن الخطر الصهيوني الذي يستهدف دولة أو جهة في المنطقة لا ينعكس بالضرورة على غيرها من الدول أو الجهات. يضع هذا الخطاب إسرائيل في موقع الدفاع وردّ الفعل، ويتراءى لحامليه أنّ إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأرض خيار واقعي وقريب المنال مقارنة بغيره من الخيارات المبدئيّة كتحرير كل فلسطين، أو المتخيّلة كحلّ الدولة الواحدة. في رأي هؤلاء أنّ تجزئة الساحات في المنطقة هي الأساس، وأنّ في وسع كلّ دولة على حدة، أن تطمئن إلى منظورها الخاص للأمن القومي، فتراقب سعي العدو إلى حسم حرب غزة وتوسيع هوة التفوق الإقليمي لمصلحته، دون أن تقلق على حضورها ووجودها وسيادتها. يمكن نقض هذه الفرضيّات بالاستناد إلى الوقائع التي تبرز السياق الهجومي في علاقة العدو بمحيطه كالاعتداءات العدة التي تعرّض لها لبنان في حقبة حياده غير المعلن قبل اتفاقية القاهرة (1)، ورفضه الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها عام 1982 رغم مغادرة القوات الفلسطينيّة بيروت ودخول قوات غربيّة متعددة الجنسيّات إليها وإلغاء اتفاقيّة القاهرة وموافقة لبنان في اتفاق 17 أيار 1983 (ألغيت بعد عام) على إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وترتيبات أمنيّة تمسّ بسيادته. وليس بعيداً من ذلك الهجمات التي تتعرّض لها سوريا منذ عام 2013، في خرق لوقف إطلاق النار الذي صمد أربعين عاماً منذ توقيع اتفاقية فك الاشتباك.
لكننا في هذا النص سنذهب أبعد من ذلك في سبر غور الطبيعة الهجوميّة للعدو، عبر شواهد تاريخيّة توثّق أنّه كان دائماً في موقع المبادرة لا رد الفعل، وأنّ رفض قيام دولة فلسطينيّة بأي مساحة كانت وتهجير الفلسطينييّن وطردهم هي في صلب الفكرة الصهيونيّة المؤسّسة للكيان، وأنّ عقيدة الأمن القومي تتعامل مع المنطقة من منظار شامل ومترابط في حسابات الفرص والمخاطر.
التفتيت والاختراق
تبيّن المذكّرات التي أصدرها قسم الشرق الأوسط في وزارة خارجيّة العدو في حزيران 1950 وفي كانون الثاني 1951، الأهميّة التي يوليها العدو للتفريق بين الدول العربية وتشتيت خياراتها، وقد تضمنت هذه المذكرات، حسب رؤفين أرليخ (2) في كتابه «المتاهة اللبنانيّة»، خمسة مبادئ أساسيّة ترتكز إليها السياسة الخارجيّة الإسرائيليّة، والبارز فيها: التصدّي لأي مظهر من مظاهر الوحدة العربيّة انطلاقاً من انعكاس ذلك سلباً، بالنسبة إلى إسرائيل، على موازين القوى في العالم العربي ومعه. والتشجيع المستمر والمنهجي للحلفاء المحتملين (في الداخل العربي) حتى ولو لم تظهر ثمرة ذلك في المدى القريب. وبذل الجهد لتحقيق تسوية سياسية أو اتفاق سلام مع مصر والأردن.
توضح هذه المذكرة النظرة التفتيتيّة إلى العالم العربي، بوصفها مدخلاً للاختراق ولتحقيق الأطماع. كانت نظرية تحالف الأقليّات هي الأساس الآيديولوجي لإستراتيجيّة كيان العدو غداة تأسيسه تجاه دول المنطقة، ولبنان بنظره هو النموذج والمختبر لتفاعل ناجح بين سياسات الاختراق والسيطرة والتجزئة.
حضرت فكرة التحالف بين الحركة الصهيونية ومن سمّتهم بالأقليّات في المنطقة منذ الانتداب، وجرت محاولات لاختبارها ولكن دون نجاح في مواجهة بعض الأحداث كالتي حصلت في سوريا خلال عام 1954. وفي حينه برزت آراء متشدّدة تدعو إلى السيطرة على مناطق منزوعة السلاح أو حتى هضبة الجولان لتغليب كفّة المتمرّدين على السلطة المركزيّة في دمشق رغم سريان اتفاقية الهدنة.
لم تنجح نظرية حلف الأقليات في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وحلّت محلّها، وبالخصوص بعد حرب 1956، نظرية بديلة هي التحالف مع دول الأطراف (إيران، تركيا، أثيوبيا…). هذا التحوّل، لم ينطبق على لبنان الذي أريد له أن يكون نقطة تقاطع بين المقاربتين. فقد واظب بن غوريون وأنصار المدرسة المتشددة على النظر بإيجابيّة إلى ما رأوه طموحات انفصالية لبعض الجماعات السياسية في لبنان. لكن تجربة دعم بعض الفئات أثناء التمرد الكردي في العراق خلال الستينيات وفي لبنان أثناء الحرب الأهليّة انتهت بحسب أرليخ إلى خيبة أمل وتعلّم دروس قاسية بشأن الاعتماد على الأقليّات في الشرق الأوسط.
الاستيلاء على الليطاني
لكن قصة العدو مع هذا البلد لم تكن بهذه البساطة، فلبنان حظي باهتمام العدو من ثلاث نواحٍ، جغرافية وسياسيّة واقتصاديّة. كان نهر الليطاني محلّ عناية الحركة الصهيونية منذ البداية. الخطة الأولى للاستيلاء على النهر وضعها ماكس بوركات بطلب من تيودور هرتسل الذي طرح نقل مياه الليطاني إلى نهر الأردن. ألهمت هذه الخطة وغيرها الوكالة اليهوديّة في نهاية الحرب العالميّة الأولى، في طروحاتها لترسيم ما سمّته حدود «أرض إسرائيل» وفقاً لاعتبارات اقتصادية وجغرافية… وتوراتيّة، بغرض أن تحظى الدولة الوليدة بقدرٍ عالٍ من الاكتفاء الذاتي وموارد حيويّة تلبّي طموحاتها التوسعيّة. ولهذا كان نهرا الأردن والليطاني مصدرين حيويّين لسدّ النقص في الميزان المائي ولا سيما في جنوب فلسطين ولإنتاج الطاقة الكهربائيّة.
الأطماع الصهيونيّة بالليطاني لم تكن مجرد رغبة عابرة، بل مطلباً جاداً وعميق الجذور. ففي كتاب ديفيد بن غوريون وإسحاق بن تسفي، «أرض إسرائيل في الماضي والحاضر» (1920) جُعل الليطاني الحدود الشماليّة لأرض إسرائيل، وكرّر بن غوريون الأمر نفسه في كتابه «نحن وجيراننا» (1931) الذي عبّر بصراحة فيه عن الآتي: «في شمال لبنان الكثافة السكانيّة تقلّص إمكانية الاستيطان… نهر الليطاني أو نهر القاسمية كما يسمّيه العرب، هو الخط الفاصل بين جزئي البلاد، (في جنوبه) طبيعة البلاد والكثافة السكانية أقرب إلى وضع الجليل، بخلاف الشمال حيث الوضع أقرب إلى لبنان… حدود شمال أرض إسرائيل يجب أن تكون القاسميّة».
وضعت اتفاقية سايكس بيكو حدّاً لهذه الآمال، ولم تُجدِ نفعاً مطالب الحركة الصهيونيّة المُقدّمة إلى مؤتمر السلام في باريس عام 1919 في دفع حدود «أرض إسرائيل» نحو الشمال حتى خط العرض 45 الذي يشمل الضفة الجنوبية لليطاني ومصادر مياه نهر الأردن حتى حرمون وسهل حوران حتى نهر العوجة جنوب دمشق. المذكرة التي رفعتها الحركة الصهيونيّة/الهيستدروت إلى مؤتمر فرساي في 3 شباط 1919 لم تستند إلى اعتبارات أمنية بل اعتبارات اقتصاديّة: «المياه والطاقة الهيدروكهربائيّة أمران حيويان لتطوير أرض إسرائيل في المستقبل». وورد في هذه المذكّرة ترسيمٌ مقترح للحدود يبدأ من نقطة في البحر المتوسط جنوب صيدا ويسير فوق هضاب جنوب لبنان وصولاً إلى جسر القرعون باتجاه البيرة، ويمضي جنوباً في الخط الفاصل بين حوض وادي القرن ووادي التيم ثم ينعطف جنوباً مع الخط الفاصل بين السفوح الشرقيّة والغربية لحرمون وصولاً إلى غربي بيت جن.
أحبطت المعارضة الفرنسية الشديدة، لدواعٍ استعمارية صرفة، آمال الحركة الصهيونيّة المدعومة من بريطانيا، وبرّر رئيس حكومتها لويد جورج التنازل بعدم ظهور الليطاني ضمن «أرض إسرائيل» التوراتية حسب الأطلس التاريخي للأرض المقدّسة. بعد ذلك جرت محاولات عدّة من قبل الصهاينة لثني فرنسا وبريطانيا عن موقفهما وإقناعهما بدفع حدود «أرض إسرائيل» نحو الشمال، ولكن مصالح القوتين العُظمتين تغلّبت وحسمت اتفاقية بوليه نيوكامب التي أُقرّت عام 1923 أمر الحدود مع أنها قضمت بعض الأراضي من لبنان.
في مراحل سابقة، عبّرت الحركة الصهيونيّة عن أطماعها في جنوب لبنان بطرق شتى، مثل اقتراح حاييم وايزسمان، الذي ترأس فيما بعد المنظمة الصهيونيّة العالميّة، في عام 1907 إقامة مصانع صغيرة في صيدا برؤوس أموال صهيونيّة مستغلاً وجود سكان يهود فيها. ومنذ عام 1882 أبدت جمعيّة «أحباء صهيون» اهتمامها بالاستيطان في جنوب لبنان وحاولت في تواريخ متعددة شراء مزارع لتوطين عائلات يهوديّة ولكنها أخفقت. وحتى بعد إقامة دولة لبنان الكبير وترسيم حدوده، بقيت تتردد بين الحين والآخر أفكار عن الاستيطان في جنوب لبنان، وفي ذروة حركة الهجرة اليهوديّة في الثلاثينيات من روسيا وألمانيا وبولند طُرحت إمكانية استقبال لبنان للاجئين يهود ولقي ذلك دعماً من بعض الشخصيات اللبنانية المتواطئة مع الصهاينة.
دولة مقلّصة
عادت فكرة الاستيلاء على مناطق جنوب الليطاني إلى الظهور مجدداً وعلى نحو جدي وخطير في خمسينيات القرن الماضي بدفع من بن غوريون الذي بقي على إيمانه بنظرية حلف الأقليات تجاه دولة هشّة كلبنان. أورد بن غوريون حججه الرئيسية في رسالة شخصيّة وجّهها إلى موشيه شاريت في تاريخ 27 شباط 1954، وكان يشغل منصب رئيس الحكومة، وفيها أن لبنان الحلقة الأضعف بين دول الجامعة العربيّة، ويحتضن أقليّة مسيحيّة وازنة، ما يعطي إسرائيل، في رأيه، فرصة تاريخيّة للوصول إلى الليطاني وإقامة دولة مقلّصة في لبنان تحوّل الأقليّة إلى غالبيّة. ورغم خشية شاريت من أن تجرّ المحاولات المتجدّدة لتغيير حدود لبنان مشكلات على إسرائيل، فقد أعرب عن مساندته مدّ يد العون إلى أي حراك انفصالي في لبنان.
كان تفكير بن غوريون عن لبنان جزءاً من مخطّط أوسع لتغيير جذري وطويل الأمد في الشرق الأوسط، هذا المخطّط، الذي عرضه أمام رئيس الحكومة الفرنسيّة غي مولييه، وبعض وزرائه عشية حرب 1956، تضمّن تقليص حدود لبنان وتوسيع حدود إسرائيل حتى الليطاني وزيادة مساحة سوريا التي عُدّت حينها أقرب إلى المعسكر الغربي لتضمّ مناطق تقطنها غالبيّة إسلاميّة، وتضمّنت كذلك مقترحات لتغيير حدود الأردن فضلاً عن الوصول إلى قناة السويس. لم يكن غريباً والحال هذه، وفي سياق يؤكّد عمق حضور نظرية الأقليّات في التفكير الصهيوني، أن يجري تداول أفكار خلال محادثات الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1949 تتضمّن إلحاق المناطق الساحليّة السورية إلى لبنان لفصلها عن الغالبيّة السنيّة هناك (!). وقد قاوم الصهاينة قبل توقيع اتفاقيّة الهدنة مع لبنان في آذار 1949 الضغوطات التي مورست عليهم للانسحاب من القرى الأربع عشرة التي احتلوها خلال عمليّة حيرام نهاية عام 1948، طمعاً بضمّ مناطق جنوب وادي الحجير، أو على الأقل ضمّ المنطقة التي سمّوها «الإصبع اللبناني» في جنوب شرق لبنان الموازية لإصبع الجليل لفصل المنطقة عن سوريا.
بقاء إسرائيل يتطلب منها أن تكون دائماً في موقع الهجوم، سواء أكان ذلك بالحروب الدائمة أم الاستتباع السياسيّ (لبنان 1982) أم الهيمنة الاقتصاديّة (اتفاقيّات التطبيع) أم الاختراق والتفتيت (حلف الأقليّات) أم التطويق (حلف الأطراف) أم زجّ المنطقة في الصراعات الدوليّة (فكرة الحرب على إيران)
ولم يكن اجتياح لبنان عام 1982 مجرّد جباية لثمن جغرافي في مقابل تمركز المقاومة الفلسطينية فيه، بل حمل في طياته أيضاً أطماعاً سياسيّة تعيد إلى الأذهان النزعة الصهيونية المتأصلة في النظر إلى لبنان من منظاري حلف الأقليّات والاستتباع، فالفرصة كانت سانحة لهيمنة إسرائيل على الدولة ككل عبر دعم انتخاب رئيس جمهورية موالٍ لها عام 1982، ثم في تواطؤ بعض اللبنانيّين على توقيع اتفاقيّة السابع عشر من أيار 1983.
يورد ديفيد هيرست في كتابه الجريء والغني عن لبنان «حذارِ من الدول الصغيرة» عدداً من الشواهد والأمثلة التي تدل على نحو لا لبس فيه أنّ هدف إسرائيل كان من البداية تقسيم المنطقة والهيمنة السياسية على ما يمكن من دولها. ولم يكن اجتياح لبنان أخطر النزوات الجيوسياسية التي راودت التيار العام في الفكر الصهيوني، إذ لا يمكن في رأي الكاتب التغاضي عن مقالة بعنوان «إستراتيجية إسرائيل في ثمانينات القرن العشرين» ظهرت في مجلة «كيفونيم» التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية عشية اجتياح 1982، أو عدّها مجرد هذيان من طرف مجموعة مجنونة، فكاتبها أوديد ينون كان سابقاً موظفاً كبيراً في وزارة الخارجية الإسرائيلية. ومن بين ما تورده المقالة، التي تبدو وكأنها امتداد لأفكار بن غورويون في الخسمينيات، السطور الآتية: «إن التفتيت الكامل للبنان إلى خمس دويلات محلية هو سابقة لكل العالم العربي، وتفكيك سوريا ولاحقاً العراق إلى مناطق ذات أقليات عرقية ودينية تتبع النموذج اللبناني هو هدف إسرائيل الرئيسي في المدى البعيد على الجبهة الشرقية، أمّا الإضعاف العسكري الحالي لهذه الدول، فهو هدف المدى القريب. ستتفتت سوريا إلى دويلات عدة وفقاً لبنيتها العرقية والطائفية، سيكون هناك دولة علوية-شيعية ودولتان سنيّتان متصارعتان في حلب ودمشق وللدروز دولتهم أيضاً. أمّا العراق، فلا بد من تقسيمه مثل سوريا ولبنان إلى ثلاث دول تتركز حول المدن الرئيسية الثلاث الموصل والبصرة وبغداد إلى جانب دولة كردية مستقلة. وشبه الجزيرة العربية بكاملها مرشحة للتفكك… ويجب أن تكون سياسة إسرائيل في الحرب والسلم أيضاً إزالة الأردن من الوجود…».
كان لبنان موضع استخفاف العدو منذ حملة حيرام ضده في خريف عام 1948. كان في وسع قوات العدو، كما ذكر قادة الحملة، الوصول إلى بيروت بفعل تحاشي قوات الجيش اللبناني الاصطدام بالقوات المتقدّمة. بعد ثلاثة عقود من ذلك بدأت الصورة تتغيّر، وانقلبت الآية مع ظهور المقاومة الإسلامية في لبنان وتوحيد الجهود في محور يمتد على مدى خمس دول عربيّة، في تفكيك لعناصر السياسة الصهيونية. فأهداف محور المقاومة تقع على النقيض مما ورد في مذكرة وزارة الخارجية الصهيونية المشار إليها أعلاه وغيرها، بتأكيده الوحدة في مقابل التجزئة (التصدي لمظاهر الوحدة العربيّة) والتنوع في مقابل التفتيت (حلف الأقليّات) والتحالف مع إيران الذي أطاح بنظرية حلف الأطراف.
الطرد والتهجير
تفيد بعض المزاعم بأن ورود عبارة وطن قومي بدلاً من دولة لليهود في وعد بلفور لم يكن مصادفة، بل يؤكّد أن الغرض من الوعد لم يكن حرمان غير اليهود من حقوقهم في فلسطين. وقد حمل بعض الصهاينة ذلك في البداية على محمل الجد، ووصل الأمر ببعضهم مثل جماعة بريت شالوم وإحاد هعام إلى تبني رأي مفاده أن الأهميّة هي للحفاظ على التراث والثقافة اليهوديين حتى من دون إقامة دولة منفصلة داخل فلسطين، أو في أبعد الحدود إقامة دولة ثنائيّة القوميّة، فالمبدأ هو عدم الاصطدام بالعرب لإيجاد بيئة آمنة لليهود. في العشرينيات ظهرت آراء مضادة من قبل ما سمي التيار التصحيحي بقيادة زئيف جابوتنسكي، الذي لم يرَ مناصاً من الاصطدام بالعرب لتحقيق الأطماع في أرض فلسطين. ومع أن الاستيلاء الكامل على فلسطين كان الهدفَ المضمر للجميع، فإنّ الخلاف لم يُحسم رسمياً داخل الحركة الصهيونيّة إلّا في أيار 1942، خلال اجتماع كبار القادة الصهاينة في نيويورك وعلى رأسهم وايزمن وبن غوريون وقادة الجالية، أقرّ فيه مبدأ السيادة اليهوديّة المطلقة في «دولة يهوديّة» على كامل مساحة فلسطين الانتدابية.
مهّد ذلك إلى أن تكون خطط التطهير العرقي علنية وواسعة النطاق في البلدات الفلسطينيّة. أمّا الرواية التي تنسب مأساة فلسطين إلى الفلسطينيين أنفسهم، فإنّها تفككت على أيدي الصهاينة أنفسهم، وبالخصوص في كتابات المؤرّخين الجدد وأعمالهم التي استندوا فيها إلى ما كُشف، من وثائق ما يسمّى «الأرشيف الوطني الإسرائيلي». قدّم هؤلاء اعترافاً لا لُبس فيه بالجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، وبعضها كما يُقرّون كان متعمّداً ومخططاً له بصفته من ضرورات ولادة الكيان.
علينا ألّا نفاجأ، ولن نُفاجأ بطبيعة الحال، من طفو خيار الطرد إلى قاموس حرب غزّة فورَ عمليّة «طوفان الأقصى»، فله جذور إيديولوجية عبّر عنها بصراحة مؤسّسو الحركة الصهيونية قبل سنوات عدّة من احتدام الصراع داخل فلسطين. وينقل بني موريس في كتابه «مولد مشكلة اللاجئين» أن تيودور هيرتزل، دعا في الثاني عشر من حزيران 1895 في مذكّراته اليوميّة إلى تجريد الفلسطينيّين من الأرض وبإغراء الفقراء بالمغادرة عبر تأمين عمل لهم في بلاد العبور.
وفي اللقاءات الخاصة بين قادة الحركة الصهيونيّة كان تسويق حلّ الترانسفير يقع في صلب مواقف الصهاينة الأوائل لحلّ ما كانوا يسمّونه المشكلة العربية: «لا يمكن السماح للعرب بإعاقة بناء قطعة تاريخية مهمة جداً… يجب أن نقنعهم برفق بأن يغادروا، فهم رغم كل شيء لديهم الجزيرة العربية التي تضمّ ملايين الأميال ولا يوجد أي سبب خاص للعرب كي يتشبّثوا بهذه الكيلومترات القليلة. ولمّا كانت عادتهم هي طيّ الخيام والذهاب بعيداً، فليضربوا المثال على ذلك الآن».
غير أن معظم المنادين بالترانسفير احتفظوا بآرائهم لأنفسهم أو اقتصروا في تداولها على الخطابات الشخصية داخل الدوائر الصهيونية كما يقرّ بذلك المؤرّخون الجدد، وفيما كان خطابهم العلني «المنافق»، منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى أربعينيات القرن العشرين، يعلن أنّ في فلسطين مكاناً كافياً لكلا الشعبين، كانوا يخططون سراً لما يقولون إنه أمر لا مفرّ منه: إنّ قيام دولة يهودية غير ممكن دون طرد العرب. ومع مرور الوقت تخلّى قادة الحركة الصهيونيّة عن حذرهم تجاه مسألة الترانسفير، ومن ثلاثينيات القرن العشرين بدأت في الظهور دعوات عالية النبرة وتُقارِب الإجماع مؤيّدة للفكرة. وبرزت طروحات من قبيل الضغط على البريطانيين لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة المنظّمة إلى العراق أو إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن. وقد استغل بن غوريون صدور تقرير اللجنة الملكيّة البريطانية، التي أُوفدت إلى فلسطين عام 1936 ونُشر تقريرها في تموز 1937 وتضمّنت توصية بنقل السكان، ليقول: «يجب أن نتمسّك بهذه التوصية تمسّكنا بوعد بلفور… إذا لم ننجح في إزاحة العرب من بيننا في الوقت الذي تقترحه اللجنة البريطانية ونقلهم إلى المنطقة العربية، فإن ذلك يمكن تحقيقه بسهولة بعد قيام الدولة اليهودية».
إنّ الاستيطان الذي نراه اليوم في فلسطين ودعوات التهجير، هما القرينة المادية على الجريمة المتمادية والأصلية التي مهّدت لقيام «دولة إسرائيل». يعترف بن غوريون نفسه بذلك في المؤتمر العشرين للكونغرس الصهيوني الذي عُقد في زيورخ في شهر آب 1937 لمناقشة التقرير البريطاني، بقوله: «ففي عدد من البلاد لن يكون من الممكن إقامة استيطان جديد من دون نقل فلاحين… النقل أو الترانسفير هو الذي سيجعل من الممكن تنفيذ برنامج استيطان شامل». لكن التخطيط للنقل والطرد والتهجير لم يكن أبداً باللطف المزعوم، ففي الاجتماع المذكور الذي انتهى بعد نقاش صاخب إلى الموافقة على تقرير بيل الذي يوصي بالطرد، اقترح بن غوريون أن يكون النقل إجبارياً وبواسطة القوات اليهودية لا البريطانية كما يوحي التقرير، ولا بطريقة منظّمة كما كان يُظنّ.
وبعد خمس سنوات من هذا التاريخ، كشف بن غوريون عن نواياه بأعلى درجات الصراحة: «أؤيّد النقل الإجباري، ولا أرى فيه أي شيء غير أخلاقي!»، وحذا آخرون حذوه «لا شيء لا أخلاقياً في نقل 60 ألف عائلة عربية! لا يمكن أن نبدأ بدولة يهودية ونصف سكانها من العرب». والأدهى من كل ما تقدّم أن المقصود لم يكن نقل أفراد أو قرى بأكملها فحسب، بل نقل فئات اجتماعيّة عرقية ودينية محدّدة ما ينمّ عن دوافع فئويّة مكتومة وعمق فكرة الأقليّات في العقل الصهيوني. ففي تشرين الأول 1941 كتب بن غوريون نفسه: «الدروز، وعدد من القبائل البدوية في وادي الأردن، وربما كذلك المتولي (شيعة يعيشون في شمالي الجليل حسب وصفه)، قد لا يمانعون أن يُنقلوا في ظروف مشجّعة إلى دول مجاورة».
وفي نهاية المطاف طُرد الفلسطينيون والعرب بطريقة دمويّة وعبر عشرات المجازر باعتراف المؤرّخين الصهاينة أنفسهم الذين لم يجدوا بدّاً من الإقرار بأن عمليات تنظيف واسعة النطاق قد جرت طوال مدّة الصراع السابق لإقامة الدولة، والتي لم تكن لتوجد لولاه. ويقرّ هؤلاء أيضاً أن الأشهر القليلة التي سبقت قيام الكيان في عام 1948 شهدت إعداد خطّة ضخمة للتهجير هي خطّة «دالت» التي وضعت في بداية شهر آذار 1948 ورأى فيها بني موريس في كتابه «برنامج عمل لتأمين الدولة اليهودية الناشئة». فُوّضت القوات الصهيونية بتدمير القرى التي تبدي مقاومة وطرد سكانها. شمل ذلك قرى وبلدات عدّة كانت قد عقدت اتفاقيات مصالحة وتسوية مع جوارها اليهودي، لمجرّد أنّها كانت تهدّد تماسك أراضي الدولة اليهودية العتيدة. كان هذا التصريح المطلق المعطى لقادة الجبهة والألوية والأحياء والفرق الصهيونية هو إشارة البدء بالمرحلة الثانية للتهجير الذي أخذ طابعاً واسعاً وشاملاً ودموياً. ولم يقتصر الأمر على العصابات التي توصف بالمتطرّفة كـ«الأرغون»، بل شمل أيضاً قوة «الهاغانا» الأساسيّة (البالماخ) التي كانت نواة ما سُمّي فيما بعد «جيش الدفاع الإسرائيلي».
قوس النزول
تظهر الوقائع والأحداث والقرائن التاريخيّة، أن بقاء إسرائيل يتطلب منها أن تكون دائماً في موقع الهجوم، سواء أكان ذلك بالحروب الدائمة أم الاستتباع السياسيّ (لبنان 1982) أم الهيمنة الاقتصاديّة (اتفاقيّات التطبيع) أم الاختراق والتفتيت (حلف الأقليّات) أم التطويق (حلف الأطراف) أم زجّ المنطقة في الصراعات الدوليّة (فكرة الحرب على إيران). وتتكامل هذه العناصر والخيارات في ما بينها لتكون أساس عقيدة الأمن القومي للعدو التي لا تفرّق بين الساحات والجبهات والدول.
لكنّ انتقال إسرائيل من الهجوم إلى الدفاع في الحرب الحاليّة، يدلّ على أن المشروع الصهيوني هو في قوس النزول بالمعنيَين التاريخي والإستراتيجي. تفتقر إسرائيل إلى عناصر الثقة والاطمئنان مهما أُعطيت من أسباب القوّة الغاشمة، وتنتابها الخشية من أن تهتزّ مظلّة الحماية الأميركية التي تظللها، ما دفعها في العقد الماضي إلى البحث عن عمق عربي ومظلة مشرقية ونيل رخصة غربيّة بالسيطرة على كل فلسطين. وفيما كان هدف إسرائيل اختراق مجتمعات المنطقة وتفتيتها، ها هي تعاني من انقسام آيديولوجي وسياسي ومصلحي لم تهدأ ارتداداته حتى خلال الحرب الإبادية على غزّة.
لا تلقي الدول العربية بالاً لمعاهدة الدفاع العربي المشترك (الموقّعة في تاريخ 18 حزيران/يونيو 1950)، في تناغم مع أحد مرتكزات السياسة الصهيونيّة تجاه المنطقة، ولكن يعوّض عن ذلك حلف المقاومة، الذي يؤدي ذات الوظيفة الدفاعية المُتَخلّى عنها، ويتحلّى بالصفات نفسها التي لا بدّ منها لنهضة الأمم: الرؤية والإدراك والقدرة على التحمّل والشجاعة في القرار والمبادرة.
—-
(1) جنرال صهيوني. نائب منسق نشاطات الاحتلال في لبنان بين عامي 1985 و2000
(2) حسب قاعدة بيانات المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق يُقدّر عدد شهداء الاعتداءات على لبنان بين عامي 1948 و1969 بـ 218 مدنياً