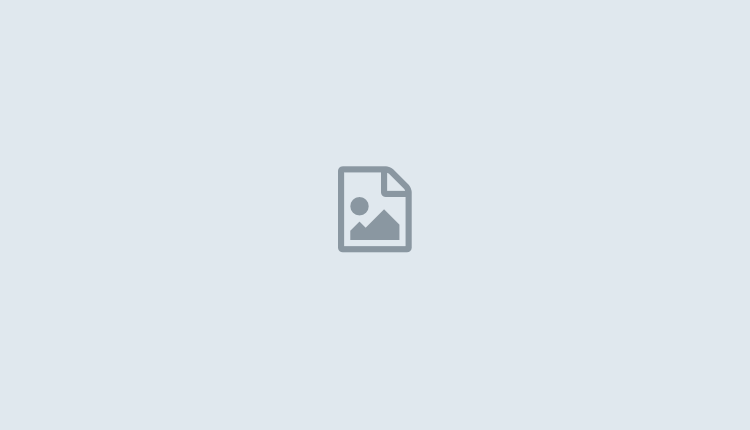اليمن بين اغتيالين
طالب الحسني – وما يسطرون|
مثلما يتحضر كيان العدو الإسرائيلي لمواجهة الرد العسكري الإيراني -العربي المشترك على اغتيال القائديْن العربييْن هنية وشكر في بيروت وطهران، هناك دول عربية أيضاً تستعد للشراكة في الدفاع عن “إسرائيل”!
من أي خلفية أردت أن تأتي لتفكيك هذه المفارقة ستجدها إنجازاً إسرائيلياً- أميركياً، هو نتاج عقود طويلة من العمل والتخطيط في المنطقة. لقد أخذت هذه الدول أو بالأحرى الأنظمة خارج دائرة الصراع العربي- الإسرائيلي بالتدرّج، وعبر مراحل زمنية ممتدة إلى نحو 80 عاماً.
لست بصدد الكتابة عن “التطبيع” لكنه مدخل لفهم كيف وصل الحال ببلدان عربية أن تشارك في الدفاع عن العدو الإسرائيلي، ولو قيل لرجل أدرك بوعي ستينيات القرن الماضي ما يرتبط بهذا الصراع الوجودي سيكون من الصعب تغطية هذه الفجوة بين جيل ذلك العقد واليوم، إنه انتقال من الكفاح المسلح المدعوم إلى الحوار والسلام الموهوم إلى الحياد السلبي المذموم قبل أن “يتطور” خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى الشراكة في الأهداف الاستراتيجية على غرار العداء لإيران وتجريم سلاح المقاومة الفلسطينية والعربية وتلك العابرة للهويات والجغرافيات، ونحن اليوم نراقب ما يشبه الدفاع المشترك ( بعض العربي الأميركي عن إسرائيل )، وليس مستبعداً إن توسعت الحرب لتصبح شاملة إقليمية بين محور المقاومة والعدو الإسرائيلي وبالطبع الأميركي أن تصطف هذه الدول “العربية” مع “إسرائيل “.
تنتهي هذه الجزئية بنقطة، وليس من المستحسن إضافة علامتي استفهام وتعجب.
ثمة زاوية أخرى “موجعة” يجب الاعتراف بها، وهي أن الشارع العربي قد أصيب أيضاً بحالة برود شديدة، مع بعض الاستثناءات المحدودة. صحيح أن السواد الأعظم يتعاطف مع غزة التي تباد، ولكن ما قيمة التعاطف إذا كان على قاعدة قلوبهم معك وسيوفهم عليك؟
وإذا كان “البرود الشديد” والتعاطف المفرغ من أي “شحنة حماس” هما ردة فعل الشعوب العربية تجاه الإبادة المسكوت عنها في قطاع غزة، فمن غير الممكن أن تكون أفضل حالاً إزاء الأنظمة والحكومات العربية التي انحازت إلى صالح العدو الاسرائيلي! ومرة أخرى، الاستثناءات محدودة.
في ساحات النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تسمع جدلاً غير منته بين تيارات “متعددة” واحد منها ذلك الذي يبرر أن تتصدى دول عربية للصواريخ والطائرات المسيرة التي تهاجم “إسرائيل” لإسناد غزة عندما تطير فوق أجوائها، لكنها لا تقوم بالأمر نفسه مع الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تعبر لضرب دولة عربية كما حصل حين أغارت على ميناء الحديدة، المدينة اليمنية الساحلية بعد استهداف صنعاء لـ”تل أبيب”.
الذين يبررون ليسوا هواة بل هم “النخب”، وليسوا أقلية بل يكادون يتوازون مع أولئك الذين ينتمون إلى التيار المحافظ. لم يكن هذا التصنيف حتى وقت قصير معهوداً، فما من محافظ وغير محافظ بالنسبة إلى الموقف من القضية الفلسطينية، نعم وجدت حالات شاذة وفعلوا ذلك سراً خوفاً من العزل الشعبي قبل الخشية من القوانين المجرّمة للتطبيع.
لقد هدم هذا الجدار، جرّب الآن أن تقول أو تكتب أن أنظمة عربية وجيوشاً تستعد للمشاركة في التصدي لعملية هجومية ستنفذها طهران وصنعاء وحزب الله اللبناني انتقاماً لاغتيال “إسرائيل” قائديْن مقاوميْن عربييْن، هنية وشكر، ستجد جدلاً وتبريراً كثيراً عقيماً، حتى إن وجدت أصواتاً كثيرة تندّد.
ويزداد الأمر سوءاً إن كان ذلك يحدث برغبة “وقناعة” من تلك الدول أو تحت الضغط والإكراه الأميركي أو بكليهما معاً، تجب الإشارة أيضاً إلى أنها سابقة في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي بالمقارنة بحربي 67 و 73. وبكل المراحل السابقة.
والأقرب أن ذلك يحدث لثلاثة أسباب متداخلة :
– السياق الطبيعي لهذه الأنظمة التي خضعت لعلاقة طويلة غير مقيّدة مع الولايات المتحدة الأميركية
– قناعة راسخة أن المسار “الصحيح” هو التسليم “بدولة” إسرائيلية قائمة يجب التعامل معها كواقع بعيداً من مواصلة الانحياز الشكلي إلى القضية الفلسطينية.
– مخاوف حقيقية قوية بأن انتصار حماس والمقاومة الفلسطينية هو انتصار للمحور الذي تتصدره الجمهورية الإسلامية.
في خطابه الأخير، تعمّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن يفرد ما بين 10 إلى 15 دقيقة منه للتذكير بأن انتصار ” إسرائيل ” لا يشكل تهديداً لحماس والمقاومة الفلسطينية وحزب الله فحسب، وإنما على القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية والدول العربية والمنطقة، ثم وضع نصر الله ذلك فقط مجرد افتراض لكي يؤكد أن من يمنع ذلك هو المقاومة والمحور – المطعون عربياً من الظهر –
وهي رسالة ضمنية قالها للتاريخ وليس لتلك الدول فهو يعرف أن موقفها لن يتغير، وكذلك للإشارة أن جميع المقتضيات الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية والقومية وحتى الاستراتيجية تفرض الخروج من هذا المربع.
مقابل هذه السردية للواقع ” المحبط “، يجب التأكيد أن هذا القسم من ” الوجود العربي الميت ” هو الذي يسقط الآن، تموضع بعض الأنظمة والدول العربية في المعسكر الإسرائيلي- الأميركي -الغربي هو معركة في سبيل البقاء، ذلك لأنها بطبيعتها وصيرورتها وتركيبتها في هذا المعسكر نقيض محور المقاومة ومع المحور الأميركي ولو لم تكن كذلك لكانت قد سقطت.
لا أعتقد أن أحداً يجهل أن التدخل الأميركي والبريطاني والغربي في تركيب الأنظمة العربية الرسمية يحدث ضمن ” الديباجة ” التي تقول حين تصف العلاقات والاتفاقيات والمعاهدات التي توقع بين هذه البلدان والولايات المتحدة الأميركية بأنها تعاون بين “البلدين الصديقين”. لكنها ليست كذلك فالقاعدة تقول إن دول المنطقة يجب أن تكون داخل دائرة النفوذ الأميركي وليس خارجها كجزء من مستلزمات ” القوة العظمى.
ما هو خارج الدائرة، هو تمرد من منظور أميركي- غربي يتم التعامل معه بالقوة الغاشمة، أو بمحاولة العزل وعدم الاعتراف، أو بفرض العقوبات والحرب الاقتصادية، وأحياناً كل هذه ” الأسلحة ” والنماذج كثيرة، إيران، كوريا الشمالية، فنزويلا، العراق، أفغانستان، نظام القذافي، الدولة السورية، واليمن منذ 2015.
لكن، مثلما يجري في التاريخ أن الإمبراطوريات ” تشيخ ” وتضعف وتهتز، جرى ويجري على الولايات المتحدة الأميركية وفوق ذلك أن المحور الذي قرر التمسك بالسلاح وفكر المقاومة من مطلع ثمانينيات القرن الماضي هو الآن أقوى من البدايات بعشرات المرات، واستعصى على محاولات محوه واستئصاله في مراحل متعددة، ولذلك هي صيرورة حتمية، فلو لم ينتصر حزب الله في 2000، 2006، 2012 وما بعدها كان سينتصر حتماً في أعوام غيرها، وبالقياس حماس والجهاد الإسلامي وزميلاتهما، لو لم يحدث “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 لحدث في أي تاريخ آخر.
صراع اليوم هو نتاج تعاظم قوة الحرية التي أرادت من وقت مبكر كسر الاستبداد والاحتلال والنفوذ كمسار حتّمه الانتماء إلى أرض وتاريخ وهويات وثقافات وأديان هذه المنطقة باستخدام القوة المقاومة مقابل قوة الاحتلال الإسرائيلي وقوة الحماية الغربية، وقوة أخرى تتمثل في الخذلان والكيد العربي، وهذه هي فلسفة الحرب القائمة والمستقبلية أيضاً.
رؤية دول وأنظمة وحتى أحزاب وتيارات من جنس المنطقة في “خيام” الاحتلال جزء من الصراع تكرر عبر التاريخ بنماذج مختلفة فهل يملك أحد تفسيراً يشرح ديمومة العلاقة الأميركية بمنطقة الخليج من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بحلقات متسلسلة من النفوذ الاستراتيجي على قاعدة التبعية مقابل الحماية، ثم الحماية مقابل المصالح المشتركة. لاحقاً، صار الثابت أن البقاء ضمن هذه الدائرة المحمية ” بالقوة العظمى ” يتطلب الشراكة في مواجهة ” الخصوم ” و” التمردات ” عن الدائرة المكتملة، المصير المشترك.
عندما اختارت الولايات المتحدة الأميركية تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وتجريم الكفاح المسلح ضد العدو الإسرائيلي صممت اتفاقية ” أوسلو “، على الرغم من أن حل الدولتين وهم ومشروع مرتبط بنزع السلاح المقاوم، ومن روح أوسلو صمم ما يسمى المشروع العربي للسلام. حسناً، ألم يكن الاتجاه الطبيعي أنه عندما لا يتم تنفيذ أوسلو وتخرج الدولة الفلسطينية المنزوعة كل شيء من الاتفاقية أن ينتقل “أنصار أوسلو ” إلى مشروع آخر ؟ لم يفعلوا.
وحتى الآن، أظهر كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية أن قيام الدولة الفلسطينية غير مقبول وغير ممكن. لم يفعلوا، لأن البقاء في الدائرة له حيثيات وخلفيات تتعلق بالحماية، والبقاء وديمومة وأبدية العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتنسحب هذه ” الاستراتيجية ” على الموقف من ” إسرائيل ” ولم تكن ” اتفاقية أبراهام ” 13 آب/أغسطس 2020 والتي ” يغنيها ” نتنياهو كلما تذكر ” العرب ” سوى محطة على طريق ” قطار التحالف البعض العربي- الأميركي ” حتى هذه لو لم تحدث في 2020 لكانت ستحدث في تاريخ آخر، اذ إنه ليس صحيحاً أنها إنتاج ترامب وإنما صادفها في شهرها التاسع.
من هذا العمق يمكن رؤية شماعة الانصراف عن حماس والمقاومة بسبب العلاقة مع إيران بلا قيمة.
وهب أن حماس تقاطعت مع إيران فأين تلتقي مع هذه الدول؟
حماس مشروع مقاومة وسلاح وأنفاق وصواريخ، وهذه الدول نقيض ذلك تماماً، لا مشروع، ماذا ستستفيد فلسطين من ألف نسخة مكررة من عباس.
في الحالة القائمة، الحرب العربية الإسلامية مع العدو الإسرائيلي وحماته الأميركيين وبعض العرب تخطر في البال خلاصتان متقاربتان للشاعرين :
الأولى حين قال المتنبي لسيف الدولة: وسوى الروم خلف ظهرك روم.
والثانية للراحل أمل دنقل:
إنها الحرب
قد تثقل القلب
لكن خلفك عار العرب
لا تسالم ولا تتوخ الهرب.