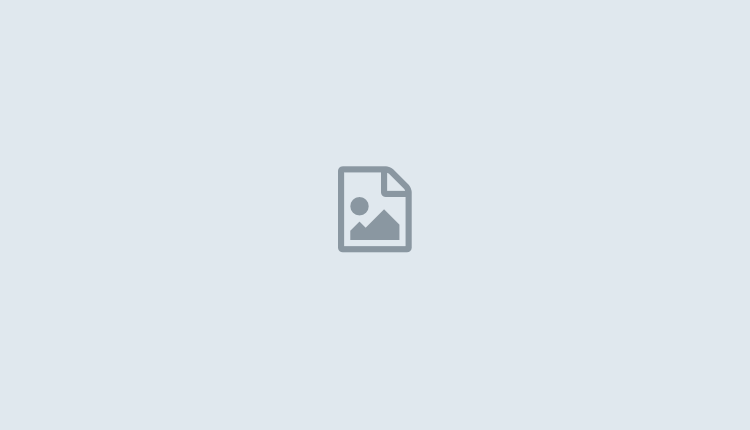العلاقة بالغرب: أما آن لهذا السؤال أن ينتهي
عوني بلال – وما يسطرون|
ما حصل كان هائلاً. الكل يقول ذلك. والكل يكتب ذلك. لكنَّ قول الأشياء وإدراك الأشياء أمران مختلفان جدّاً. هل ندرك حقّاً حجم ما حصل. لا أزال إلى اليوم أسأل نفسي هذا السؤال. للبعض، لم تكن عشرة أشهر من المجزرة فرصة للتفكير في ما سبق، وإنما فرصة -معتادة كغيرها- لتعزيز ما سبق: للتمترس في ما عليه المرء، مع ما يستلزمه ذلك أحياناً من تلاعب وشطارة عندما يصطدم السابق باللاحق. يستوي في ذلك أتفه المراهقين وأكبر المفكّرين. لكن ما جرى، مرّة أخرى، كان هائلاً، ولم يكن للتلاعب ولا الشطارة أن يصمُدا أمامه طويلاً.
حدثٌ هائل كهذا يصنع ضغطاً هائلاً. أربعون ألف شهيد، وطبيب يبتر ساق ابنته بلا مخدّر. أي وعي يبقى على حاله بعد هذا. ومهما كانت زاوية النظر، فالمشهد صار مزدحماً بالتوترات وخطوط التماس، ليس بيننا وبين العدو، بل بيننا نحن أنفسنا. أكثر هذه التوترات لم تولد مع الحدث الجاري، فهي سابقة عليه، لكنها -بفرط الضغط- وصلت إلى نهايتها القصوى وتحولت شقوقها إلى صدوع. وإذا كان من توتر واحد يستحق أن يكون مركزاً لكل ما سواه فهو رؤيتنا إلى هذا الغرب؛ موقفنا منه، وفهمنا له وكيف نرى أنفسنا أمامه.
كثيرون سئموا من سؤال «العلاقة مع الغرب». وهو سأمٌ مستحقٌّ كي يكون المرء منصفاً. عقود أنفقت في الكتابة الغزيرة عن هذه المسألة. وجُلُّ هذا المكتوب رداءات من فئة «نأخذ من الغرب ما ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا»، وكأن الأمر بازار مفتوح ومشكلتنا هي فنّ الاختيار. هذه العبارة المدرسية هي خلاصة أعمال ضخمة لمثقفين لامعين ملؤوا آلاف الصفحات، لكنهم لم يقولوا عملياً في ختامها إلا هذه: «نأخذ ما ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا». ولذلك، فالازدحام الظاهر في نقاش «العلاقة بالغرب» زحامٌ زائف إلى حدٍّ كبير. وحتى بتنحية هذا كله، فقد كان جديراً بالمجزرة الحالية (الغربية في سلاحها وتمويلها ومجرميها) كان جديراً بها أن تضع نهايةً لسؤال العلاقة بالغرب. أن تغلِق ملفه بعد أن صار الجواب فاقئاً للعين. هذا ما يتخيله المرء على الأقل. لكن ذلك طبعاً لم يحصل، ولا هو سيحصل عمّا قريب.
في عزّ المجزرة، يخرج مثقف لامع ليحذّر من مغبة انسحاب الأميركيين من المنطقة (منعاً للاجتياح الإيراني)، ويكتب آخر في هزالة الضربات الأميركية على اليمن (مطالباً بالمزيد)، فيما ينظّر ثالث في أهمية بناء اللوبي العربي بواشنطن (قياساً على اللوبي الصهيوني). هذه عينات من تيار كبير يعيش بيننا ومعنا، وليس له إدراك للعالم دون مركزٍ غربي يشعّ الوجودُ والمعنى منه. مواقف هؤلاء لن تتغيّر على وقْع مذبحة مهما كبرت لأنهم نتاج السطوة الغربية وعَرَضٌ لها قبل أن يكونوا أصحاب رأيٍ فيها.
إن كان للتحرّر مقياس فهو في جرأة الخروج عن أنماط الحياة التي رسّخها ذلك الغرب. إلى أي حد يجرؤ أكاديمي عربي -مثلاً- أن يبحث في قضايا ويكتب بأساليب لا تعترف الأكاديميا الغربية بها، ولا تُسهم في صعوده المهني في جامعته المصمّمة قياساً على جامعات غربية؟
يحب كثيرون القول إننا نجعل الغرب شمّاعةً لفشلنا. ليست المشكلة في صحة المعنى المقصود أو عدمه. المشكلة هي وقاحة المجاز. أن تصف الغرب بالشمّاعة، وأن تصفه شمّاعةً لنا، نحن تحديداً. يكفي أن تطالع توزّع القوات التابعة لقيادة المنطقة الوسطى الأميركية (سنتكوم) حتى تعرف حقّاً مَن الأجدر بلقب الشمّاعة ومَن يلعب دور المِشجب؛ نحن أم هذا الغرب.
كنت أنظر في خارطة أعدّها مركز دراسات عسكري عن توزّع القواعد الأميركية حول العالم. وإلى حدٍّ كبير فهي تشبه خرائط انتشار الأمراض المعدية، ولا يبدو المشرق العربي فيها إلا مركزاً للوباء ومهد الجرثومة الأول. ما من منطقةٍ كهذه على سطح الكوكب (في تزاحم الدول المستضيفة). ولمن يَعُدّ نفسه عربياً، فلا أعرف خريطة مُهينة كهذه الخريطة.
حتى تلك الخرائط الشائعة لفلسطين، والتي ترسم لك سلسلة مرقّمة تريك ما تبقّى من الوطن السليب بعد كل حرب، حتى تلك الخرائط لا تحمل مذلّة جغرافية كهذه. قواعد عسكرية من هذا النوع لا تأتي ومعها أسلحتها وحسب. هي تأتي ومعها سطوة في كل شيء؛ في السياسة والاقتصاد، في أروقة الجامعات ومراكز البحث، في مأكل الناس ومشربهم، في التقنيات وأنماط الحياة وحتى بالكلام والمفردات وأفق الخيال والتفكير. ما يفصل التنوير الأوروبي عن حاملة الطائرات الأميركية أقل بكثير مما يحاول مثقفو الحداثة العربية أن يروّجوا له.
كنت أتحدّث مع باحث متخصّص قبل بضع سنوات في دولة عربية تزخر بقوات أميركية من كل شكل: جوية، وبحرية وبرية. واستبدّ بي التساؤل وهو يحدّثني في مسألة سياسية: كم يا تُرى من تلك القوات في رأسه -ورأسي- ونحن نتكلم؟ كم من إدراكه وإدراكي يتشكّل في عقولنا حقّاً وكم منه يتشكّل داخل تلك القواعد؟ وهل جدرانها المحصّنة تسوِّر مَن في داخلها أم أنّ الأمر بالمقلوب تماماً ونحن المسوَّرون في الخارج.
هذه من أشكال القوّة التي تريعُك في سطوتها واختراقها للوعي: ليس لأنها ظاهرة، بل للعكس تماماً. ما من تماسٍّ مباشر بين أغلب مجتمعاتنا وهذه القواعد، لكن على المرء أن يرسم الخطّ الاجتماعي والتنظيمي الذي يصل بين الطرفين؛ بيننا وبينها. هذا خطٌّ طويل جدّاً ومتشعّب جدّاً يَعبر في طريقه كلّ مفاصل الدولة والمجتمع. قد يعيش المرء حياته كلّها دون أن يقابل جندياً واحداً من العاملين بتلك القواعد، ودون أن يلمح طائرة من طائراتها أو يعرف بنشاط من نشاطاتها، لكن حياته كلّها ملوّثة بها ومصمّمة لضمان استمرارها.
هذه ليست قراءة فلسفية مجردة في البنى الخفيّة للقوّة، ولا هو تنظير عقائدي يحاول نبش معانٍ متخيّلة، بل إدراك مادّي بحت لسطوة آلة القتل وسلطة الممسكين بها. هكذا تجد نفسك أمام أبسط الأسئلة وأكثرها مصيرية في ذات الوقت: ماذا نريد؟ هل نريد علاقة تبعيّة للغرب (نسمّيها تعاوناً وصداقة كي نهوّن الأمر على أنفسنا) يرافقها استقرار وهدوء، وحياة نزجيها في مراقبة معدّلات النمو ومؤشرات التضخم والتبرم من الفساد وبناء الأبراج وتنظيم المهرجانات، أم نريد تمرّداً على المركز الغربي مع ما يرافق ذلك من مخاطر محدقة على كل وجه من أوجه الحياة. هل نريد دبي ونيوم أم نريد خانيونس وصنعاء؟ هل نريد عالِم الكيمياء أحمد زويل متأنّقاً على منصة نوبل، أم نريد عالِم الصواريخ جمال الزبدة مسجّىً على الأكتاف؟
أهمية الطوفان أنه صعّب التوفيق بين هذه الأطراف، وأوصل هذه الثنائيات إلى مرحلة الصدام. أمام أسئلة كهذه، لا نفع غالباً من الجدال لأن دوافع الإجابة تأتي من موضع في الإنسان يخصّ كيمياءه وجوهر إدراكه لنفسه والعالَم. التمرّد على الغرب سعياً للتحرّر ليس درباً عادياً، وحجّته العقلانية معقّدة ولا تقبل الاختصار لأن كلفة التمرّد باهظة جدّاً وتحتاج إلى تبرير بحجم التكاليف. العقلانية وحدها لا تكفي لاقتحام سبيل كهذا. تحتاج معها إلى إيمان أيضاً، وطويّة من نوع خاص. وكل ما يقال في هندسة المجتمعات العربية يتركّز تحديداً هنا: في ضرب هذه الطويّة وتبهيت هذا الإيمان.
وعندما نتحدّث عن توتر في رؤيتنا إلى الغرب، فالأمر ليس قسمة بين فريقين: واحدٌ يعادي الغرب وآخر يناصره. القسمة تخصّ استلهام نظام بعينه، في الأفكار والمعاني، وفي بنية الدولة والمجتمع، وحتى في معاشنا اليومي وسؤال «ماذا نريد». بوسع المرء أن يشتُم الولايات المتحدة ليلَ نهارَ. بوسعه أن يستعيذ من مجونها وشذوذها وقيمها على رأس كل ساعة.
ليس في هذا تحرّر من سطوة الرجل الأبيض بشيء. إن كان للتحرّر مقياس فهو في جرأة الخروج عن أنماط الحياة التي رسّخها ذلك الغرب. إلى أي حد يجرؤ أكاديمي عربي -مثلاً- أن يبحث في قضايا ويكتب بأساليب لا تعترف الأكاديميا الغربية بها، ولا تُسهم في صعوده المهني في جامعته المصمّمة قياساً على جامعات غربية؟ إلى أي حدٍّ يجرؤ مهندس عربي أن يهجر اهتمامات بحث الغربيين (سادة الساحة العلمية) ويبحث في مسائل لا تأتي بمنحٍ ولا جوائز ولا اهتمام منظمات دولية؟ إلى أي حدٍّ يجرؤ أستاذ في مدرسة أن يتمرّد على المنهاج المقرَّر ويخرج عن كتاب الوزارة الذي صيغ قياساً على نظير أوروبي وأميركي؟ لا معنى لحديث في التحرّر لا يبدأ من مسائل ملموسة كهذه. ولعلّ أكبر شواهد السطوة الغربية علينا أن التمرّد عليها يجُرّك إلى صدام فوري بكل ما حولك، ويُلزمك أثماناً فادحة.
لن يرحل سؤال العلاقة بالغرب، لا لغموض جوابه، ولكن لأن نقاشه ليس نقاشاً حول أفكار ورؤى وإن بدا كذلك. هذا السؤال هو ظلٌّ لمعركة أخرى تجري في الميدان، وامتدادٌ لخلل فادحٍ في موازين القوى كرّسَ آلاف الشهداء حياتهم لإصلاحه. هو توتر بين من يريد عيشاً هانئاً تحت ظلّ السطوة الغربية، ومن يؤثر الفناء دون ذلك، وهو خطّ تماس بين نوعين مختلفين جدّاً من البشر.