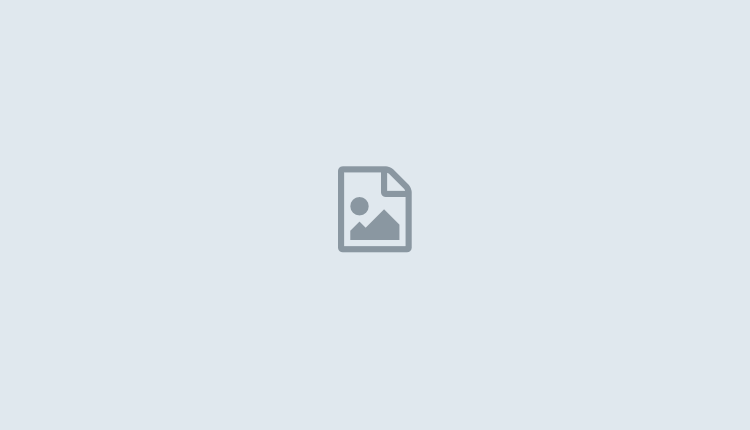السعودية بين اليمن وفلسطين
موسى السادة – وما يسطرون|
في الإطار المعرفي العام، يتم تحليل العلاقة السعودية – الأميركية ضمن مفهوم التبعية السياسية والاقتصادية، وحتى الثقافية، بين طرف يمثّل الإمبراطورية وآخر تابع لها. إلا أن هذا المفهوم جامد ويستثني عوامل وخصال متغيّرة بتغيّر الظروف التاريخية ذات الصلة بالطرفين، وتحديداً السعودي. لذلك، لا يمكن تحليل السعوديين اليوم بشكل جاف عبر ترديد مسألة التبعية للولايات المتحدة فقط. بل إن رابطة التبعية السعودية كانت، وهي اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، منطلقة من حالة نفسية تؤدّي إلى حمق في التصرّف، وخصوصاً في فلسطين واليمن.
ففي فلسطين، تمثّل القضية عبئاً تاريخياً وإزعاجاً يعكّر عملية ممارسة الرفاه والترف للأثرياء والطبقة الوسطى الاستهلاكية، والممثلين عنها، أي الأمراء العرب. ولأنّ هناك علاقة سببية بين موت الفلسطينيين وعذابهم ورفاه الأمراء وشريحة واسعة عربية وعالمية في محيطهم، فكلّما تبرز فلسطين معكِّرةً صفو الترف والاستهلاك يختلط الحمق النفسي والغاية السياسية، وتخرج أسوأ أنواع الخطاب وغياب العقل وانكشاف للنوايا، بحسٍّ انتقامي يصل إلى أن ينافس الصهاينة أنفسهم من دون مبالغة. فكيف يجرؤ أهل غزة على محاولة تعكير استهلاك المطاعم الأميركية والترفيه في «موسم الرياض»؟ ففي العمق إنّ ذهنية المستوطنة والقصر هي ذاتها، والتهديد الفلسطيني لهما هو ذاته.
في اليمن، الأمر ذاته أيضاً، فالمسألة تتعلّق بالفقراء وصرختهم وثوريتهم وتوقهم إلى الكرامة والحرّية. ولكن الحمق السعودي هنا منطلق من الفوقية التاريخية على اليمن واليمنيين، وهذا تحليل جامد ومكرّر أيضاً. فالمسألة اليوم أن السعوديين، لأول مرة في تاريخهم، وبدون أيّ سابقة خلال ملكهم، يجدون أنفسهم في جزيرة العرب وهناك وهن وإضعاف للسطوة البريطانية، ومن ثم الأميركية فيها، ومن أين؟ من اليمن. من هنا، يصعب على السعوديين فهم هذا الوضع الجديد. عقلهم – جدياً، ومن دون مبالغة – لا يستوعب المسألة، والأهمّ أنه يرفض أن يتقبّلها.
المسألة هي خصلة بشرية، وخصوصاً للمراهقين، وأيضاً للطغم الحاكمة المتكبّرة والمغرورة. لن يقبل هؤلاء تغيّر التاريخ، وحينما يتغيّر، يركنون إلى التكبّر والإنكار، كالمراهق الذي تحذّره مراراً وتكراراً بأن لمس النار سيحرق أصابعه، ولكن لو أعدت شريط التاريخ ألف مرّة، فالنتيجة واحدة أن المراهق بتكبّره سيلمس النار وتحترق أصابعه، فهذه طريقة تعلّمه الوحيدة، وهذه أيضاً سنّة التاريخ مع المستكبرين.
منذ دخول الهدنة، والسعوديون يحاولون بالتكبّر ذاته قلب الأمور والتموضع من طرف إلى وسيط، والهروب من سياساتهم وجرائمهم. كانت هذه وسيلتهم الغبية، وليس الحمقاء، بالمعايير العقلية لأمراء آل سعود في تحاشي أثر الهزيمة. ولكن، نحن اليوم وبعد «طوفان الأقصى» ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، في لحظة تاريخية فريدة للنفسية السعودية، حيث ثمّة تقاطع في الحمق تجاه الفلسطينيين واليمنيين في آن واحد، وأمست المعركتان معركة واحدة.
وعليه، يتضخّم الحمق السعودي، وهو ما نراه ينعكس كنوع من اضطراب ثنائي القطب، والتقلبات النفسية، فمن ناحية إعلامية وفي الخطاب السياسي نشهد ارتفاعاً في نكران الضعف والوهن للقوة العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، والتي راهنوا عليها وما زالوا كوثيقة أمان أبدية لمشاريعهم الاقتصادية ومستقبلهم السياسي في المنطقة.
وهو ما ينعكس عبر محاولة تبنّي سياسات تصعيدية اقتصادية على اليمن والذهاب بعيداً في الصهينة البجيحة والحرب على الفلسطينيين، وكأن السعوديين في حالة انتظار لنوع من التدخّل الغيبي الذي سيصبّ في مصلحة هذه السياسات، وهزيمة الفلسطينيين واليمنيين.
رغم ذلك، فإنهم، وبعد تبنّي كلّ سياسة متهوّرة وحمقاء، سواء منع الحجّاج اليمنيين من العودة أو التصعيد في الحرب الاقتصادية، وإلى ما قبل آخر اللحظات من الوعيد اليمني، يتراجعون ويخضعون. فهم في حالة نفسية ما بين إنكار الوضع الجديد وبين الشعور والإحساس بأنّ عصى القوّة السياسية والعسكرية الحقيقية هي لدى خصومهم، وليست معهم أو حتى مع الأميركيين والإسرائيليين، في المنطقة كلّها وفي فلسطين ولبنان واليمن. بل إنّ القول المنسوب إلى السعوديين والأميركيين بأنكم لن تقدروا على اليمنيين لهو مؤشّر على ذلك، وما ثبات صوابيّته سوى مؤشر ودليل آخر أيضاً على أن تصرّف اليمنيين كفاعل ثوري في المنطقة ليس خاضعاً لقواعد الردع والاشتباك التقليدية وأحكام الحدود والجغرافيا الوطنية لهو الخيار الأجدى في التعامل مع العدوان الغربي.
وبالعودة إلى التضخّم في الحمق السعودي، فهو يمتدّ ما بين عدم تقبّل الوضع التاريخي الجديد لجزيرة العرب في يمن مستقلّ وحرّ وعزيز، والأهمّ قوي ومقتدر، وأن هذا يقتضي تأقلماً واحتراماً ونهاية للنظرة الدونية، وأن صنعاء عاصمة لها حرمة وعصمة كأيّ عاصمة، وأن الشعب اليمني ذو سيادة وحرمة في ممتلكاته واقتصاده وحياته، وصولاً إلى عدم تقبّل واقع أن الوضع الإقليمي لما بعد «طوفان الأقصى» يقتضي أن البحث عن حل أمني تقني عبر البنية العسكرية الأميركية والصهيونية رهان واضح خسارته. وأن المركزية للقضية الفلسطينية ثابت، لا متحوّل، في تاريخ العرب والمسلمين، وأن مسار التطبيع على هامش مستقبل المنطقة. والأهم في كل هذا، أنه لا يبدو أن هنالك قدرة إبداعية في الفكر الاستراتيجي للسعوديين للوصول إلى توليفة للتكيّف مع هذا الواقع الجديد سوى التقلّبات النفسية والحمق الذي لن يؤدّي إلا إلى ارتكاب أخطاء استراتيجية كبرى تكلّفهم الكثير.
فالنقطة أنه ورغم ذلك فإن هذا الحمق السعودي يتمظهر على شكل نكران وتكبّر من جهة، ويتمظهر في الوقت ذاته شعوراً بالأزمة. ومن الممكن رؤية شعور الأزمة أنه ورغم كل المحاولات السعودية لإعادة تصدير شرعية وخطاب جديد معاصر وحداثي يتناسب مع العولمة الاقتصادية والثقافة الاستهلاكية الأميركية، إلا أنه ومع أوّل شعور بالأزمة تعود السلطة والناطقين عنها إلى الأدبيات والعصبيات الأولى لقيام الدولة وهي العصبية الوهابية، وخطاب العداء على أسس طائفية ضدّ الآخر. لذلك، نلاحظ اليوم، ومع حماقتهم بالتواطؤ مع الأميركي والإسرائيلي المزدوج ضدّ فلسطين واليمن، عودة الشحذ على وتر العصب الوهابي أمام الآخر، وهذا مؤشّر نفهم عبره أنهم رغم النكران والتكبّر فهم يشعرون بالمأزق والأزمة.
والنتيجة، في نهاية المطاف، أن التعنّت والتجبّر السعودي لن يزولا بالتهديد والوعيد، بل سيقابلونه بالسخرية والإنكار. فالشواهد التاريخية تخبرنا أن هذه اللحظات التي يتغيّر فيها التاريخ بما يفرض فيه الفاعل التاريخي الصاعد أنه نظير وذو مكانة، نادراً ما قوبلت باستيعاب. وما التوافقات المرحلية والاتفاقات والتسهيلات سوى تسويف سعودي ولن تفضي بانسيابية إلى تملّك اليمن السيادة الكاملة على مجاله الجوّي ومعابره البحرية أو إلى قبول السعوديين بقوّة ثورية فلسطينية تلهب مشاعر الملايين. وعليه، فالسعوديون سيستمرّون في مسارهم ذاته إلى أن يلمسوا النار بأيديهم، وحينها فقط سيستوعبون الظرف التاريخي الجديد في صدمة سيهرولون بعدها للتأقلم معه بأقلّ الخسائر.