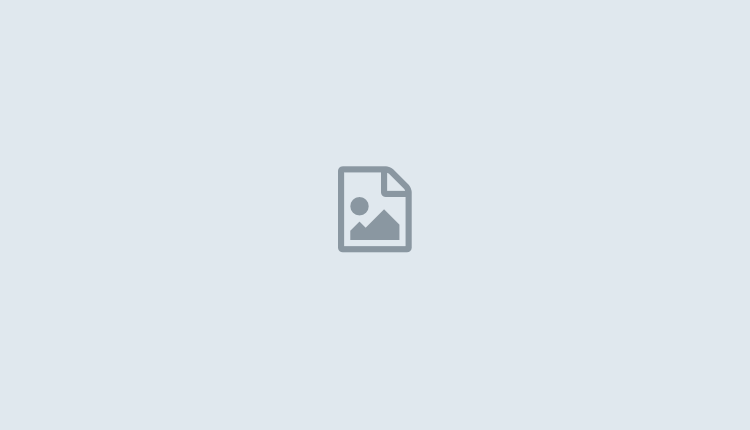المسيحية الصهيونية إنْ حَكَت
ميشال نوفل – وما يسطرون|
الصهيونيّة المسيحيّة حركة غير مكشوفة إلّا نسبيّاً في عالمنا العربي. ومع ذلك، فإنّ الحقيقة المذهلة هي أنّ الصهيونيّة بدأت مسيحيّةً قَبل أن تكون يهوديّة، في ظلّ الاعتقاد السائد في البروتستانتيّة الأنغلوساكسونيّة منذ منتصف القرن التاسع عشر بأن «عودة شعب إسرائيل إلى أرضه» تساهم في تحقّق النبوءات.ومِثل هذا الاعتقاد سوف يُسهّل فبركة «وعد بلفور» الذي عُدّ أوّل إنجاز تاريخي للحركة الصهيونيّة عام 1917، ويجعل تأييد إسرائيل منذ 1948 محوراً رئيسيّاً للسياسة الداخليّة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب الوزن المتزايد باستمرار للصهيونيّة المسيحيّة بالدرجة الأولى، واستقطاب الصوت اليهودي بالدرجة الثانية.
وفي هذا السياق، يُسجّل لبنيامين نتنياهو، بصفته رئيساً للحكومة فترة 1996-1999 ثمَّ 2009-2021 ومجدّداً منذ 2022، أنّه اخترع نوعاً من «الصهيونيّة بلا يهود»، إذ هو يُقدّم التأييد غير المشروط للصهيونيّين المسيحيّين على الحوار مع «الدياسبورا» اليهوديّة التي تُوصف بأنها متنوّعة جدّاً ونقديّة في معظم الأحيان.
ويَعتقد التيّار الإنجيلي في البروتوستانتيّة الأنغلوساكسونية أنَّ فلسطين فارغة من المعنى لغياب «أمّة» تستحقّ هذا الاسم «ما دام الشعب اليهودي لم يُحقِّق فيها مصيره ممهّداً السبيل لإقامة مملكة الله». ومن شأن هذا التصوّر الديني أن يتحوّل إلى هاجس سياسي يدفع نحو تعزيز السلطات البريطانيّة دعمها للمشروع الصهيوني في فلسطين، وتالياً دعم الولايات المتحدة لدولة إسرائيل الناشئة. ويمكن لهذه الحِجّة التوراتيّة أن تُفضي، عقب احتلال الضفة والجولان وسيناء، إلى إفلات الدولة اليهوديّة الغاصبة من المحاسبة الدوليّة، وتالياً تجاوز القانون الدولي. وعلى هذا النحو، تتحوّل الصهيونيّة المسيحيّة تدريجاً لاعباً مركزيّاً في ما يُسمّى عملية السلام الإسرائيليّة-الفلسطينيّة في السياسة الأميركيّة، ويصبح في إمكانها الاضطلاع بدور حاسم لضمان أن تبقى هذه العمليّة لمصلحة إسرائيل.
وها هي الصهيونيّة المسيحيّة في الآونة الأخيرة تعمل لتشجيع دونالد ترامب على توجيه ضرباتٍ بشرعيّة القضيّة الفلسطينيّة، وذلك عبر إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول 2017 في إطار «مقاربة جديدة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيّين». وإذا كان وعد بلفور لم يعترف سوى بـ«الحقوق المدنيّة والدينيّة للجماعات غير اليهوديّة الموجودة في فلسطين»، فإنّ ترامب لا يعترف للفلسطينيّين سوى بحرّيّة العبادة في القدس، ويمنح لإسرائيل الحقّ في ضمّ وادي الأردن والمستوطنات في الضفّة بموجب «اتفاق القرن» الموقّع مع نتنياهو في كانون الثاني 2020.
ولم يكتفِ الأصوليّون الأنغلوساكسون بتغييب العرب في الصراع على فلسطين، بل عملوا أيضاً لجعل العمليّة الرامية إلى حرمان الفلسطينيين من وطنهم مسألة غير قابلة للعودة إلى الوراء. وهكذا تخلّت الصهيونيّة المسيحيّة التي تُباهي بتحقيق نجاحات تاريخيّة يتقدّمها إعلان وعد بلفور، عن الاهتمام بالإدارة السياسيّة للانتداب البريطاني، لمصلحة التركيز على العمل داخل الولايات المتحدة، وإن ظلّت تتجنّب ممارسة سلطة مباشرة على فلسطين رافضة باستمرار نشر قوّة للفصل فيها.
غير أنّ الاستبداد التوراتي سوف يؤدّي تدريجاً إلى تحويل الصهيونيّة المسيحيّة إلى ماكينة حربيّة تطحن كل المبادرات الرامية إلى السلام، ومنها محاولة الرئيس جيمي كارتر الذي تجرّأ على الحديث عن مصالحة بين العرب والإسرائيليّين، والخطوة التي أقدم عليها إسحاق رابين باسم أمن إسرائيل وأسفرت عن عقد تسوية إقليميّة مع منظمة التحرير. واللافت للانتباه في هذا السياق، اندفاع الكونغرس الأميركي على التصويت بأكثرية ساحقة على قانون سفارة القدس بعد عشرة أيام فقط على اغتيال إسحاق رابين. وساهمت الحملة الشديدة التي شنّها الصهيونيّون المسيحيّون ضدّ اتفاقات أوسلو في تحويل اللوبي الإسرائيلي إلى لوبي ليكودي قلباً وقالباً.
وكان لافتاً للانتباه أيضاً، أنه بمجرّد الحصول على اعتراف الرئيس ترومان بإسرائيل، لم يعُد بن غوريون يُولي الصهيونيّة المسيحيّة سوى القليل من الاهتمام. في المقابل، نرى بيغن ونتنياهو يلتزمان شراكة متعدّدة الوجوه مع الأوساط المسيحيّة التي تُبدي تأييداً مطلقاً للصهيونيّة، علماً أن الانتهازيّة هي التي تدفعهما إلى بناء علاقة عضويّة مع الإنجيليّين الأميركيّين، وهي نزعة مماثلة لتلك التي تحرّك مسيرة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ثمَّ محاولته الخوض مجدّداً في معركة الرئاسة الأميركيّة.
لكن الغريب في تحلّق الأصوليّين الأميركيّين حول ترامب أنّ هذا الرئيس الذي اجتاز عتَبَة البيت الأبيض في كانون الثاني 2017، لا يتميّز بممارسته الدينيّة ولا بتمسّكه بالقِيَم العائليّة. ومع ذلك، فقد وضعوا ثقلهم في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري حيث يمثّلون نصف الناخبين، ثمَّ في الانتخابات الرئيسيّة في تشرين الثاني حيث كانوا يمثّلون نحو نصف الأصوات الجمهوريّة، وذلك لإنجاح سعي ترامب إلى تبوّؤ سدّة الرئاسة. ويبدو أنّ دعم ترامب غير المشروط والتزامه نقل السفارة إلى القدس، قد ضَمِنا لترامب هذا التأييد الحاسم من القاعدة الإنجيليّة. وعلى هذا المنوال، باتت الصهيونيّة المسيحيّة الحليف الرئيسي لحزب الليكود في الولايات المتحدة حيث يحوز ترامب تأييد 81% من الناخبين الإنجيليّين البيض، إضافة إلى 25% فقط من أصوات اليهود.
أمّا نائب الرئيس الإنجيلي المتحمّس مايك بنس، فإنّه يُجاهر بأن «شغفه بإسرائيل ينبع من إيمانه المسيحي».
وحدهم اليهود الأرثوذكس الذين يُعدّون أقليّة صغيرة في الوسط اليهودي الأميركي، يبدون اندفاعاً في التزامهم سياسة ترامب مساوياً للإنجيليّين، وذلك لأنَّ التعلّق التوراتي بإسرائيل يتقدّم في الحالتين على أي اعتبارات أخرى.
إنّ المبشّر الإنجيلي روبرت جيفرس، القائل «إنَّ كل شيء يبدأ وينتهي في إسرائيل»، هو الذي ألقى في كانون الثاني 2017 عِظَة القدّاس الذي أُقيم في مناسبة تولّي ترامب سدّة الرئاسة الأميركيّة. ولم يمضِ شهر على ذلك حتى استقبل ترامب نتنياهو بحرارة ومظاهر تكريم أظهرت على الملأ المفارقة مع التوتّرات التي شابت العلاقة الأميركيّة الإسرائيليّة في عهد الرئيس باراك أوباما.
وإذ نأتي إلى التأييد المطلق الذي يُظهره الرئيس جو بايدن لحرب الإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على فلسطين، نتبيّن أنّ هذا الموقف يتّصل بالاقتناعات الصهيونيّة لرئيسٍ يرفض النداءات المتكرّرة للبابا فرنسوا من أجل وقف النار في غزّة، على الرغم من إيمانه الكاثوليكي. ولقد رأى بايدن، خلال زيارته لإسرائيل في 8 تشرين الأول، أنّ من المناسب أن يؤكّد لنتنياهو أنّه «ليس ضروريّاً إطلاقاً أن تكون يهوديّاً لكي تكون صهيونيّاً، وأنا نفسي صهيوني». وهذا كان التزام عمومي سبَقَ أن صرّح به بايدن مراراً في السابق، لكنّه يرتدي هذه المرّة قيمة المشاركة في الحرب في خضمّ العدوان الإسرائيلي الوحشي. بل إنّ الرئيس الأميركي، الذي يحبّ إبراز الصفة اليهوديّة لبعض مستشاريه ووزير خارجيّته، لا يتردّد في وصف مقاومة حركة حماس للاحتلال والعدوان بأنها «الشرّ المطلق».
ولا شكّ في أنّ ما يهمّ بايدن في الاصطفاف إلى جانب إسرائيل، عسكريّاً واستخباريّاً وديبلوماسيّاً، هو إرضاء الصهيونيّين المسيحيّين الذين يسيطرون على الكونغرس ويهدّدون بعرقلة عمل المؤسّسات الفيدراليّة عبر تجميد موازنتها. وإنّ الإنجيلي المتعصّب مايك جونسون، الذي انتُخب رئيساً لمجلس النواب الأميركي في 25 تشرين الأول، عقب أزمة دامت ثلاثة أسابيع، حصل في اليوم نفسه على التصويت بأكثرية 412 صوتاً مقابل 10 أصوات على قرار التضامن «مع إسرائيل التي تُدافع عن نفسها ضدّ الحرب البربريّة لحماس».
وكان جونسون هذا، المقرّب من ترامب، قد زار القدس في شباط 2020، ودخل إلى المسجد الأقصى مُحاطاً بمؤيّدين إسرائيليّين لإقامة الهيكل الثالث مكان قبّة الصخرة. وقاد جونسون في 3 تشرين الثاني عمليّة التصويت بأكثريّة 226 صوتاً مقابل 196 صوتاً على مساعدة عسكريّة لإسرائيل قيمتها 14 مليار دولار مقتطعاً من هذه الصفقة المساعدة الإنسانيّة المقترحة لغزّة.
ولا بدّ، أخيراً، من الإشارة إلى المبشّر فرانكلين غراهام الذي تسلّم «الإمبراطوريّة الإنجيليّة» من والده بيلي غراهام، فقد أكّد لنتنياهو عندما استقبله في تل أبيب في 20 تشرين الثاني تأييده لـ«إسرائيل شعب الله» في هذه الحرب «بين الخير والشرّ» داعياً، إثر هذا اللقاء، أتباعَه في الولايات المتحدة «إلى الصلاة من أجل رئيس الوزراء» الإسرائيلي.
في الواقع، إنّ الحلفاء الإسرائيليين للصهيونيّين المسيحيّين ليس لديهم أيّ أوهام حول المصير الذي يتصوّره الأصوليّون الأميركيّون لليهود المرشّحين للإبادة بنسبة الثلثين في يوم القيامة، على أن ينجو الثلث المتبقّي بفضل اعتناقه المسيحيّة. ولا مشكلة لدى هؤلاء الحلفاء في تحمّل الغلواء المُعادية للساميّة للمبشّرين الإنجيليّين، ما دام تأييدهم صلباً للاستيطان الكولونيالي للأراضي الفلسطينية.