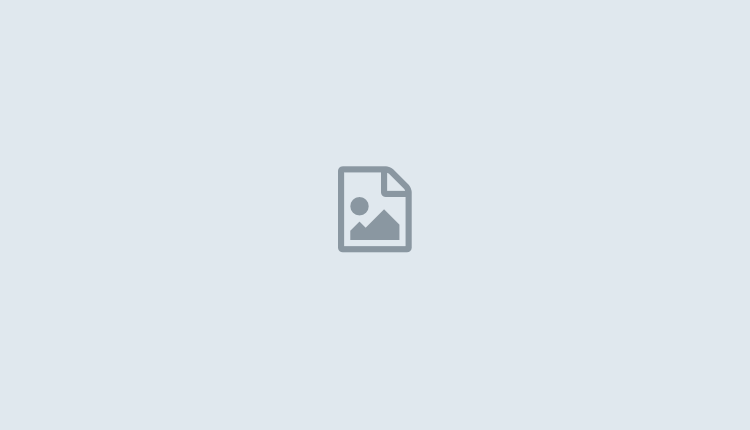نقطة الضعف الكبرى
سعد الله مزرعاني – وما يسطرون|
بعد الإعلان عن حادثة مقتل جندي على الجانب المصري من معبر رفح، سارعت السلطات المصرية إلى احتواء الحادثة ولفلفتها. فقد أصدرت بيانات باردة وحذرة بشأن الحادثة، فيما الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي كانت لاهثة وحارّة. الرغبة في السيطرة على الوضع، ومنع تفاقمه، كانت هي الهاجس والهدف المصريين! قبل ذلك، «لحست» السلطات المصرية كل «تهديداتها» الإعلامية المحذّرة من سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في «فيلادلفيا» والتي يشكّل الدخول إليها والسيطرة عليها أمراً مخالفاً لاتفاقية كامب ديفيد لعام 1979. عكس ذلك، كان الحرص الإسرائيلي على احتواء الوضع أقلّ بما لا يقاس. هو أعلن مقتل الجندي المصري، وحمّله المسؤولية عن بدء إطلاق النار، رغم أن أحداً لم يصب من الجنود الإسرائيليين جرّاء ذلك.يُشار إلى أن الحادثة وقعت بعدما راج بأن ثمة توتراً قد حصل بين حكومتَي مصر وإسرائيل بسبب التقدّم الإسرائيلي إلى المعبر، في نطاق قرار اجتياح «رفح» من قبل الجيش الصهيوني. كان من المنطقي أن يزيد مقتل الجندي المصري من الاحتقان بين الطرفين. لكن ذلك لم يحصل بسبب أن سلطات القاهرة أكَّدت، مراراً، تمسكها بالمعاهدة، السيئة الذكر، الموقّعة بين البلدين. وقد كُشف أن في بنود تلك المعاهدة ما يتضمّن تعهدات ملزِمة بعدم التراجع عنها، كلياً أو جزئياً، من دون موافقة الطرفين ووسيطهما العرّاب الأميركي!
استعاضت السلطات المصرية عن اتخاد المواقف التضامنية الجادة مع غزة والشعب الفلسطيني، ببعض التعاطف والدعم الإعلاميين، شأنها في ذلك شأن بقية المطبّعين والمتواطئين القدماء والجدد. وهي استعانت بقوات الأمن، وبشراسة استثنائية، على منع وقمع كل محاولة شعبيّة للتضامن مع غزة والشعب الفلسطيني، ما حال دون مشاركة الشارع المصري في التعبير عن شجبه لحرب الإبادة الهمجية: بالتدمير والمجازر والتجويع والحصار.
ما فعلته السلطات المصرية، وكوفئت عليه ببعض القروض من «صندوق النقد الدولي»، كرّرته، بشيء من الزيادة أو النقصان، السلطات الأردنية التي لم تتورّع عن الانخراط في الشبكة الدفاعية التي نظّمتها واشنطن منعاً للصواريخ والمسيّرات الإيرانية من بلوغ أهدافها في المؤسسات العسكرية الصهيونية.
عمَّان لم تتمكن من منع التحرّك الشعبي، لكنها حاصرته، سياسياً وأمنياً، مشكّكةً في أهدافه وقواه، فيما كانت تخوض معركة متصاعدة مع السلطات السورية حول موضوع المخدّرات بشكل طرح الكثير من علامات الاستفهام، حول التوقيت على الأقل. ينطبق هذا الأمر على السلوك السعودي الذي لم يسعف صمتَه الرهيب عنادُ المقاومة وصلابتها، وتعاظمُ المجازر الإسرائيلية، وطولُ مدة الصراع. اضطرّت الرياض إلى أن «تقود»، وهي مهووسة، منذ صعود محمد بن سلمان، بـ«القيادة» (بدءاً من الرياضة إلى الغناء والترفيه…)، قمّتين في وقت واحد! اكتفت القمتان، بـ«قيادة» سعودية، بتنظيم زيارات إلى «مراكز القرار» الدولية، من دون رمي الموقف الأميركي، الشريك في العدوان وفي المجازر وفي تغطيتها، بوردة أو إشارة عتب أو ملامة، ومن دون أن تفعّل عناصرَ قوتها في وجه المعتدي، لوقف عدوانه، وفي وجه الحصار القاتل لاختراقه. على العكس من ذلك، فمصر والأردن والخليجيون (مع تمايز جزئي لدور قطر) أكدوا على التمسك بالمعاهدات القائمة والعتيدة. وهو حرص، بالمناسبة، لم تعتمده إسرائيل التي بالغت في إجرامها واستفزازها دون حدود أو قيود.
لا يجوز أبداً الاكتفاء بهذه الملاحظات التي تناولت ما كان ينبغي فعله، ولم يُفعَل. لا بدّ من التجاوز إلى ما كان لا ينبغي فعله، وقد فعل، وبوقاحة غالباً
طبعاً، لا يجوز أبداً الاكتفاء بهذه الملاحظات التي تناولت ما كان ينبغي فعله، ولم يُفعل. لا بد من التجاوز إلى ما كان لا ينبغي فعله، وقد فعل، وبوقاحة غالباً. من ذلك: الإعلام الذي راوغ ولم يتردّد في إثارة شبهات حول «طوفان الأقصى» وحول موقف المقاومة. ومن ذلك التهجّم على موقف «أنصار الله» في قرارهم الشجاع بمنع المساعدات عن الكيان الصهيوني عبر البحار والموانئ. من ذلك، أيضاً، التشكيك في الموقف الإيراني لجهة صدقيّته وأهدافه، إلى المساهمة في توفير ما يحتاج إليه العدو نتيجة الحصار البحري. ثم إلى إعداد مشروع «شراكة استراتيجية» بين واشنطن والرياض، تدشّن التطبيع «الشامل» مع الكيان الصهيوني، وتحسم الصراع على السلطة في المملكة لمصلحة وليّ العهد، وصولاً إلى وقوف السلطة الفلسطينية عاجزة ومتفرجة أمام الحملة الدموية التي يقودها متطرّفو الحكومة الإسرائيلية، في الضفة الغربية أيضاً، والتي ذهب ضحيتها حوالي 500 شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين، حتى الآن، في نطاق عمل إجرامي إرهابي موجَّه للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية والسعي لتهجير سكانها كما يحصل في غزة. اقترن ذلك بإقدام الحكومة الإسرائيلية على تنظيم هجوم استباقي على ما تبقّى من اتفاق أوسلو، رغم شكليّته وتعاسته، ورفض أيّ دور للسلطة ومحاولة خنقها اقتصادياً، وإحراجها على كل المستويات السياسية والأمنية.
يذهب هذا الوضع الرسمي العربي الخانع والمتواطئ، والمانع والقامع للاحتجاج الشعبي (باستثناء نسبي للموقف الجزائري)، باتجاه مضادّ تماماً، للمصلحة العربية والفلسطينية. وهو يقع على طرفَي نقيض أيضاً، مما يجري في العالم من انتفاضة دولية، على المستوى الشعبي، وحتى الرسمي، ضد الحركة الصهيونية ووليدها الكيان الصهيوني (وداعميهما) اللذين تكشّفا قوة إرهابية همجية معادية لحقوق شعب فلسطين، ولكل القيم والمكتسبات الحضارية البشرية، وخصوصاً في مسائل حقوق الإنسان والتعامل مع المدنيين والمؤسسات الإغاثية والصحية والإعلامية والتربوية والروحية في زمن الحرب! هذا فيما طُبع كل المسار الراهن، منذ أكثر من سبعة أشهر، بالصمود المذهل والأسطوري للمقاومة وللشعب الفلسطيني، في أداء ملحمي بطولي ذي وقع وإيقاع تاريخيين!
وبين هذا وذاك، تواصل واشنطن المناورة والخداع، ويكاد الرئيس الأميركي الحالي يتفوّق على كل من سبقه، ليس في دعم الإجرام الصهيوني فحسب، بل أساساً في المراوغة والتضليل بما مكَّن ويمكّن الصهاينة في تل أبيب وفي العالم من كسب الوقت، أملاً في تحقيق أهدافهم العنصرية والإجرامية والإرهابية.
الوضع العربي الراهن، كجزء مما كان يسمّى «العالم الثالث»، موهَنٌ ومثقَلٌ بالسعي الدائم من قبل الإمبراطورية الإمبريالية الأميركية وأداتها الكيان الصهيوني، وخصوصاً لنهبه وللهيمنة على مصيره ومقدّراته وثرواته. يحصل ذلك بوسائل الاحتلال والتفتيت وإثارة الانقسامات والحروب الداخلية والحصار والعقوبات. وتستدعي أزمات وتجارب قواه التحررية القديمة، بشكل خاص، الانخراط في عملية تقييم عميقة باتجاه بلورة وتأسيس تيار تحرّري استنهاضي شامل، يوجّهه برنامج كفاحي يضع في رأس أولويّاته التصدّي لمشاريع الهيمنة الاستعمارية ولأدواتها المحلية، وتوحيد كل الجهود في خدمة ذلك الهدف.